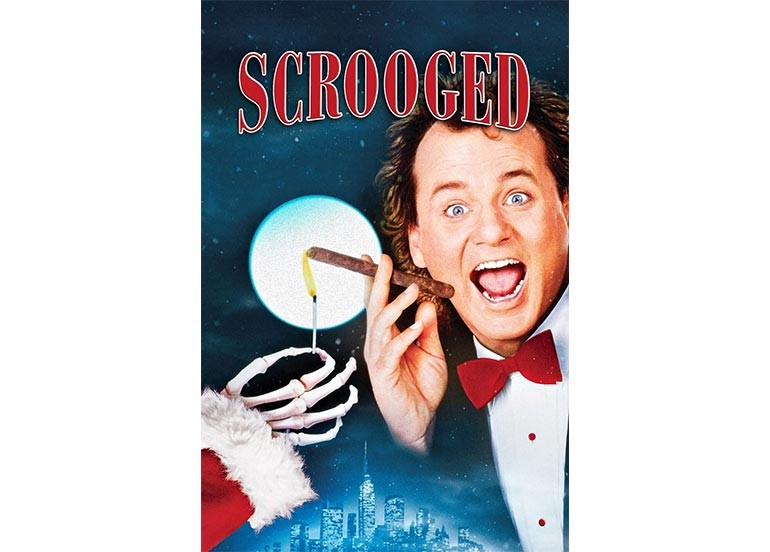المحرر السينمائي
بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، فاجأ المخرج عدي رشيد (1973) الوسطين العراقيين، الثقافي والسينمائي، بإخراج أول فيلم روائي طويل. مصدر المفاجأة متأتٍ من جَدبٍ أصاب عقدين ونصف العقد من الزمن في إنتاج الأفلام في العراق. لفيلمه هذا عنوان غير مألوف: «غير صالح للعرض». بعده، أنجز أفلاماً عدّة.
رشيد مخرج وكاتب أفلام. درس في «كلية الفنون التطبيقية» في بغداد، وكرّس نفسه للسينما. عمل كاتباً مستقلاً لمقالات نقدية، ثم درس السينما في «كلية الفنون الجميلة». بعد أفلامٍ قصيرة، وفيلمين روائيين طويلين، غادر إلى نيويورك، وأقام فيها.
من أفلامه القصيرة: «بياض الطين»، و»مقدمة أخرى»، و»نقص التعرض». ومن الوثائقي: «كلكامش: الملحمة.. المكان»، بالإضافة إلى روائيّ طويل بعنوان «كرنتينة».
كتب سيناريوهات مسلسلات وبرامج تلفزيونية، منها: «الوثيقة 12» (فيلم تلفزيوني)، و»مرة واحدة في بابل»، و»ورشة مدينتنا» (مسلسل تلفزيوني). عرضت أفلامه في مهرجانات سينمائية عربية ودولية، ونال بعضها جوائز. بعد عام 2003، انضمّ إلى المجموعة الفنية «ناجين»، التي قدّمت أعمالاً ثقافية مختلفة، ثم أنجز «غير صالح للعرض».
بمناسبة فيلمه الجديد «أناشيد آدم»، حاورناه عنه، وعن تجربته السينمائية.
ما فكرة «أناشيد آدم»، الذي تعمل عليه الآن؟ ما الأسلوب الذي اعتمدته في مُعالجة فكرته؟
- «أناشيد آدم» حكاية صبي يُدعى آدم، بدأ محاولته الأولى في إيقاف الزمن، من دون أن يكترث لمروره الحتمي في الآخرين حوله. عملتُ على السيناريو أعواماً عدّة، والسيناريو مرّ في مراحل، قبل بلوغه الصيغة التي صوّرت الفيلم على أساسها. تمّ التصوير في منطقة غرب العراق، في ريف مدينة هيت تحديداً، حيث الفرات في صراع أزلي مع التصحّر حوله، والتصحّر هنا في ثنائية المعنيين، الجغرافي والمجازي.
الصبي عزام أحمد من الفلوجة، أدّى دور آدم. إنّه محور الحكاية. انتماؤه وإيمانه بالفيلم، ثم تماهيه بالعمل في ظروفٍ مناخية صعبة للغاية، ولساعات طويلة، مكسبٌ حقيقيٌّ لترجمة مَشاهد الحكاية. بخصوص الأسلوب، أكرّر عبارة جان كوكتو: «الأسلوب نتيجة، وليس نقطة انطلاق».
في فوضى الإنتاج السينمائي في العراق، هل وجدت تمويلاً مناسباً فيه؟ ما رأيك في تعثّر عملية الإنتاج هنا؟
- إنّك تُسهّل عليّ المهمة. بالفعل، كما في سؤالك: إنّها محض فوضى. طبيعة «أناشيد آدم» لا تحتمل الاندراج في أيّ مُسمّى من مُسمّيات تلك الفوضى. لذا، الإجابة بسيطة: لا. لم يحصل الفيلم على تمويل في العراق، باستثناء دعمٍ لوجستي، قدّمته نقابة الفنانين، بفضل جبار جودي. لم أحصل على دعم جهة حكومية أو أهلية. كنتُ أشعر أنّ هناك تجاهلاً مقصوداً إزاء هذه التجربة، ممن يعتقدون أنهم قائمون على العملية الثقافية ـ السينمائية هنا، على المستوى الرسمي على الأقلّ. البعض استقبلني. وبعد ثرثرة وكلمات إنشائية لا معنى لها، ينتهي الموضوع برمّته بصور جماعية، تُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي. الجهل السينمائي مرضٌ ينهش المؤسّسة الثقافية العراقية، عموماً.
لكن، بغض النظر عن علاقة «أناشيد آدم» بالمؤسّسة الثقافية الإنتاجية في العراق، أؤمن بأنّ العملية الإنتاجية تعتمد على ثلاثة أركان أساسية: المجتمع، ورأس المال، والصانع. الثلاثة في مشكلة حقيقية، منذ سيطرة الدولة على القرار الثقافي، نهاية ستينيات القرن المنصرم. عملياً، لا يزال العراق يعيش تحت وطأة تلك القوانين.
الموضوع مُعقّد، لكن خلاصته بالنسبة إليّ تكمن في التالي: لا وجود لسينما بلا جمهور، ولا جمهور للسينما العراقية في العراق.
في فيلمك هذا، هل استعنت بالفريق الفني الذي عمل معك في فيلمك الأول؟
- لكلّ فيلم ظروفه الإنتاجية والتعبيرية، التي تُحتّم شكل الفريق ونوعه. للأسف، لم تسنح الظروف إلا بوجود المنتج ماجد رشيد، من الفريق القديم. الأسباب كثيرة، لا مجال لذكرها هنا. لكنّي، فعلياً، افتقدتُ ذاك التواصل النفسي الحسّي، الذي يوفّره العمل مع فارس حرّام وزياد تركي وغيرهما.
بين «كرنتينة» و»أناشيد آدم»، أنجزت تجربة ناطقة باللغة الإنكليزية، الأولى لك في نيويورك (لا يزال المشروع في مرحلة المونتاج ـ المحرّر). كيف أثّر هذا على تجربتك، عامة؟
- التأثير إيجابي، طبعاً، وعميق عموماً. بعد أنْ أكملتُ التصوير في نيويورك، سافرتُ إلى ريف الأنبار لتصوير «أناشيد آدم». بعد استقراري في نيويورك، بدأت تدوين حكاية عن علاقة المجتمع الأميركي بالمهاجر عامة، وبالمهاجر ذي الأصول العربية خاصة. انتهى التدوين بعد المرور بأربعة كتّاب سيناريو، جميعهم من نيويورك. بعد خمسة أعوام من العمل الشاق، صار الفيلم أول روائي أميركي لي.
التحدّي الأكبر في تلك التجربة مُتجسّدٌ في التابو الموضوع على تناول مداخلة كهذه من مُخرج مهاجر، من العالم الذي يسمّونه الشرّ. الفيلم أنجز بعد رحلة إنتاجية ـ نفسية مختلفة عن رحلتي «غير صالح» و»كرنتينة».
تاريخياً، يُسجَّل لك أنّك مخرج أول فيلم بعد التغيير، «غير صالح للعرض». إنّه بحقّ مغامرة كبيرة. هل تجدها جمرة أجّجت هذا الاندفاع السينمائي الحاصل الآن في العراق؟
- أشكر لك هذا الإحساس. أتّفق معك، وبتواضع، إنّها الجمرة التي كان جيلنا، ومن أتى بعدنا، يحتاج إليها. لكنّي لم أكن وحدي. تلك التجربة مثال للعمل الجماعي الواعي بأزمة بلد وإنسان.
أيمكنك التحدّث عن تجربة العمل في «غير صالح للعرض»، في ذاك الوقت العصيب؟
- كما في سؤالك، كانت أوقاتاً عصيبة. كنّا نراقب الاحتلال حزناً، وأجسادنا ترقص لسقوط الطاغية. إنّها لحظة انفصام كاملة، لا نزال ندفع ثمنها، أشخاصاً وأمّة.
سينمائياً، أكثر ما أتذكّره من تلك التجربة، الشجاعة المطلقة للمُصوّر السينمائي ـ الفوتوغرافي زياد تركي، والدرس الذي قدّمه في العمل على خامة سينمائية غير صالحة للاستعمال. حينها، كنتُ أنفّذ فيلمي الأول، وأتعلّم منه في الوقت نفسه. بعدها، كانت لحظة العمل الفريدة على السيناريو مع الشاعر فارس حرام. هذه تجربة فذّة في التواصل اليومي معه. لم يكن لدينا سيناريو مكتمل. كنا نكتب أثناء التصوير.
ما الذي تبقّى من جماعة «ناجين» الثقافية، وتجربة فيلمك الأول إحدى ثمارها؟
- »ناجين» حالة خاصة. لم تكن جماعة ثقافية، وفق السياق التقليدي للمفردة، بل تجمّع لممارسة فعل النجاة من سلطتي الطغيان والاحتلال. كانت مُسمّى للقاء أكثر منه منهجاً. ما تبقّى، أفرادٌ تعلّموا درس الحرية كاملاً. بعضهم هاجر إلى حريته، وبعضهم يحرث في أرض صعبة المراس. لكلّ من الخيارين تحدّياته.
أنتَ تختلف عن أبناء جيلك، لأنّك من المخرجين المثقفين الذي تعاملوا مع السينما كرسالة حضارية. ما أثر هذه الثقافة في عملك؟
- بعد الصورة، المُدوَّن يعنيني كثيراً. الشعر تحديداً، وبعده الرواية. هذا قرّبني، في مرحلة التسعينيات، من فاعلين في الوسط الثقافي العراقي. إنسانياً، تعلّمت منهم كثيراً. ذاكرتي مرتبطة بملمس الأرائك الخشبية في «مقهى الجماهير»، التي تحتضن أناساً أثّروا فيّ كثيراً، وساهموا في تكويني الإنساني ـ المعرفي. هذا بالتأكيد أثّر فيّ كسينمائي.
لستُ متأكداً من مصطلح «السينما رسالة حضارية». لكنّي مؤمن بأن مسؤولية ما تحضر، كلّما فتحتُ مسودتي لتدوين مشهدٍ جديد. لعلّها الرغبة في البحث عن ظلال ال جودة، لا أكثر.
أنتَ في الغربة. هل تتابع الحراك السينمائي الحاصل في العراق الآن؟ ماذا تقول فيه؟
- لا يوجد حراك سينمائي في العراق. إنه «محاولات لا أكثر»، وهذا وصفٌ له منذ أعوام. لكلّ محاولة فارسها، كما تعرف.