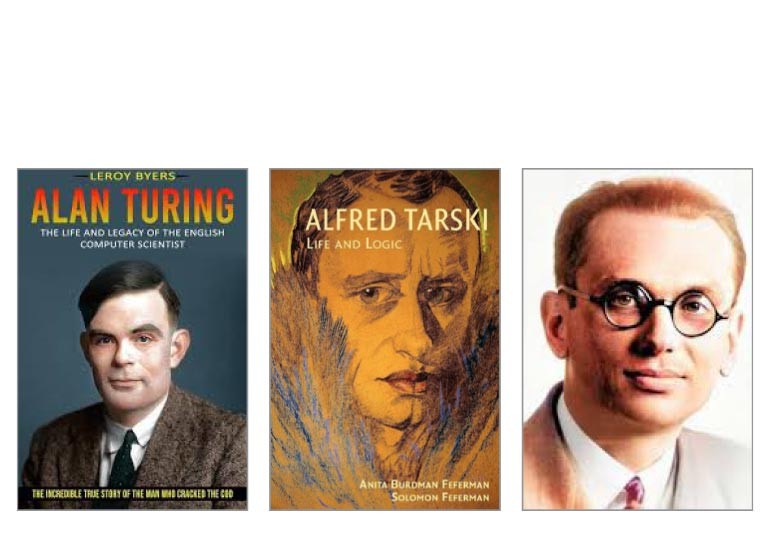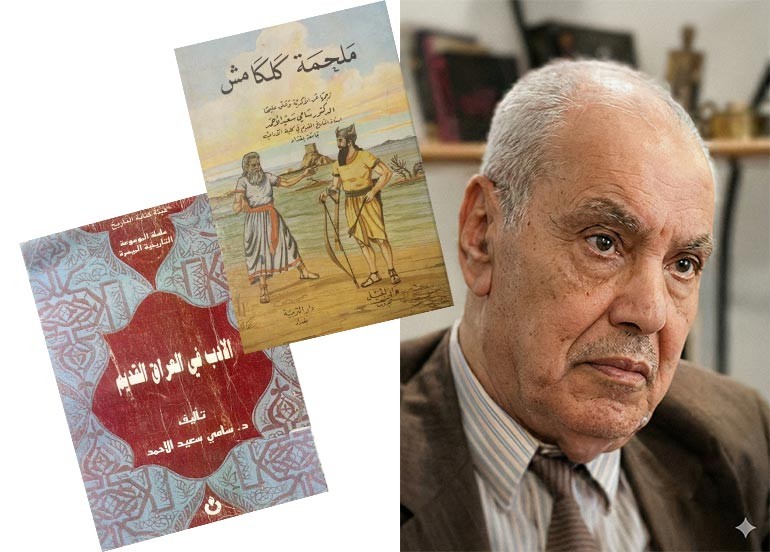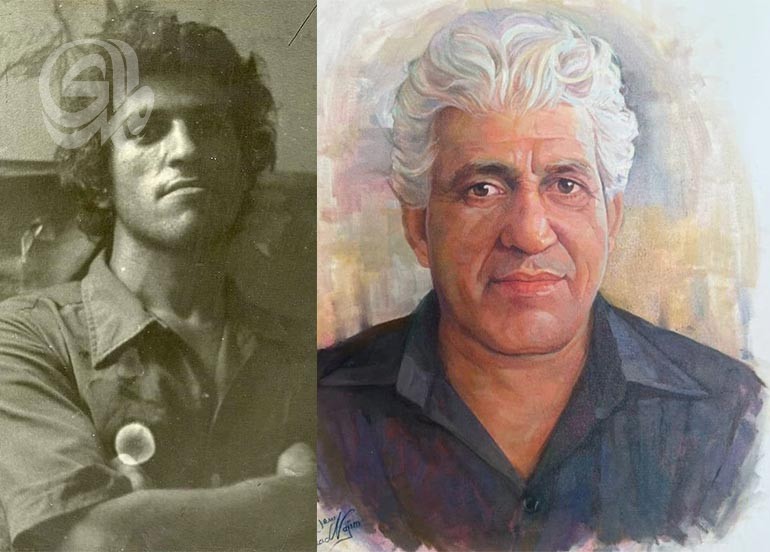د. نادية هناوي
سيطرت الظاهرة التجييلية على شعراء العقود التي تلت حركة الشعر الحر، وبها نفّسوا عن عقدة الريادة، وليست الريادة سوى أصالة ما في هذه الحركة من حداثة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشعر العربي
ولم يشهد تاريخ الشعر حركة مثلها سوى حركة أبي تمام قبل أكثر من ألف ومئتي عام تقريبا. وكان من نتائجها أنها فتحت باب التجريب على مصراعيه في تطوير بنية القصيدة العربية شكلا وموضوعا فكانت قصيدة التفعيلة ثم قصيدة النثر جنسين أدبيين قائمين بذاتهما وتحتهما اندرجت أنواع شعرية مختلفة. تنوعت توصيفاتها لكنها بالمجموع تنضوي في ركب حركة الشعر الحر.
وإذا كان التفرد بسمة تجريبية خاصة أمرا محدودا بعدد من الشعراء المميزين، فان التمظهر بالتجييل كان متاحا للشعراء المهووسين بالتعبير عن أنفسهم جيلا جديدا وليس مهما بعد ذلك أي أمر شعري آخر لأنه ـ برأيهم ــ يظل تابعا أو تاليا للمتغيرات الاجتماعية والإيديولوجية والاقتصادية والفكرية على أساس أنها هي التي قادت الشعر نحو التحول الفني والموضوعي.
وإذا كان جيل الرواد متأثرا في حركته التحديثية الشعرية بالشعر الانجليزي عامة والكلاسيكي منه خاصة وكان ممثلو الحداثة في الشام متأثرين بالشعر الفرنسي، فان أكثر ممثلي التجييل الستيني وما بعده كانوا متأثرين بالتيارات المذهبية والنزعات الفلسفية التي عرفها الأدب الأوربي. وكان من مظاهر هذا التأثر بالعموم القطيعة مع من سبقهم من الشعراء أو التمرد على الأوزان الشعرية أو استعمال المهمل منها.
وكانت قصيدة النثر خير وسيلة في إثبات الفرادة لا على مستوى الإبداع الشعري حسب وإنما على مستوى النقد الأدبي أيضا فكان فاضل العزاوي من أوائل المراهنين نقديا على جعل الجيلية ظاهرة أدبية متخذا من قصيدة النثر مظهرا لها.
وعلى العكس من صنيع نازك الملائكة في تجديد الشعر والتنظير النقدي الموضوعي له، كان صنيع الشعراء المنظرين للتجييل مقصودا منه الشهرة بالتباهي الشخصي بأساليب مختلفة منها كتابة البيانات ومنها تقديم شهادات سيرية ومنها تأليف كتب نقدية. وكل حديث عن جوهر القصيدة وحركتها وعلاقات أبنيتها والمواقف داخلها من الحياة والموت والحقيقة وقوانين مواجهة الكون إنما يأتي ثانويا وتابعا لحديث، تكون المركزية فيه للشاعر وتأكيد مواقفه تجاه الواقع والحياة.
واقرب مثال على ذلك البيان الشعري 1969 الذي ما تطرق إلى دقائق العملية الشعرية ولغة الشعر وأشكاله إلا هي تابعة للحديث عن الإنسان ورحلته في الحياة حيث الإنسان صياد والشعر بندقيته. ولا مناص من القول إن القصدية التي تصنع القصيدة هي نفسها التي تصنع الجيل، وما كان لبودلير ان يكون رائد جيله لولا مداومته العملية على الشعر لا الشعراء وما كان لنازك ان تكون رائدة جيلها لولا أنها اهتمت عمليا بالقصيدة كظاهرة شعرية ينبغي التنظير لها.
بيد ان ما حصل عقب جيل الرواد كان العكس تماما، بمعنى أن القصدية وجهت نحو التجييل الذي صار الشغل الشاغل للشعراء. وإذا كان الشعراء الثلاثة سامي مهدي وعبد القادر الجنابي وفاضل العزاوي قد قدموا شهاداتهم بوصفهم منظرين لجيلهم، فان عدواهم أصابت شاعرا مارس خليطا هجينا يجمع النقد الأدبي بالتوثيق الذي أساسه الاعتراف والتذكر وهو محمد مظلوم الذي شغله التعداد للأسماء والمواقف. أما الشعر فلا يأتي عنده إلا تابعا. وكتابه (حطب إبراهيم أو الجيل البدوي شعر الثمانينات وأجيال الدولة العراقية) إضافة عددية لكتب التجييل العقدي وتقليد واضح لـ(الروح الحية) لفاضل العزاوي و(الموجة الصاخبة) لسامي مهدي، وفيه تقييم شخصي لشعراء جايلوه مع كثير من التسامي والتفاخر والترفع والتقاطع مع شعراء سابقين ولاحقين.
وكما تكلم الشاعر سامي مهدي عن سبقه مجايليه في كتابة الشهادة الشعرية، كذلك تكلم محمد مظلوم عن كونه السابق في تأليف الكتاب عن شعراء الثمانيين في عقد التسعينيات. وبغض النظر عن عقدة تضخيم الذات وهي تعلي نفسها على حساب الجماعة التي تريد ان تؤرخ لها وتتحدث عنها، فان وقوع محمد مظلوم تحت تأثير سامي مهدي كان واضحا أكثر من فاضل العزاوي أو حاتم الصكر أو شاكر لعيبي. ولان قصدية محمد مظلوم من وراء التجييل تصب في باب البحث عن الفرادة، لذا وقع في فخ الإسقاطات القرائية مستسلما للرؤى الإيديولوجية التي صارت تتحكم في مسارات شهاداته وتحليلاته وتعليلاته واستنتاجاته.
والدلائل كثيرة منها أولا أن قصدية التدليل على أن للسلطة دورا في دعم شعراء على حساب غيرهم، جعلته يربط ربطا متعسفا بين فكرة الجيل الشعري وتاريخ الدولة العراقية، مبينا أن الشعر نشأ مع نشوئها علما انه لم يحدد مفهومه لمسمى الدولة واستند في تقسيمه للدولة على ما في الولايات المتحدة الأمريكية من أطوار للدولة وهي: الطور البطولي والطور النبوي والطور الفني والطور البدوي أو البدئي. فهل تصلح مناظرة حال العراق بحال الولايات المتحدة؟ ثم كيف تصح موازنة التعامل مع الإبداع عامة والشعر خاصة بالتعامل مع السياسة والاجتماع؟!
وثانيا قصدية محاباة طائفة من الشعراء يشاركونه توجهاته الإيديولوجية، جعلته يصرف النظر عن الشعراء داخل العراق وكأن لا وجود في المشهد الشعري العراقي سوى للذين هاجروا الى الخارج. وهذا المطب حرف المؤلف عن جادة الموضوعية. إذ أن من يرد تجييل أبناء عصره أو يدلِ بشهادة فعليه أن يكون محايدا كونه يكتب لوجه التاريخ متعاليا على الأهواء ومتناسيا المزاجية والآنية.
ثالثا قصدية الانتقاص من الشعراء الذين بقوا في الداخل واعتبارهم متخاذلين وجبناء وغير فاعلين في مقابل إسقاط صفات بدوية على الشعراء المهاجرين ممن سماهم(الجيل البدوي) ومن تلك الصفات الحرية المطلقة والروح الوثنية وعدم الاندماج بالمكان وقراءة الطالع والاحتيال والتعصب وهي عنده صفات بطولية اتصف بها( عدد كبير من شعراء هذا الجيل عبروا الحدود أو غامروا بعبورها وهم لا يملكون جوازات سفر. إنهم بدو لان تخوم حياتهم تقع بين الحرب والمنفى بين جوقة الحطابين الذين يعدون نارا لإحراق المستقبل وبين المدن التي يصلونها ولا يجدون حياتهم) فنظر إلى الهجرة وكأنها خاصة بالشعراء وحدهم بينما هي شاملة مختلف شرائح المجتمع العراقي ممن كانوا يمثلون دور الرعاة والبدو كي يتمكنوا من الهرب عبر الحدود بسبب ظروف الحرب. وليس في الهرب تنكر لأرض الوطن التي يظل التطلع للعودة إليها قائما بوصفها الأصل والمنبت.
رابعا قصدية إسقاط الموقف الشخصي على النص الشعري جعلت التقييم الأخلاقي يتقدم على التقييم الجمالي وربما يمحوه أحيانا بالمحاكمة والإدانة وتصفية الحسابات القديمة ولو ترك المؤلف أمر التحليل الشعري واكتفى برصد المواقف الإيديولوجية لأبعد نفسه عن هذه التعسفية في النقد التي تدخل في باب العنف الرمزي وليس كما عدها هو من قبيل النقد الثقافي الذي رآه انفع من النقد الأدبي !!.
خامسا القصدية في تنزيه الذات وامتداح النفس نجمت عن فئوية النظر إلى من يشبهونه في الارتحال والهجرة فعدهم لوحدهم جيلا. ومثلما حلل سامي مهدي قصائد معينة لحميد سعيد وخالد علي مصطفى كذلك حلل محمد مظلوم قصائد معينة لعبد الحميد الصائح وصلاح حسن وناصر مؤنس ونصيف الناصري وعبد الزهرة زكي وضياء الدين العلاق وسعدون حاتم.
سادسا خلطه التجييل العقدي بالتقييم النقدي جعله يسقط على النصوص التي يحللها مواقف أصحابها الشعراء من ناحيتين: الأولى تعبوية والثانية أبوية. ولذلك وجه لوما إلى الناقد حاتم الصكر لأنه افرد دراسة مستقلة لديوان عدنان الصائغ كما قام بتخوين مجايليه الذين لم يهاجروا ملصقا بهم صفات التعبئة والتدجين والتسويق متناسيا ان الخوف من التسويق إلى الحرب كان سببا في هروب الكثيرين خارج العراق.
ومثلما تحدث الشاعر سامي مهدي عن أثر المقاهي والجمعيات والمجلات في تشكيل جيله كذلك تحدث الشاعر محمد مظلوم عن أثر مقهى البرلمان ومنتدى الأدباء الشباب ومجلة أسفار في صنفين من الشعراء: صنف عده حطّابا هم شعراء التعبئة والقصيدة المدجنة كرعد بندر ولؤي حقي وصنف عده حطبا والمؤلف نفسه منهم ثم أضاف صنفا ثالثا هو بين بين كعدنان الصائغ وعبد الرزاق الربيعي.
وهنا نتساءل: إذا كان المتحصل من التجييل العقدي مجموعة أسماء، فيها الخامل والفاعل والخافت والصادح والناجح والفاشل والمؤثر والمنعزل فما الفائدة المرجوة إذن من وراء ذلك للقصيدة خاصة والشعر عامة؟ وما النفع من جمعها مع أسماء ذات تجارب قوية ليضع الاخيرة في خانة سماها الجيل الضائع؟ وإذا كانت قصيدة النثر هي الجنس الشعري الأكثر رواجا عند شعراء الثمانينيات فلماذا إذن نفى المؤلف عن نفسه كتابتها وادعى انه امتداد لجيل الرواد؟
لن نجانب الصواب إذا قلنا إن المؤلف لم يستقر على رؤية واضحة في كتابه( حطب إبراهيم ) فكان أن ابتدأ بالتنظير للبدوية، وانتهى بتركها متمسكاً بالحطب والاحتطاب.