بلقيس شرارة
كان ذلك في شهر تشرين الأول عام 1947، عندما انتقلتْ مدرسة دار المعلمين الريفية التي كان والدي محمد شرارة استاذ اللغة العربية فيها، الى محلة «سبع قصور» في الكرادة الشرقية. وانتقلتُ بدروي لثانوية الكرادة الشرقية للبنات.
كانت المدرسة جديدة، وفي دور التأسيس. وصلتُ صباحاً الى المدرسة، وعندما دق الجرس توجهت إلى الصف، كنت في الصف الثاني متوسط، فجلست بجانب فتاة كانت من عمري. إذ كانت الثانوية الشرقية مقتصرة على طالبات من العائلات المعروفة في بغداد، ولم تكن الطبقة العاملة آنذاك باستطاعتها ان تبعث بناتها للتعلم في المدارس.
بعد ان انتهى الدرس خرجنا إلى ساحة المدرسة لقضاء الفرصة، سرتُ بجانب الفتاة التي جلست بجانبها، ودار الحديث بيننا: « أخذتُ ببريق عينيها اللتين تنمان عن قوة شخصيتها المتكاملة بالرغم من صغر سنها... وطغى عليّ جمال روحها وذهنها المتيقظ وفكرها الثاقب المتقد، وجرأنها على المناقشة»، واكتشف من خلالها «من انها متحررة بآرائها، طليعية بمفاهيمها، ثائرة على المجتمع التقليدي الضيق» (جدار بين ظلمتين، ص-195)، كما شعرت خلال الزمن بتميزها عن اقرانها وسلوكها الذي يختلف عن طالبات الصف.
كانت بتول تنتمي إلى عائلة ثرية، وعلمت ان والدها من عائلة القشطيني، كان حاكماً لفترة من الزمن، لكن تغلب عليه عقلية المجتمع السائد في تعصبه وتشدده اتجاه بناته. فكان السائق يجلبها برفقة شقيقتها إلى المدرسة صباح كل يوم، ويجلبهما من المدرسة إلى الدار عصراً. كانت تتوق إلى الحرية التي حُرمتْ منها، والتي كنت اتمتع بها على صغر سني، إذ كان والدي يعاملنا معاملة الند لند، ونتكلم معه كما نتكلم مع صديق.
سألتني بدورها عن عائلتي، أجبتها انني من أصول لبنانية، و والدي مدرس وبنفس الوقت هو أديب وشاعر، وعمي عبد اللطيف شرارة من الكّتاب المعروفين في لبنان، وان جذور العائلة في هذا المجال تعود إلى القرن التاسع عشر.
ومنذ ان ان تعارفنا شعرنا ان افكارنا متقاربة، كانت بتول مولعة بقراءة الكتب الأدبية، ولها قابلية في حفظ الشعر واستعادته، كما كانت متميزة في درس الإنشاء والكتابة، وبذلك توطدت الصداقة بيننا. واصبحت بتول بالنسبة لوالدي كابنته الرابعة.
في تلك الفترة، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، و بسبب الانفتاح تمخض عقد الاربعنيات في العراق عن ظهور حركة ثقافية واسعة، شملت «و واكبت الحركة الوطنية في العراق، وانقلبت إلى ثورة فكرية في جميع المجالات ألادبية والفنية والسياسية والاجتماعية، فازدهرت الأفكار الماركسية واللبيرالية والقومية، كما برزت حركات ادبية في صراع مع الافكار اليسارية هي البودليرية والوجودية والفرودية، وكانت بغداد العاصمة التي تفاعلت وانصهرت فيها جميع الأفكار والحركات المختلفة». (محمد شرارة من الإيمان إلى حرية الفكر، ص-175).
كانت تقام في دارنا الأجتماعات الادبية الاسبوعية، حيث كان يحضرها شعراء من امثال بدر شاكر السياب ولميعة عباس عمارة ونازك الملائكة و والدها صادق الملائكة وبلند الحيدري واكرم الوتري والأديب حسين مروة وكريم مروة و حسن الأمين، والجواهري أحياناً. وقد شكلت الندوة الاسبوعية بداية النهضة الشعرية، التي تركت آثارها على الشعر الحديث في العراق والعالم العربي.
وقد وصفت شقيقتي حياة شرارة الحاضرين في تلك الندوة في المقال الذي كتبته بعنوان: «ندوة الشعر الحر في بغداد الأربعينات» جريدة النهار، الملحق 29/11/1997:
« كان معظم الحاضرين، كما هو واضح، في عمر الشباب، أو الفتوة والصبا، لا يتجاوز حتى الكبار منهم سن الأربعين ما عدا الجواهري. وكانت غالبيتهم على حظ من الوسامة والأناقة، بل البعض منهم يختال الجمال طاغياً جذاباً في محياهم وقوامهم. وكانت الأحلام العذبة والأماني الباسمة تداعب عقولهم وتسري في أرواحهم وتمتزج بأجواء الشعر والنثر الرومانتيكية من قصائد الشابي وإيليا أبو ماضي وكيتس وشيلي وجبران خليل جبران وغيرهم. كان بعضهم ممن توطدت منزلته الشعرية أو الأدبية ومنهم من بدأ بداية تبشر بموهبة لامعة، ومنهم من يلتهم الكتاب تلو الآخر ويصغي للأكبر منه وينتظر دورة الزمن لتتجلى وتبرز إمكاناته الفكرية والأدبية، وهكذا التقى «الصبا والجمال» والأناقة والشعر والحديث الحاذق والكلمة الذكية... لا شك إن محمد شرارة كان ألمضّيف والراعي والمشجع لتلك الندوة بشخصيته القوية واللبقة البشوش وروحه الاجتماعية ونقداته الأدبية الذكية وحديثه الممتع وحفاوته بالوافدين وحبه للضيافة».
وكنت احّدث بتول عن تلك الاجتماعات الأدبية والشعرية التي كانت تقام كل يوم خميس في دارنا. وبمرور الوقت حضرت بتول بعض تلك الأجتماعات، وكان لوالدي تأثير كبير على تفكيرها واتجاهها، إذ كان والدها من المحافظين في آرائهم، و كانت معظم العائلات محافظة في تربيتها وتوجيهها وخاصة تجاه البنات. لكن والدي كان معجباً بثورتها على الركود الاجتماعي والفكري الذي يطوقها من كل جانب.
كانت بتول معجبة بالشاعر المتنبي، وحفظت معظم شعره، إذ لها قابلية كبيرة في حفظ الشعر، كما كان والدي من المعجبين به أيضاً وكتب كتاباً عنه بعنوان: «المتنبي بين البطولة والاغتراب». فكانت عندما تزورنا تجلس مع والدي، تقرأ بعض ابيات المتنبي ويجيبها والدي بابيات أخرى له.
لم تستسغ بعض الطالبات هذه الصداقة المقرونة بالتقارب الفكري، إنما حذرني البعض من العائلات الشيعية «من هذه الصداقة، بدعوى ان بتول من الطائفة السنية ويجب الحذر منها، بالرغم من أن الحديث الطائفي كان ضمنياً وليس مباشرا». إذ قالوا لي: (هي مو من عدْنا)، أي لا تعود لطائفتنا وهي الطائفة الشيعية. واستغربت من هذا الكلام البعيد عن أجوائي، إذ نشأنا نؤمن بالانسان وبالمساواة، وليس هنالك فرق بين مسيحي ومسلم أو يهودي أوبوذي. لذا توطدت صداقتنا خلال الزمن «كشجرة الزيتون الكبيرة التي ترمز للصمود بوجه الأعاصير» (هكذا مرّت الأيام ص-84).
وافترقنا بعد ان انهينا الثانوية، فاصبحتُ تلميذة في كلية الآداب، وبتول في كلية البنات، ومن الصدف أن كلية البنات وكلية الآداب كان موقعهما في باب المعظم، يفصلهما الشارع فقط. فأصبحت أعبر الشارع في كل فرصة واقضي فرصة العشرة دقائق مع صديقتي بتول.
وفي عام 1954 تزوجتُ رفعة الجادرجي وسكنتُ شارع طه في حي الأعظمية، وشاءت الصدف ان انتقلت بتول إلى نفس المنطقة بعد ان بنى والدها داراً قريبة من المنطقة. فاستمرت لقاءاتنا، ثم خطبت بتول وتزوجت من قريبها حسين الامام، الذي كان من خريجي انكلترا، منفتحاً لبيراي التفكير. واضطرت في البداية الى العيش في البصرة بضعة اعوام، ثم عادت إلى بغداد.
ومرّت الأيام والسنين، لكننا لم نكن ندري ان القدر سيجمعنا حتى في المآسي. فبعد ان استلم الحكم صدام حسين واصبح رئيساً للجمهورية عام 1979، لم يقتصر على تصفية اعضاء حزب البعث المهمين، وانما شملت التصفيات فئة كبيرة من مثقفي البلد من الأطباء والمحامين و المهندسين والمعماريين، واصبح كل شخص معرّض لألقاء القبض عليه. واطبقت الرقابة المشددة على المجتمع وعلى إرادة وحرية الإنسان. لذا أصبح أحياناً استعمال الشفرة حتى في المحادثات التلفونية شيء طبيعي.
القي القبض على زوجي رفعة بعد عودته من النمسا في شهر كانون الأول 16/12/1978، فقد كان مدعواً من قبل جامعتي فينا وانزبرغ، حيث اقيم معرضاً لأعماله، والقى محاضرتين بتلك المناسبة. واتصلتْ بي بتول وجاءت لزيارتي عندما علمتْ بالقاء القبض على رفعة، وقضتْ ذلك الصباح معي تحاول أن تخفف من عبء الصدمة التي اصابتني، فلم أنم طيلة الليل، بل بقيتُ في الطارمة مع والدة رفعة حتى الثالثة صباحاً. عادت بتول إلى دارها ظهراً، لتجد ان شقيقها محمود، وهو مهندس من خريجي انكلترا، قد القي القبض عليه أيضاً، اذ طلبوه كشاهد في القضية التي اعتقل من اجلها سابقا، حيث صدر الحكم عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات، و على رفعة بالسجن المؤبد.
واصبحت لقاءتنا في السجن ايضاً، إذ ضم السجن في تلك الفترة خيرة أبناء البلد. ودامت المحاولات والتشبث في تخفيف الحكم أو أطلاق سراحما. وكنا في حديث متواصل عما استطعنا ان نقوم به من محاولات واتصالات بالمسؤولين في تلك المدة العصيبة التي مرّت علينا، و التي جميعها باءت بالفشل، حتى قرر صدام حسين اطلاق سراح رفعة بسبب الحاجة إليه، إذا كان « مؤتمر عدم الأنحياز» سيعقد في بغداد عام 1982.
وبعد ان اطلق سراح رفعة من السجن بعد ان قضى عاماً ونصف، قرر آلا يبقى أكثر من عامين في العراق، اما محمود شقيق بتول فقد اطلق سراحه بعد أن قضى عامين ونصف في السجن.
افترقنا ثانية بعد أن سافرتُ مع رفعة إلى الولايات المتحدة، وقضينا عشرة اعوام فيها، عدنا إلى لندن وقرر رفعة آلا يعود إلى العراق. إذ بعد أن خاض صدام حسين الحرب التي شنها على إيران لمدة ثمانية أعوام، خرج العراق منهكاً ومديوناً، حتى دخل في حرب أخرى واحتل الكويت، وبعد تحرير الكويت، فُرض على العراق حصاراً اقتصادياً قاسياً، إذ فقد العراقيون ابسط أمور العيش حتى شمل المواد الغذائية. فهجم الناس على مديرية السفر محاولين الحصول على جواز السفر الذي اصبح رمزاً للحرية والتخلص من قيود الكبت التي جثت على صدورهم.
وانساب الزمن وجرت الأيام بسرعة، «هجرتْ العقول وطنها، وبدأت تنضب في جميع الحقول، الجامعات فرغت من خيرة اساتذتها والمستشفيات من خيرة اطبائها والمهندسون مشتتون في جميع انحاء العالم. «هكذا مرت الأيام ص- 336». فقررت بتول وزوجها الهجرة أيضاً وسكنا انكلترا، وشاءت الصدف ان نلتقي ثانية، في كنكيستين.
والآن بعد ان فقدتْ بتول زوجها حسين في نهاية عام 2018، رحل رفعة أيضاً منذ عامين ونصف، وأصبحنا أرملتين، لكن الزمن كان قاسيا مع بتول، فقد أصيبت بمرض الباركنسين، الذي أدى بها إلى أن تصبح مقعدة، لكن استمرت زيارتي لها ولقائي بها اسبوعياً. والآن ليس هنالك مستقبل إلا الحاضر الذي نعيشه من يوم إلى يوم، حاضر محاط بضباب اليأس، إذ ليس هنالك شيء مفرح نتحدث عنه، وخاصة حاضر بلدنا وبلدان الشرق الآوسط. ولكن ما زال إلى الآن ما يجمعني ببتول طيلة هذه المدة الطويلة من الزمن أي ثلاثة أرباع القرن، هو التقارب الفكري وحبنا للأدب والشعر، انها علاقة فكرية بحتة.






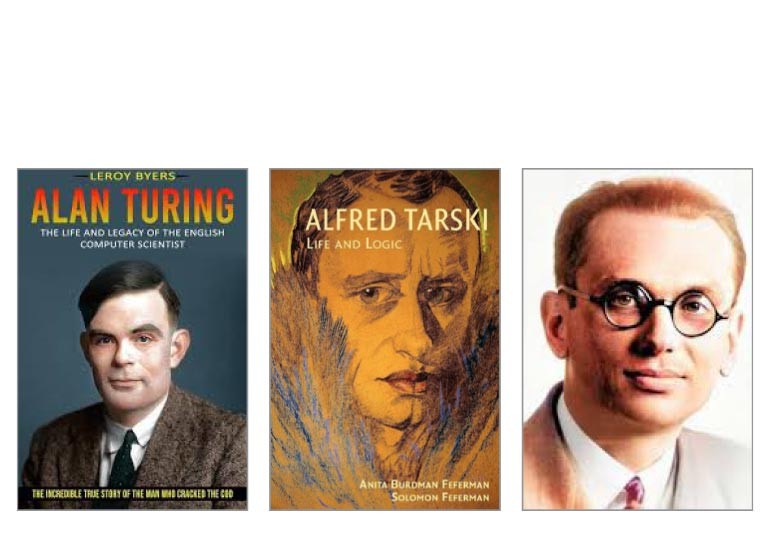
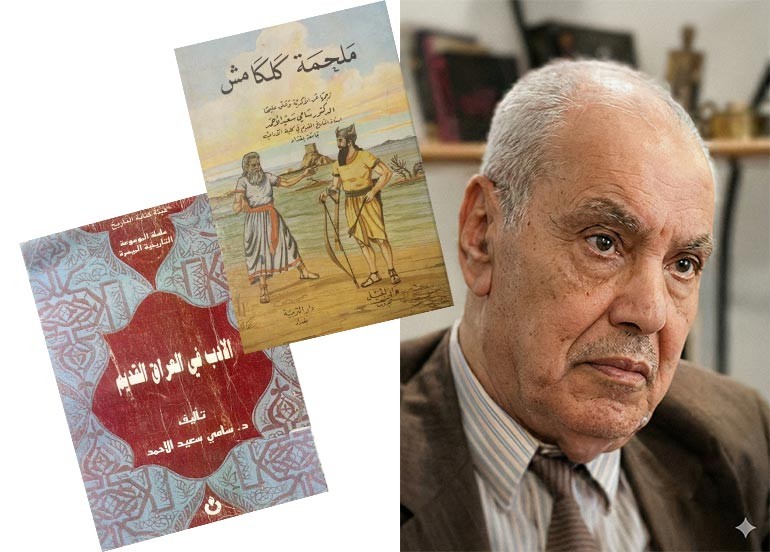
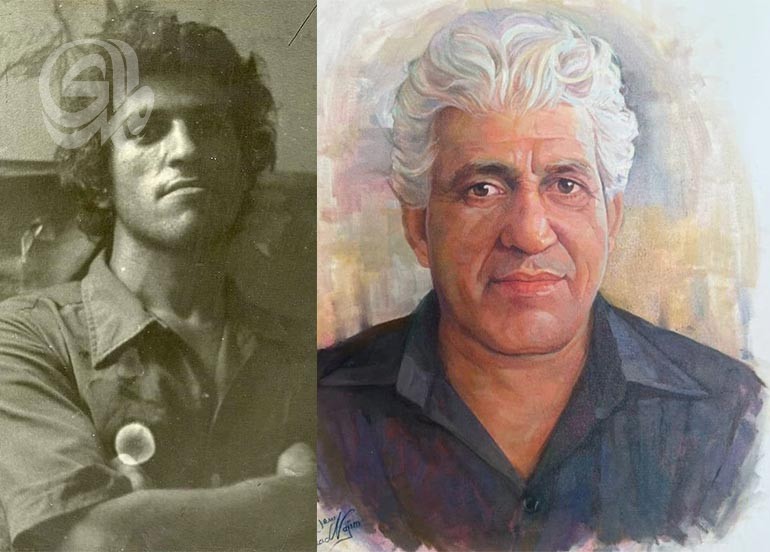


جميع التعليقات 1
د.سمير عبد الرسول العبيدي
مقال مميز...سرد للذاكرة وتوثيق للتاريخ...مع الاشارة الضمنية لمصادر مميزة...شكرا لكم