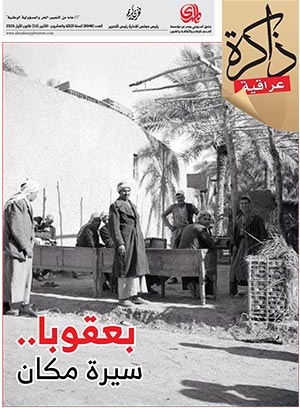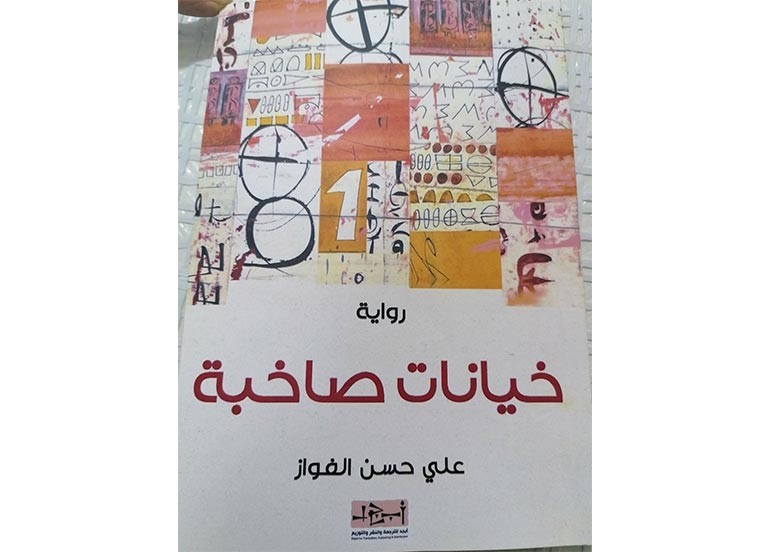لطفية الدليمي
لعل حنين الإنسان إلى اليوتوبيا وتوقه إلى الحرية الغائبة والمغيبة عن أزمنة الناس في بلادنا، فضلاً عن شوقه النوستالجي إلى الطقوس والفعاليات التي غابت عن راهن حياته ولبثت تقيم في أغوار لاوعيه ومكبوتاته،
هي مايدفعه إلى التشبث بسلطة الوهم وتبنّي آليات التوهم ليواجه بها العنف الذي يحكم عالمه بغرائب طرائق القتل الناعمة والخشنة التي تُديم تهديد وجود المرء في كل آن وهو الطريد المحاصر بفخاخ هنا وكمائن هناك.
أين يتجه هذا الإنسان المطارد وهو في عجزه عن المواجهة والهرب؟ من سيأخذ بيد هذا الكائن المرصود لميتات عبثية؟ ومن سيكون حامي هذا الكائن المطارد في غابات البشر من بائعي رؤوس الناس في صناديق تفاح وموز ومن مكفّري الناس والمتخذين من أنفسهم قضاة ينزلون القصاص بالأغيار وكأن الأرض خلت من أي قانون أو شريعة وترادفت فيها المجازر التي أبادت الملايين من الذين لاذنب لهم غير أنهم وجدوا أنفسهم على دين ذويهم أو أنهم توارثوا الصفات والأسماء والتقاليد في أرض ضمت منذ آلاف السنين أجداث أسلافهم وتراث العقول النيرة من مبدعي العصور الغابرة، أو أنهم من أولئك الساعين في الأرض لطلب رزق أو علم أو من الغافلين العابرين جهات العالم إلى حلم أو المشيدين صرحاً من صروح الفن والحضارة .
ليس أمام الميت التالي أو المقتول اللاحق غير أن يركن إلى يقين يقيه من عداوة الجاهلين ويحاول أن يوجدَ في اللحظة الضارية مؤمناً بأن حياته- التي لاتعني للقاتل غير إطلاقة في الرأس - تساوي حياة الناس جميعاً في شرائع السماء.
من يعزّي المرصود للقتل؟ لاأحد غير فسحة وَهمٍ صغيرة بحجم حلم يخشى الإفصاح عنه ويحتضنه ويحميه كأنه سر خلاصه، ويتبناه ويؤمن به حتى ليصير مالك زمامه ومحرك كينونته الحاضرة وتصوره لما هو آت من أيامه - إن أتى ! ! . يقر الوهم آنئذٍ باعتباره أمراً مسلماً به بينه وبين غريزة البقاء لديه ؛ فيأخذه علاجاً، ويمارسه اعتياداً أو وسيلة ورثها من أسلاف حالمين وعمل على تطويرها عبر الأزمنة، واعتنقه في جميع مراحل نموه وتطوره.
فيوض الوهم تمدُّ الإنسان بقوة دافقة تتوالد في أعماقه وأمداء روحه المهددة ليجابه بها الخواء والعدم الذي يلاحقه بشكل حروب أو عنف منظم أو إرهاب أو إرهاصات مجتمع متغير أو حتى فشل شخصي. تماثِلُ قوة الوهم لدى الانسان ومضةَ برق أو شرراً بوسعه إشعال الحريق في ركود المخيلة والتكرار البليد ليوميات العيش ومستلزمات البقاء، ويسمو ذلك الوهم بصاحبه فوق تدابير المحو والفتك ولو إلى حين من الوقت.
المبدع والوهم
يقف المبدع في فضاء الأمكنة ومديات الزمان، وينوجد ضمن حركة الأحداث حيث التغيرات المتوالدة عن مرور الوقت وتبدّلات الأمكنة واندثار أساطير وتقوّض مفهومات وموت طقوس وتهاوي قيمٍ وامّحاء ظواهر وتوالد بدائل عن كل مندثر أو ممحوّ، وبإزاء هذا التقوض والاندثار والتغير المتواتر يتمسّك الفرد الخلّاق بشيء يحتمي به من التهديدات التي تتربص بوجوده ونتاجه ويحاول أن يلوذ بأفيائه المفترضة ويحيا في تدابيره اللامرئية. يحتمي بالوهم الممتع مقابل قبح الواقع وسلطته الفاتكة، تتغير أشياء وتزول أخرى وتحل محلها أشياء وأشياء ؛ غير أن الوهم يبقى ملاذ المبدعين والقوة التي تحكم سيرورة الجهد الإنساني إبداعاً وعيشاً يملأ شواغر الوقت وثغرات الأمكنة التي تنشأ عن التحولات الاجتماعية والإقتصادية والسياسية والمعرفية والتغيرات التي تتكفل بها الطبيعة من زوال ونشوء.
كل إبداع مُبتَكَر هو نتاج مخيلة «تتوهم»، يدرك معه الفنان أنه يلج منطقة أخرى موازية للواقع أو متقاطعة معه، هي فضاء الوهم الذي ماأن يبلغه حتى يقع تحت هيمنة سحره وغواياته وإمكاناته التي لا تحدُّ.
العمل الإبداعي إجراء بديل للسحر البدائي لدى الإنسان الأول لانطوائه على علامات وإشارات توجِدُ شعوراً بالأمان وتقدّمُ بديلاً عن واقع ما أو صورة محورة عنه أو شكلاً ممسوخا له. ينطوي العمل الفني أو النص على مفاعيل سحرية تفتن وتقود إلى استيهامات نعوّضُ بها - منتجين أو متلقّين- عن نقصان أو غياب مقومات وجود أو اشتراطات بقاء، وتعيننا هذه التوهمات ذات التأثير السحري على جعل حياتنا ممكنة ومحتملة لنواصل التحرك في المديات المتاحة لوجودنا الإنساني. هكذا نجتاز خط الحظر والتحريم وندخل أقاليم الغرابة عندما نبدع أو ننشغل بفكرة أو حتى حين ننام ونحلم، مستعينين بالوهم للإمساك بالمستحيل في لحظات الرؤيا. عندئذ نتحول وندخل أطواراً متباينة ؛ فنكون مرة أبطالاً لنصوصنا أو شهوداً على شخوص أعمالنا. في النوم نكون أبطال أحلامنا أو متفرجين على مستحيلات أحداث نقوم بها بأنفسنا ؛ أما عندما يأخذنا الفكر والتفكر فإننا نضع أنفسنا بدلاء عن أنفسنا أو عن آخرين سوانا - أي نكون أنفسنا ولانكونها في الآن ذاته. نفكر بالآخر وله ومعه خارج حدود وجودنا المادي والمجازي لهدف بسيط وغامض، معلن وخفي: أن نملأ مجلدات الزمن- زمننا - بأشياء وأحداث مصنوعة بمزيج من اللغة والصور. أحداثٌ توهمناها أو أوهَمْنا الآخر بحدوثها، وندّعي - أو يخيل إلينا - أننا شاركنا فيها أو شهدنا وقوعها.
بوَهْمنا الساحر وبتوهمنا الخادع نرصُّ في الفراغات الشاسعة المحدقة بمخاوفنا العبارات والمقاطع والصور والألوان والأنغام ونملأ الأمكنة والوقت باستعارات نستمدها من واقع متخيل لنقترح واقعاً وهمياً في العمل الابداعي ؛ فنبتكر سلالات بشر وبحاراً وعوالم، ونجول في الفضاء أو يستغرقنا التصدي لأضداد يتوالدون من مخاوفنا، أو نبتكر أحباء ينهمرون من فجوات أشواقنا أو نحظى برفقة عابرة أو تتفتح بين يأسنا حزمةٌ من آمال أو نجترح مآثر ونقطف مُتَعاً ونحيا مباهج متخيلة ؛ وبذا نستبدل ما ينقصنا بالوهم منطلقين من تصوراتنا عن واقع ما، تمدُّنا به المخيّلة بعون من وسائل التعبير المختلفة، لا لشيء إلا لنعوّض عن فقدان حيثيات كثيرة أو غيابها من حياتنا أو لطغيان حيثيات أخرى عليها مما أفضى إلى تغييبنا عن ممكنات الواقع ؛ فنعيش وهْماً يهدئ من وتيرة إقصائنا عن المشهد الحياتي ويرجئ - وإن إلى حين- لحظة فنائنا.
الإبداع إنما هو إقرار بوجود حلم، بإمكاناتٍ أخرى نتوهمها، نرغبها وننشدها وهي كامنة فينا ومتموضعة في مخيلاتنا صانعةِ أوهامنا الفردوسية.
في الكتابة – الإبداع نقصي «الآن» والـ «هنا» من أجل «الآتي» والـ»هناك» بعونٍ من آليات التوهم والتخيل وإمكاناتهما، وتـأخذنا مُتَعُ الوهم إلى معابر تنقل خطوتنا إلى أزمنة وأمكنة مغايرة، سواء نحو الماضي على سبيل الاستحضار والتذكر أو باتجاه المستقبل عن طريق الحلم والتخيل. لكن ماالذي يساعدنا على المضي في النزهة الخطرة من غير أن نتراجع أو نتوقف؟ إنها قدرتنا على النسيان والتخطي والبدء كل آونة من جديد، وذلك هو سر ديمومة الإنسان مذ وجد على أرض البشر.
النسيان: نزهتنا الخطرة
عندما تتلظى الذاكرة في هيجانها وتدور أو تتطاول أو تشكّلُ حلقة نارية تطوّقُ الوعي فإنها ترغمه على تلقّي رسائل وشفرات ووهجات واهنة من الماضي، تحاصره وتستعبده بغواياتها فتثير الحنين الطفولي وتروض جموحه بمخزون من الخبرات الراسخة وأصداء الأصوات والروائح والتجارب الهالكة وتؤجج الحنين المَرَضي إلى ذلك الذي تلاشى وانتهى في طيات الزمن المندحر في محاولة لتدجين المخيلة النشطة والتحكم بها وإعاقة انبعاث نتاجها ليبقى الوعي في المنطقة القلقة الحرجة، بين القبول بمكر الذاكرة أو التصدي لها في المعبر الخطر المؤلم الذي يماثل آلات التعذيب القروسطية من تلك التي نراها في قلاع أوروبا الوسطى: عجلات مسننة، نير خشبي، سلاسل تنتهي بأغلال.
هذه هي الذاكرة المعيقة، حاجز المنع وسلطة الحنين الطاغية. فكيف نحدُّ من سطوتها ونوقف فعلها الجهنمي في وعينا المحاصر؟ وكيف ننجو من ألاعيبها ومكرها وهي تقف في وجهنا مشهرة سلطة الضد والآخر المعادي ناقض آمالنا؟ وكيف نقوّض سلطتها ونفلت من أسنانها الفولاذ الناشبة بلحم حاضرنا؟
يكمن الجواب في وسيلة ذات وجهين متلازمين: الوهم والنسيان ؛ ففي اللحظة التي يحاول المرء فيها الإمساك بالوهم يتوجّبُ عليه أن ينسى ليصدّق وهمه، ولحظةَ يمسك بالنسيان يمكنه أن يتوهم وينسى أنه ينسى، وعند ذاك سيدخل أرض النزهة الموعودة الخطرة، في عربة يجرها جوادان توأم: الوهم والنسيان. تأخذه النزهة – المخاطرة (أو المغامرة، لافرق ! ! ) إلى حيث يفلت من جحيم التذكر أو نعيمه، وتقترح عليه فعل التحرر من سطوة الذاكرة وعبودية الأمس. هذه المجازفة شرط للمضي في اقتحام أقاليم العجائب، وآفاق الكشوف المدهشة، خلاصاً من اليومي المكرر والمستعاد الرث، وعندئذ سيوقفنا سؤال النسيان أمام تحد آخر: كيف نمسك به ونروض فيوض وجوده المضطرب فينا؟ وكيف نغلّب سلطته على سلطة الذاكرة المستمكنة في عقولنا؟ أو كيف نعتنقه ونحن نهرب من لظى الأحداث التراجيدية ووجع التجارب وألم الفقدان وندخل بوابته المشرعة أمامنا؟
قد نجد لدى البوابة الغامضة التي يلفها الضباب الأبدي والدخان أعمدة متبلورة شبيهة شواخص ملحية أو نفاجأ بغدران متجمدة يعلوها زبد الأحداث المتهاوية، وقد نلمح حقولاً من نجيمات وزنابق، من جليد يشع نصوعها تحت شموس من صهير أبيض، ولأجل عبورها لابد لنا من أن نؤدي ثمن التحول الخطر من يقظة التذكر المهيمنة إلى خواء النسيان الشاسع. آنئذ، نهَبُ مفاتيح الذاكرة لرياح مثلجة تدور بها في متاهات الأعصر الجليدية الأولى وندع البياض الأزلي يغمر تلك الحجرات المكتظة برماد الزمن والغبار ومواثل الموت والصدأ والاصداء، وسوف يكتسي كلُّ مافيها بالبياض، سيغدو فراغاً، عدماً، ذاكرة ممحوة مجلوة شبيهة الغياب. سوف تحطُّ الذاكرة مثل طائر التم الأبيض في الهوة الثلجية ويتلاشى البياض في البياض لتبدأ مملكة النسيان في الظهور. عندها تمضي النزهة في الفانتازيا الكبرى التي ترجىء - إلى حين - التلامس مع الواقع ؛ ولكن، ليس هذا هو المهرب النهائي، إنها النزهة المؤقتة، والعقار المهدىء الذي تعقبه إجراءات السطوع ضمن حرارة الواقع والوقائع.
إن إمكان الحياة وسط المخاطر إنما هي إمكانيةُ أن نحتفي بالشمس والوردة والينبوع، بالفكرة والنغم واللون، بالجمال والحب والحلم، لنديم فعل الحياة الذي يشترط إمكانين آخرين:
- العمل: إيجابية الفعل
- الوهم: اجتراح الرؤى
فإذا تعذر علينا الفعل في حقب الاضطراب والفوضى والمهالك - كما هو حاصل في برهتنا الراهنة - وفي أمكنة التهديد والتلويح بإقصائنا -مبدعين وفاعلين - من الحياة فاننا نستبدل العدم الحاصل من عجزنا عن الإنجاز بوهم إنجاز آخر على مستوى الحلم حتى لايطحننا الخواء وتبتلعنا الثغرات الفاغرة في الزمن العبثي والأمكنة الخطرة ؛ فلا نقف في محنة القنوط إزاء إرجاء الفعل وعجزه عن التحقق، بل نتبنى تمثّلاتِ الوهم المنقذ ووهجات الحلم والتوق إلى المجاهل الفاتنة فلا نتبدد في هجمة العاصفة واصطفاق الموج .
لعلّ عبورنا من متاهات الذاكرة إلى مملكة النسيان هو مايمنحنا إمكانية مزاولة الحلم والوهم الممتع، ويهيئنا للإقدام على الفعل المُرجَأ - إنما علينا أن نحتاط من سطوة ذلك النسيان وشراسته ومخاطره ونحول بينه وبين شراهته العاتية وبين احتلاله لجميع طبقات الذاكرة التي تضم كنوزنا وبذور معارفنا وموروثنا ونفائس خبراتنا، ونوجهه حتى لايمسّ صروح مكتسباتنا المعرفية بل نقوده ليطمس الخرائب ويزيح الأنقاض وركام الرماد والحراشف الميتة والخبرات المؤلمة، ونوصد بوجهه الذاهل سبل الانفراد بذاكرتنا فنجعل منه قوة بناءة لاسلطة هدمٍ تهدد تقدمنا في الفعل وجهدنا في الإبداع وامتدادنا في الزمن.