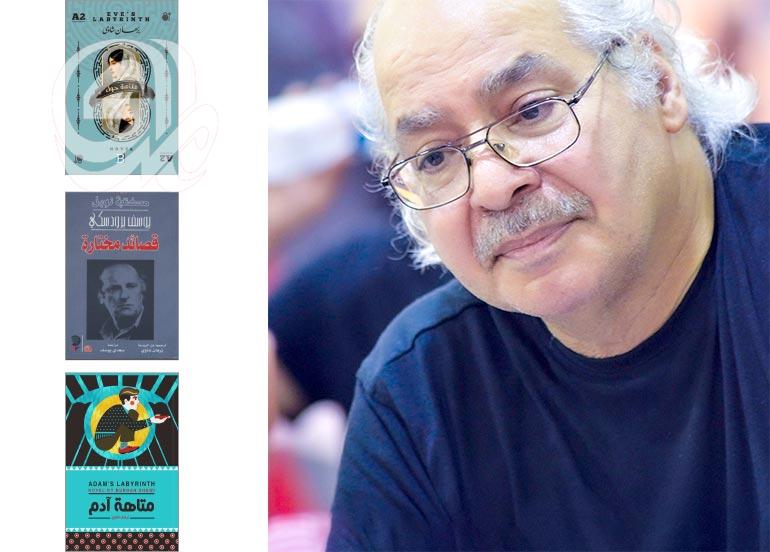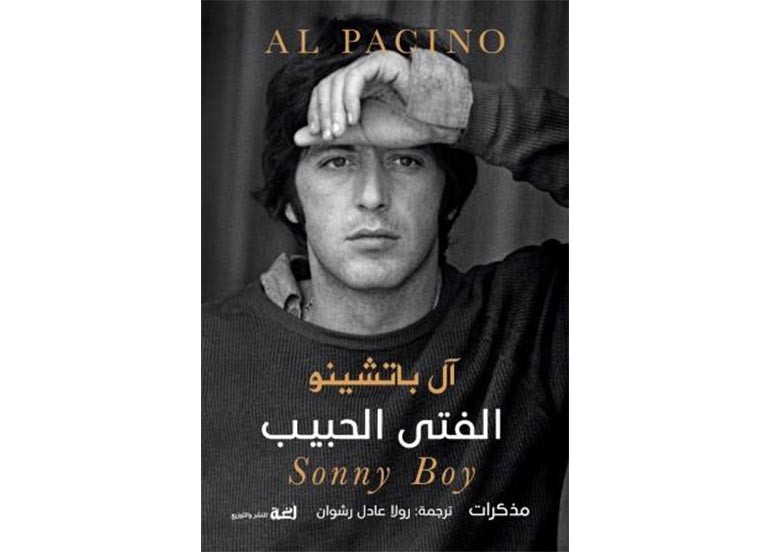يرى أنه يتحفظ على مسألة إزاحة الرواية للشعر عن عرشه
حاوره: علاء المفرجي
- 1 -
بُرهان شاوي مجول، المولود في الكوت عام 1955 ،
غادر العراق عام 1979 بعد اعتقاله، متوجها الى بيروت بعد أن شهدت تلك الفترة حملة قمعية ضد اليسار العراقي والأحزاب التقدمية. نال دكتوراه في التاريخ الحديث – موسكو – 2010- دكتوراه إعلام (جامعة موسكو- كلية اللغات- 1997)، والماجستير فنون جميلة (المعهد العالي للسينما لعموم الاتحاد السوفيتي-موسكو-1985)
عمل في الصحافة العراقية المكتوبة منذ العام 1971، كما عمل في الصحافة اللبنانية 1979-1980، وعمل اثناء اقامته في اوربا بشكل حر في التلفزيون الألماني والهولندي وعمل برامج وأفلام وتدريس السيناريو في المانيا مابين 1986-1997، كما عمل رئيسا للقسم الثقافي في جريدة الاتحاد الظبيانية ما بين العام 1997-2002، وفي تلفزيون أبوظبي ما بين العام 2002-2003. كما عمل إستاذا زائرا في كلية الإعلام والمعلومات والعلاقات العامة – جامعة عجمان – فرع ابوظبي مابين 2002 - 2003.. وعمل محررا في موقع القنطرة التابع للتلفزيون الألماني، عند استقراره في المانيا.
وتقلد بعد 2003 منصب مدير عام لقناة الحرية الفضائية منذ كانون الاول من العام 2005 ولغاية 2009. ومنصب المدير تنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات في العراق من العام 2009 ولغاية 2011، وعميدأ لكلية الاعلام في جامعة ابن رشد في هولندا.
وصدرت له مؤلفات عديدة منها: المدخل إلى نظريات الإعلام والاتصال الجماهيري 2003، الدعاية والآتصال الجماهيري عبر التاريخ 2011 ، وهـم الحرية - محاولة للإقتراب من مفهوم حرية الفكر والإرادة، سحر السينما.
كما صدرت له في مجال الترجمة عدد من الترجمات في الأدب، وسبعة مجموعات شعرية، وصدت له روايات: الجحيم المقدس - كُتبت في العام 1987 ونشرت الكترونيا 2003 وورقيا في العام 2006 ط1 وفي العام 2007 ط 2، و2012 طبعة عربية ، مشرحة بغداد 2011 ، متاهة آدم 2011، متاهة حواء 2012 ، متاهة قابيل 2013.
أسال عن الطفولة والنشأة الأولى وتأثيرهما بما أصبحت، وماهي المصادر والمراجع الشخصية والمعنوية التي أسهمت في اختيارك طريق الكتاب شعرا ونثرا؟ تحدث أيضا عن البيئة التي نشأت بها؟
- ولدت في عكد الأكراد بمدينة الكوت، التي تقع جنوب بغداد بما يقارب 180 كيلومترا، وهي التي تغير اسمها إلى (واسط) برغبة نظام البعث في تعريب العراق، حيث تقع (واسط) الحقيقية بالقرب من قضاء الحي، مدينة المغني الشعبي سلمان المنكوب. و (واسط) مدينة أقامها المجرم التاريخي الحجاج ابن يوسف الثقفي والتي تضم مرقد العلامة الجليل (سعيد بن الجبير).
تاريخ ولادتي غير دقيق أبدًا، فأنا الابن الثاني عشر في العائلة، وكما يقال بلهجتنا العراقية (بزر الكعدة). حيث كان أهلي وأخوتي يروون حتى وقت ولادتي وطبيعة الطقس في ذلك اليوم. ولدت عصرا في الأول يوم من رمضان قبل الأذان بوقت قصير وكانت السماء تنذر بالمطر. لكن التبس عليهم الأمر، فقد ولدت في البيت وليس في مشفى، لذاواحد يقول كانت في هذه السنة، وةيعارضه الثاني بأنها كانت قبل ثورة تموز بسنة..وهكذا، لكن حين كنت في الرابعة والنصف أو بداية الخامسة، أخذني أخي ليسجلني في المدرسة، إدّعى بأنني دخلت السنة السادسة، ولأن موظف التسجيل كان من معارفنا فقد قبلني.
في مدينة الكوت ترعرعت. مدينة هي بالأساس شبه جزيرة حيث يلتقف حولها دجلة قبل أن يتوجه إلى الجنوب مارا بالعمارة ليصل البصرة ويدخل في تكوين شط العرب. وولدت في (عكد الأكراد) الذي كان يسمى سياسيا (موسكو الصغيرة) لتوجه شباب ورجال عوائل سكانه إلى اليسار، ولا يسار في العراق آنذاك غير الحزب الشيوعي.
في الكوت انهيت الابتدائية والمتوسطة. وفي المتوسطة بدأت علاقتي الأولى بالسياسية. فقد كان أخي الأكبر عاملا شيوعيا. وكانت، حينها، موجة الحزب الشيوعي عالية وصاخبة. ولأنه خرج متظاهرا ضد الانقلاب الفاشي للبعث في 1963 في الكوت، أطلق (الحرس القومي)، الجناح المسلح للبعثيين الرصاص على المتظاهرين، فأصيب بطلقة في كفه.
وحين نقل إلى المستشفى تم اعتقاله من هناك، ونقل إلى سجن الكوت. وكنت أزوره مع أمي التي كانت تحمل الطعام. لذا، عرفت عالم السجون وأنا ما بين الخامسة والسادسة.
بعد خروج أخي من التوقيف هرب إلى إيران. وجرّاء ذلك كان بيتنا يتعرض ليليا إلى مداهمات الحرس القومي تفتيشأ عن أخي الهارب. وكان والدي يسترضيهم بالمال، حسب إمكانياته. بل، لم تكن المداهمات تخصنا، بل كان في عكد الأكراد عددا من بيوتات الشيوعيين. وقد سردت مشاهدا من تلك المداهمات في إحدى متاهاتي. وحين كبرت تم اعتقالي أيضا، وعرفت معنى ذلك. لذا مشاهد الاعتقال والتعذيب وعالم السجون موجود في معظم أعمالي السردية الروائية بل وحتى في قصائدي.
مرجعياتي الأدبية رومانسية، ودينية، جبران والمنلفوطي والرافعي وإشعراء المهجر وعلى رأسهم إيليا أبو ماضي. أما مرجعياتي الدينية، فكانت كتاب (المراجعات) لشرف الدين الموسوي، وشجرة طوبى، ونهج البلاغة، ثم تعرفت على فلسفتنا اقتصادنا امحمد باقر الصدر، الذي دفعني للتوجه إلى النصوص الأصلية لماركس وانجلز فتجت على مرجعيات جديدة.، لاسيما كتاب (أصل العائلة والملكية الفردية) لأفريديك أنجلز. لكن النشاط الطلابي السياسي وما كان يجري من أحداث الاعتقالات للشيوعيين عجلت في نمو الزعي الفكري والسياسي لديّ، وبشكل مبكر، وقد رويت ذلك من خلال شخصيات روائية في متاهاتي.
من الشعر إلى الرواية
بدأت كشاعر، وشاعر واعد يحسب له كثيرا، حتى إنك أصدرت ما يقرب من 7 مجاميع شعرية قبل ان تكسبك الرواية إلى جانبها، هل لأن للرواية فضاء أوسع قادر ان يلم بكل ماتريده، أم لأنه زمن الرواية كما يرى الكثير؟
- مازلت شاعرًا. وقد توجهت إلى الرواية بروح الشاعر. لذا فالروح الشعري تهيمن على بنية السرد الروائي لديّ، بل الشعر يهيمن على عالمي السردي، لذا تكثر النصوص الشعرية في رواياتي...
أما عن سؤال الانتقال من الشعر إلى الرواية، لأن فضاءها أوسع من القصيدة، اعتقد في صحة هذا، ولأن بنية القصيدة تعتمد على الإيجاز في اللغة والتكثيف، بينما السرد الروائي يعتمد على البوح والاسترسال الطويل. ولقد عارضت مقولة المتصوف عبدالجبار النفّري المشهورة: (كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة)، بأنها تخص الشعر والبلاغة والأمثال والحكم، لكنها لا تخص السرد الروائي، وقلت : ( كلما اتسعت الرؤية تفجرت اللغة وفاض الكلام).
هناك آراء عشوائية في عالمنا الأدبي، بعضها يقول إن الشاعر الذي يذهب إلى الرواية هو شاعر فاشل، وكذا الناقد الأدبي فهو فاشل في السرد والشعر لذا توجه لنقدهما، وهذا الأمر ينم عن جهل فاضح بتاريخ الرواية والشعر أيضا، لأن تاريخ الأدب العالمي بكل قومياته ولغاته يثبت أن معظم الروائيين كتبوا الشعر وانتقلوا إلى الرواية. وساضرب مثلا بروائييّن هما شاعران مجيدان أيضا، وهما ميلان كونديرا التشيكي، وبول أوستر الأميركي. وهما المرشحان الدائمان لجائزة نوبل في الآداب. فكونديرا حينما كان في تشكوسلوفاكيا أصدر أربع مجاميع شعرية، بينها نصوص تجريبة، وأعد من المجددين في الشعر، قبل أن يتحول إلى الرواية لاسيما بعد هجرته إلى فرنسا. وكذا بول أوستر، الذي يُعد من أفضل المترجمين للشعر الفرنسي إلى الإنكليزية، بل ونال جائزة البوليتزر على مجامعية الشعرية، قبل أن ينطلق ويعرف كروائي. وفي الأدب الروسي مثلا، يُعد بوشكين الهرم الأكبر في الشعر الروسي، لكنه أيضا من المؤسسين الأوائل للرواية الروسية من خلال رواياته القصيرة: إبنة الآمر، ملكة البستوني، دوبروفيسكي. وكذا الأمر مع السينمائي الإيطالي بازوليني، الذي لديه مجموعات شعرية عديدة، وكان يكتب الرواية أيضا ولديه مجموعة روايات أشهرها (أكتونا) التي أخرجها بنفسه كفيلم سينمائي. وكذا الأمر مع لورنس صاحب سلسلة الرواية الشهيرة: عشيق الليدي شاترللي، وغيرها، فقد كان شاعرا، وقد صدرت قصائدة في مجلد ضخم. وهكذا كان أميل زولا الفرنسي، وفونتانه الألماني صاحب رواية (إيفا بريست)، ويمكنني أن أضرب المثل برابندرانات تاغور ، بأنه كتب أجمل الروايات. ولو عرجنا على الرواية اليابانية لوجدنا إن معظم كتابها كانوا شعراء أيضا. وعربيا وعراقيا، باستطاعتي الإتيان بعشرات الأسماء الروائية أو الشعرية، على سبيل المثال لا الحصر: عبدالخالق الركابي، أحمد سعداوي، حميد قاسم، وعربيا، عباس بيضون، وأمير تاج السر. وغيرهم.
أما الحديث عن الأزمنة، فهذا ليس دقيقا. إذ إن انتشار الرواية أكثر من الشعر والفنون الكتابية الأخرى صحيح جدا. انتشار الرواية صار ظاهرة عالمية، ويمكن، على المستوى العربي، إلقاء نظرة بسيطة على وثائق جائزة كتارا القطرية، لفئات الروايات المنشورة ولغير المنشورة، فسنجد مئات الروايات المنشورة، وأضعاف ذلك من الروايات غير المنشورة، بينما لا نجد ذلك في الشعر مثلا. لكن هذا لا يعني أن هذا هو زمن الرواية وليس الشعر. ربما الرواية فعلا أكثر انتشارا من الشعر، لكن هذا لا يعني غياب الشعر أو تراجعه، وإلا لو نظرنا لمسألة الانتشار فقط، ونظرنا مثلا لانتشار الشعر الشعبي في مجتمعنا لقلنا إنه زمن الشعر الشعبي.
طالما إنك مارست الاثنين الشعر والرواية ، هل ترى أن الرواية قد أزاحت الشعر من عرشه، وتسيدت في العقود الثلاث الأخيرة في العراق، أم أنك لك رأي آخر؟
- هذا السؤال مرتبط بما سبقه. وأقرّ بأن الرواية صارت الأكثر انتشارا في عالم المطبوعات. لكن يبقى للشعر جلاله وهيبته، علما إن وسائل التواصل الاجتماعي، وسهولة النشر، أساءت للشعر وللرواية أيضا.
أنا أتحفظ على مسألة إزاحة الرواية للشعر عن عرشه. لكني من خلال حواراتي مع الناشرين العراقيين والعرب، اعرف جملتهم المعروفة (الشعر لا يباع، وليس هناك من يشتري كتب الشعر)، فمثلا يطلبون من الشاعر تكاليف الطباعة، بينما أحيانا يدفعون له من أجل نشر روايته أو يعطونه نسبة بسيطة من المبعيات. فما زال لدينا شعراء نقرأ لهم بمحبة: كالسياب، وسعدي، وسركون بولص، وعلي جعفر العلاق ومن المعاصرين، نقرا لنصيف جاسم، وحميد حسن جعفر، ولحمبد قاسم، وعبدالعظيم فنجان، و.و.
السينما والرواية
وصفت روايتك الأولى الجحيم المقدس، ب(الرواية المسينمة).. ما لذي كنت تريده من ذلك.؟
- صحيح. كنت قد كتبت (الجحيم المقدس) ، وهي أول محاولة لي في السرد الروائي، بعد تخرجي من معهد السينما العالي لعموم الاتحاد السوفيتي (فكيك). في تلك التجربة السردية الأولى استخدمتُ كل ما أعرفه عن جماليات اللغة السينمائية، من بناء للمكان والزمان والتقطيع المونتاجي المتوازي وبناء الشخصية وايجاز الجملة وغياب الأفعال الماضية، والصفات التصويرية لانعكاس الأفعال على الشخصية ، وجها وجسدًا. والانتقالات، أي كتبتُ سردا أقرب للسيناريو الأدبي. بيد إن صديقي، الناقد القدير الدكتور سلمان كاصد، حين قرأ النص قال لي هي رواية وتتضمن كل شروط الرواية الأدبية، لكن بطريقة سرد مختلفة.
والحقيقة أنا متخصص أكاديمي في السينما، وكتبت ذات مرة مقالا عن (السيناريو .باعتباره شكلا أدبيا جديدا) بينت فيه إن السيناريو الأدبي اليوم يُعد شكلا أدبيا جديدا. ووضحتُ بأن الكثير مما يطلق عليه وينشر باسم الرواية هو لا يتعدى كونه سيناريوهات أدبية، وضربت أمثلة ببعض نصوص نجيب محفوظ، وإحسان عبدالقدوس، ومجيد طوبيا، وإسماعيل فهد اسماعيل وغيرهم. وليس في هذا إساءة ، فقد عمل فولكنر و ماركيز، وشولوخوف ككتاب سيناريو في فترة من فترات حياتهم، بل إن ماركيز يعترف بأن كل هذه الدقة والانضباط في رواياته هو نتجة خبرته في كتابة السيناريو.
يرى جواد بشارة « لغة الصورة المستمدة من عالم السينما مارست تأثيرا كبيراً على مخيلته الابداعية والأسلوبية» هل أنت مع هذا الاختصار فيه عسف ما بأسلوبك الروائي أم ترى انه ينطبق على رواية او روايتين فقط؟
- هذا صحيح جدا، فالصديق جواد بشارة سينمائي، وكثيرا ما تناقشنا حول تأثير السينما على أسلوبي الأدبي. أنا فعلا أكتب بلغة صورية، وكثيرا ما سمعت من القراء وحتى النقاد بأنهم يرون ما أكتب أكثر مما يشعرون أنهم يقرأون.
بل إنني، حتى حينما أتناقش مع الأشخاص الواقعيين الذين أستمد منهم النمادج الروائية، أطلب منهم إرسال صورهم، وصور غرفهم، وأسرّتهم، وخزانات ملابسهم، وأحذيتهم، وحقائبهم إذا كن نساء، ومكتباتهم، ومطابخهم، ولقطات مختلفة لهم، من أجل أن أراهم يتحركون لحظة الكتابة، لذا في رواياتي نرى الشخصيات بكامل حضورها، لكن بالتأكيد هيمنة الصورة تنطبق أكثر شيء على روايتي الأولى « الجحيم المقدس»، لأنني في بقية الروايات طعّمت السرد الروائي بنصوص شعرية ومناقشات فكرية وفلسفية، بيد إن الهاجس السينمائي وجماليات اللغة السينمائية ترافقني في كل ما أكتب، وهذا ما خلصني من الحشو والشطح الأدبي والاستطراد الذي يبعدك عن الحبكة وحركة الحدث الروائي الأساسي.
علاقتك بالسينما دراسة وتخصصا وتأليفا ، ما أثرها فيما كتبت من شعر أو نثر؟
- علاقتي وعشقي للسينما يبدأ من الطفولة، بل علاقتي بها رافقتني حتى في فترة التوتر السياسي في نهاية السبعينات، حيث كنت ألجأ لدور السينما تخفيا عن أعين المخبرين. وحين غادرت العراق مشيا على الأقدام إلى سورية ومنها إلى بيروت، ومن هناك إلى موسكو، وجدت بأنني مقبول في قسم الصحافة، لكني غيرّت اختصاصي إلى السينما.
للسينما تاثير هائل على مخيلتي وذاكرتي، لاسيما وإن الذاكرة البشرية صورية. فحين نذكر كلمة (تفاحة) مثلا لا تأتي حروف كلمة التفاحة في الذهن وأنما شكلها. أو حين نذكر كلمة (الغابة) أو (البحر) لا تأتي الكلمات بحروفها وأنما صورة (الغابة) و(البحر) مثلا.
الذاكرة البشرية ممتلئة بملايين الصور، فكيف وأنت ترى سيلا من الصور والأحداث والمواقف من خلال فيلمين أو ثلاثة تشاهدها يوميا وعلى مدى سنوات الدراسة بمعهد السينما؟ وما زلت متمسكا بلغتي السينمائية وسردي الروائي الصوري.
المتاهات ودانتي
نعود الى ملحمة المتاهات ( متاهة ادم ومتاهة حواء متاهة قابيل متاهة الأشباح متاهة ابليس متاهة الأرواح المنسية متاهة العميان متاهة الأنبياء متاهة العدم العظيم) كرواية وهي الأطول في عالم الرواية العربية؟ هل تحدثنا وبإسهاب عن تجربة كتابتها وما الذي تبحثه؟
- الحديث عن (المتاهات) يعني أن أتحدث عما شغلني فكريا وروحيا طوال حياتي . فلقد كنت مكتظا بأسئلة وجودية ودينية ونفسية منذ مراهقتي، وربما كانت أسئلة جنينية في مراهقتي، لكن بمرور الوقت والتعمق في القراءة والانهماك في التنوير الاجتماعي من خلال العمل السياسي والطلابي، ومن ثم الدراسة الأكاديمية والسفر، تعمقت هذه الأسئلة وتبلورت.
توجهتُ في بداية حياتي إلى الشعر فجربته بكل أشكاله الخارجية من العمود، التفعيلة، إلى التحرر منهما. ثم امتزج هذا العالم الشعري بالسينما وببقية الفنون كالمسرح والموسيقا والتشكيل التي أعرفها جيدا جدا.
حين كتبت روايتي السينمية الأولى (الجحيم المقدس) كان ذلك في ألمانيا العام 1987، ونلت عليها منحة هاينريش بول للكتّاب الأجانب في المنفى. ولمدة ستة اشهر كتبت فيها الرواية. بعد ذلك عدت لعالمي الشعري وللكتابة النقدية.
حين عدت إلى العراق، وعملت مديرا لإحدى القنوات الفضائية ما بين 2005-2009 لاسيما في سنوات الحرب الأهلية الطائفية بعد تفجير المرقدين في سامراء، كنت أتابع بحكم عملي ما يجري. وهالني ما كنت أرى وأسمع.
ولم يعد التعبير عن كل هذا الهول شعريا ممكنا، فالقصص المرعبة لا تحصى، وتحتاج للسرد والتوثيق التاريخي وليس للإيجاز وكثافة اللغة الشعرية.
وبشكل لا شعوري، وبمكر العقل الباطن، جاءت ذكرى تجربة غريبة عشتها قبل ربع قرن من كتابة (مشرحة بغداد)، عندما زرت مشرحة الطب العدلي بموسكو. ورأيت بعينيّ كيف تم تشريح تسع جثث من بين ثلاث عشرة جثة كانت موجودة ذلك اليوم الذي كنتُ فيه هناك.
تلك التجربة التي هزت حياتي بالكامل. فأخذت من حينها أفكر بعبثية الوجود البشري ونهاية الجسد المؤلمة؟ ومعنى الموت؟ ولا قيمة الجسد، لأني حينها كنت أسمع عويل وبكاء أهل الميتين الذين يتم تقطيعهم كما اللحم في القصبخانة.
لا أعرف كيف حضرت مشاهد ذلك اليوم من أعماق اللاوعي إلى منطقة الوعي، وتلبسّتْ وتداخلتْ مع قرص مدمج (فيديو) عثر عليه في بيت ابن نائب معروف في مجلس النواب العراقي، حيث كان ابنه الإرهابي الطائفي يختطف الناس ويذبحهم في بانيو المنزل ويصورهم بعد إجراء محاكمة صورية، مبنية على الخديعة واستغفال المقابل، من قبل ثلاثة أشخاص، ثم يتم ذبح الشاب المتهم بسكين المطبخ في بانيو البيت- القصر. لذا فكرت بكتابة روايتي «مشرحة بغداد».
في تلك الفترة كانت تعصف بي أفكاري الوجودية والفلسفية حول معنى الإرادة والاختيار من جهة ومعن التسيير والقدر المكتوب من جهة أخرى، وهي أفكار رافقتني منذ مراهقتي، فبحث في الفلسفة الإغريقية والأديان وأصل كلمة الحرية ومفهومها، وكل الأسئلة المتعلقة بجوهرها.
وكنت أدون بشكل منهجي النصوص التي أقرأ وأعلق عليها، فتشكلت لديّ ملازم كثيرة رتبتها في ما بعد وشكّلت كتابي (وهم الحرية)، حينها بدأت كتابة روايتين في الوقت نفسه وهما: (مشرحة بغداد) و (متاهة آدم).