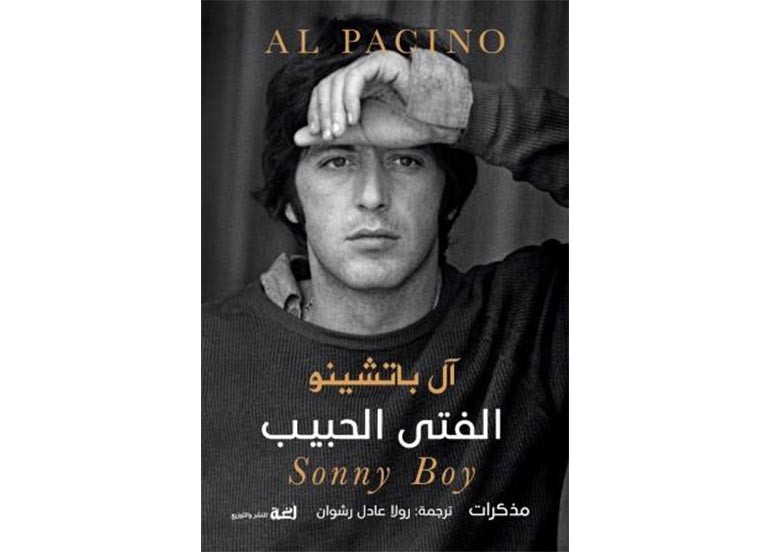لطفية الدليمي
الثالث والعشرون من نيسان (أبريل) في كل عام هو يوم الكتاب العالمي (والملكية الفكرية التي نعرف لها إسماً ولانعرف لها طعماً!!) .
هذا ماأرادته اليونسكو، وهي بعملها هذا جاءت بفعلٍ محمود يجبُ أن يتذكّره الناس ويقرنوا التذكرة بتوقير الكتاب وفِعْلِ القراءة المقترنة به.
ثلاثة هواجس جالت ببالي هذا العام في يوم الكتاب العالمي. سأحكي لكم عن هذه الهواجس باختصار يقعُ في حدود استطاعتي من غير تبخيس الفكرة المقصودة بالهاجس.
الهاجس الاوّل:
نقرأ مانرغبه ونكتب مانستطيعه
لاأظنُّ أنّ الكاتب الراحل بورخس جانب الصواب عندما أشار إلى قناعته بأنّنا " نقرأ مانرغبه ونكتب مانستطيعه ". الترحّل بين حدود الرغبة والاستطاعة يبدو لي حقيقة نعيشها وبخاصة لمن اتخذ – ولن أقول إمتهن - شكلاً من أشكال الكتابة طرازاً حياتياً له أو مَعْلَماً من معالمها الأساسية.
كلّ كاتب هو قارئ بالضرورة. لايهمُّ إن كان (بلدوزراً) للقراءة أو قارئاً عادياً. هو يقرأ مايرغب فيه وحسب. مامِن كاتب حقيقي لم يتفنن في ضروب القراءة؛ لكن ليس كلّ قارئ كاتباً ولاينبغي أن يكون الأمر هكذا. أسباب كثيرة تقف وراء هذه الحقيقة.
الكتابة أعسرُ من القراءة بالتأكيد. القراءة فعلٌ منقاد بقرار شخصي دافعه الاساس هو الرغبة في قراءة هذا الكتاب أو ذاك. ثمة ملايين الكتب المتاحة للقراءة في يومنا هذا وبخاصة في عصر القراءة الالكترونية الذي جعل من التحسّر على قراءة كتاب ما ذكرى مطوية في غياهب النسيان. نحنُ نختارُ الكتاب الذي نريد قراءته بحسب إعداداتنا المسبقة: من يشأ قراءة الروايات والاكتفاء بها فله ذلك، ومن يشأ قراءة كتب التقنية أو الفلسفة أو الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع فله ذلك أيضاً. أنت في النهاية تختارُ الكتب التي تسعدك لأنها تتوافق مع إعداداتك المسبقة، ولاأظنُّ أنّ أمراً ما في هذا العالم يمكن أن يُرغِمَ أحدنا على قراءة مالايرغبه إلا في حدود ضيقة للغاية يمكن تجاوزها فيما بعد. في القراءة أنت الفاعل الاكبر. أنت من تحدّدُ الكتب التي تختارها اختياراً يتوافق مع ذائقتك ويحقق انتشاءك العقلي والنفسي. لاكتابَ عصيٌّ على القراءة أمامك متى ماامتلكت الاعدادات اللازمة لقراءته.
الحالُ مع الكتابة مختلفٌ تماماً. مناسيبُ الحرية المتاحة لك مع القراءة تتناقصُ وتضيق لسبب جوهري: أنت عندما تكتبُ تتطلعُ لمثابة عالية تسعى لبلوغها وماأنت بالغها مهما فعلت. تبدو هذه الحقيقة مثل إحدى القوانين الغريبة في نظرية الكم. لاأظنُّ أنّ كاتباً إنتهى من تأليف كتاب ثمّ جلس يترنّمُ بما صنع عادّاً إياه تحفته الكاملة النهائية. كلّ انتهاء من صناعة كتاب إنما هو إيذانٌ بولادة فكرة كتاب جديد بما يشبه التركيب الهيغلي الديناميكي الذي ينتِجُ أشياء جديدة متفوقة نوعياً على تلك القديمة؛ لكن يتعسّرُ صنع الجديد من غير معونة القديم. قد تعيدُ الصياغة هنا وهناك في كتاب تعملُ عليه، وتضيفُ مواد وتحذف أخرى، تقتنعُ بقائمة محتويات ثمّ تعيدُ ترتيبها لأسباب مستجدة، تنقحُ وتصقلُ وتشذّبُ ثمّ تقتنعُ في نهاية الأمر أنّ فعل التنقيح والتشذيب والاضافة بات عسيراً على الكتاب الذي بين يديك ولابد من التفكير بكتاب جديد.
في القراءة ومن خلالها يمكنُ أن نُسعد بمعاينة (القمم) الفكرية التي بلغها بعضُ بني البشر. سنتوقفُ كثيراً عند قراءة عبارة أو حتى مفردة. سنعيدُ قراءة بعض الفصول مرات ومرات، وقد نضيفُ الكتاب إلى قائمة الكتب التي ساهمت في تشكيل عقولنا وأرواحنا ثمّ نعيدُ قراءتها بين حين وآخر مثلما نفعلُ مع المسرحيات الشكسبيرية أو بعض أعاظم مؤلفات عصر النهضة أو كتابات أكابر ناثرينا العرب. القراءة في النهاية سعيٌ وراء الكمال الذي نلمحه في الآخرين وليس فينا. أما الكتابة فهي مطاردة لمثال بعيد (ترانسندنتالي) نراه غير واضح الملامح، وليس في مستطاعنا سوى محاولة الاقتراب منه؛ ولكن توجد حدود للإقتراب لانستطيعُ القفز عليها أو إلغاءها.
نحنُ في العادة نُقبِلُ على القراءة منشرحي الصدور ومنتشين بلذة التوقّع القادمة؛ أما كلّ من شرع في الكتابة فيعرفُ حجم التشوّش الفكري الذي يعانيه: كيف يبدأ؟ لحظة البداية هذه مخيفة وعسيرة؛ لأنها ستحدّدُ كلّ المآلات اللاحقة.
التأرجحُ بين عالمَي الرغبة والاستطاعة، بين ماترغبُ في قراءته وماتستطيع كتابته، هو أحد الحقائق اليومية في حياة كلّ كاتب حقيقي. حَسْبُهُ أن يتلذذ بما يرغبُ في قراءته، وأن تظلّ أنظاره متطلّعة لتلك القمم العالية التي يراها شاحبة غير واضحة المعالم من بعيد، وليس له من خيار سوى الصعود إليها في رحلة سيزيفية لانهائية.
بورخس كاتب حقيقي إشتغل دوماً في قلب الاتون الكتابي المشتعل؛ ولأنه كذلك فقد نقلت عبارته حقيقة جوهرية في هذا العالم.
الهاجس الثاني:
الابداع متعدد الاشكال خارج النطاقات المعرفية الضيّقة
يعجبني كثيراً النوعُ البشري الذي قوامُهُ أفرادٌ يحرّكُهُم شغفٌ لاحدود لمدياته، ورغبة معرفية في اجتياز الآفاق البعيدة وعبور البرازخ الفاصلة بين العلوم والمعارف سعياً لإيجاد روابط، واضحة أو خفية، بينها؛ لكن يبقى العنصر الأهم الذي يتقدّمُ على كلّ العناصر هو هذا الانكباب المطلق على العمل برغم كلّ مشاغل الحياة ومتطلبات العيش. لايجب أن ننسى أننا نعيشُ حياة عراقية كلُّ مافيها يدعو إلى السأم وانقباض الروح وخذلان الإرادة والخنوع الساكن في الملاذات الآمنة التي لاكتاب فيها ولاقراءة ولاانشغالَ بالٍ بأي مسعى معرفي. أحدّثُ نفسي والآخرين دوماً أنّ الواحد منّا، أينما كان تموضعه الجغرافي وكيفما كانت ترسيماته النفسية والذهنية والروحية، لو أراد سبباً للتخاذل عن السعي المقصود والهادف في هذه الحياة لما كان صعباً عليه إيجاد بدل السبب الواحد ألفاً!!
ثمّة سؤالٌ لم يزل يلحُّ عليّ منذ أزمان بعيدة، وقد وجدت له شواهد في تأريخ صُنّاع الفكر والثقافة والأعمال الإبداعية الخلاقة. هذا السؤال هو: لماذا نجدُ أغلب صانعي الإبداع بين طائفة من الناس الذين لم يدرسوا ذلك الحقل الابداعي دراسة منهجية أكاديمية؟ أنظروا حقل الترجمة مثلاً: كم مِنْ مترجمينا البارعين، في العالمين العراقي والعربي وحتى العالمي، هم ممّن درسوا الترجمة في أقسام جامعية أكاديمية؟ قليلون للغاية. لماذا؟؟
أرى أنّ الجواب يكمنُ في عبارة (البراءة الأولى) أو (البراءة الراديكالية) بحسب مفردات المُنظّر الأدبي الراحل إيهاب حسن. الشغف يتقدّمُ على كلّ عنصر سواه، وعندما يعملُ المرء بدافع شغفه الخالص فإنّه يحتفظُ بشعلة البراءة المعرفية التي لم تدنّسها الاهواء ولم يلوّثها العفن وضغائن العمل الوظيفي.
قد يدرسُ المرء في قسم أكاديمي على غير هواه، وحتى لو لقيت دراسته هوى في نفسه فإنّ الأثقال الاكاديمية قد لاتعينه على الإرتقاء بفاعليته العقلية، وقد تثلمُ آفاق طموحه، وهذه موضوعة خطيرة ليست محصورة في دراساتنا الأكاديمية العراقية والعربية بل يمتدُّ تأثيرها حتى في الجامعات الغربية. أغلب الروائيين العالميين وصانعي الجمال الابداعي هم ليسوا خريجي أقسام اللغة الانكليزية أو الأدب أو الإنسانيات، تلك حقيقة يجب علينا التفكّر فيها باستفاضة.
الإبداعُ، في جانب من تعريفه الإجرائي، هو أن تضع بصمتك المميزة على أي عمل لك في أيّ ميدان كان، وأن تبقى بصمتك محتفظة ببراءة الشغف المطلق، شغف اللحظة الأولى التي لامَسَتْ فيها نار المعرفة روحك، وحينها إعتزمتَ أن تكون في رهط المبدعين، الممسوسين بالنار.
الهاجس الثالث:
التاريخ الشخصي وسطوة الاغتراب الابداعي
الناس في العادة مأخوذون بالمستقبل ومسكونون بممكناته الكثيرة. لماذا؟ لأنه قرينُ الإمكانات المضمرة التي يمكن أن تتحقق، ولأنه ينطوي على شيء من التفاؤل - لو أردنا - حتى لو كان هذا التفاؤل من باب التمرين النفسي فحسب؛ أما التاريخ فقد مضى وانقضى وصار كتلة من وقائع لها مسار واحد لانحيد عنه ولايمكن أن نجد له بديلاً ممكناً باستثناء القراءات التأويلية الشخصية له. التاريخ مقترن إقتراناً شرطياً بالواحدية والحتمية وإن كان من الممكن تأويل وقائعه لصالحنا؛ أما المستقبل فمنفتحٌ على تعددية المسارات وكثرة الممكنات واحتمالية النتائج. أظنّ أنّ هذا السبب هو ماجعل رهطاً من الكُتّاب – أمثال ويلز – يجعلون من آلة الزمن رمزاً ثورياً للمستقبل ومايحمله العلم من ممكنات في تطوير الحياة واستشراف آفاق لها غير تلك التي قُدّرَتْ على العقل غير العلمي. هل سمعتم يوماً بآلة زمنٍ تغوصُ في قعر التاريخ؟ ولماذا تفعل والتاريخ أمامنا كتابٌ مفتوح مقروءة كلّ صفحاته بدقة؟ ربما قد نفعل ذلك لو شئنا خلق عوالم موازية يمكن فيها متابعة مسارات جديدة لحياتنا غير التي حصلت فعلاً؛ لكنّ هذا الأمر يقعُ في باب التخييل السردي فحسب.
لكنْ من الممكن أن تكون مراجعة الماضي لكلّ من الفرد والمجتمع فعالية حيوية متى ماكانت لغرض مقارنة واقع الحال ووضعه في نطاق المساءلة النقدية: هل تطوّرْنا أم تراجَعْنا؟ ومامقدار هذا التطوّر أم التراجع؟ من الطبيعي إذا أردنا قياس مناسيب التطور أو التراجع أن نتخذ مفصلاً زمنياً أداة قياس مرجعية مع الماضي، وليس أفضل من الحاضر مرجعيةً للمقارنة مع الماضي. أهمُّ مافي الأمر أن تحصل المقارنة بهدوء، من غير غضب، ومن غير انفعالات لحظية يستوجبها ظرف آنيٌّ ما، وأن نحافظ على حياديتنا الصارمة. لسْنا في معرض مباراة في سوق عكاظ شعري أو برنامج استعراضي للبهرجة الكلامية Talk Show، وليس من المجدي أن يخدع المرء ذاته.
لو أردتُ الحديث عن نفسي بقصد كشف خطّ تطوّري الشخصي فسأقول: أراني اليوم، وبالمقارنة ماكنتُ عليه قبل ثلاثين سنة، كائناً مغترباً عمّا كنتُهُ. الإغترابُ هذا ليس اغتراباً استلابياً سيء المفاعيل والنواتج طبقاً للفلسفة الماركسية؛ بل أحسبه إغتراباً صحياً كشف لي فقر واقعنا الثقافي والعلمي وهشاشة مؤسساتنا الثقافية في العراق. أدركتُ اليوم كم كانت ضحلةً تلك المياهُ التي كنا نخوضُ فيها ونحسبها محيطات عميقة. كانت وسائلنا المعرفية وأدواتنا المفاهيمية بسيطة قاصرة، وأقسى مافي الأمر أن يعيش المرء هذه الهشاشة وهو يحسبُ أنه محميٌّ داخل خزانة مصفحة. كنّا نكتفي بعُدّتنا (وهي عدّة أدبية بالمعنى التقليدي للأدب)، ولم تكن المباحث المعرفية الأخرى ذات شأن لنا. كنا ننظرها من بعيد ونعافها جهلاً وتجاهلاً منّا؛ فما لنا والعلم والتقنية والاقتصاد والسياسة؟ ربما كانت لنا بعضُ المعرفة في هذه الميادين؛ لكنّ الخصيصة المميزة لهذه المعرفة هي تبعثرها وعدمُ انتظامها في سياق نسقي منتج.
عندما أرى كتاباتي وأعمالي قبل عشرين أو ثلاثين سنة أشعرُ أحياناً بالضيق وأتساءل: لماذا لم أكتب المسألة الفلانية بشكل آخر وبطريقة أخرى؟ حتى التقنيات الإبداعية والمقاربات السردية تتبدّلُ على ضوء تراكمنا المعرفي المستجد، وهذه حالة طبيعية لكلّ كائن حي يستزيد خبراتٍ مع الزمن؛ لكن هذه الإستزادة لن تأتينا بطريقة ميكانيكية، يجب أن نفتح حواسنا وعقولنا وأن نعمل على تغيير طريقة تفكيرنا، ولن يحصل هذا الأمر إلا بمثابرة ومشقة تقودها بصيرة شغوفة.
أطالعُ، وعلى نحو يومي، الكثير من المقالات الصحفية والموضوعات المختلفة في شتى الميادين وبخاصة العلمية والأدبية والفلسفية منها، ويحصلُ كثيراً أن أتحسس منذ السطور الأولى أنّ الكاتب يكتب بطريقة صرتُ أسميها طريقة " صندوقية "، وهي توصيف يرادُ منه الاشارة إلى مَنْ يكتبُ على طريقة ستينات وسبعينات القرن الماضي: تقسيم المعرفة البشرية إلى قلاع حصينة معزولة ومسوّرة بأسوار حجرية شاهقة، كلّ قلعة لاعلاقة لها بما سواها، والمدافعون عن كل قلعة مسكونون بحمى الدفاع عن أسوار قلعتهم الحصينة في مواجهة القلاع الأخرى.
نحتاجُ جميعاً من وقت لآخر إلى النظر وراءنا، إلى تاريخنا الفكري الشخصي بهدوء، لكي نعرف ملامح التطوّر المعرفي في أدائنا. يبدو أمراً عظيم الضرورة أن نتساءل دوماً: هل نكتب بذات الطريقة والمقاربة الفكرية التي كنا نفعلها من قبل؟ ألاتوجد ملامح للجدّة في كتابتنا؟ هل أنّ مانكتبه يصلحُ لأن يمدّ جسوراً مع الثقافة العالمية أم أنه جزيرة معزولة نكتفي بإعادة تدوير أفكارنا فيها؟
كلنا في حاجة لابديل لها أو عنها لأن نكون شجعاناً ونمتحن تاريخنا الفكري، وبغير هذا سنكونُ كَمَنْ يبدّدُ وقته المحدود والثمين، والأقسى من هذا هو تبديد أوقات القرّاء الذين نخاطبهم. القارئ هو – دوماً - العنصر الأكثر أهمية بين العناصر التي يحسب كلّ كاتب حسابها ويضعها في مركز اهتماماته، وهو (القارئ) مسؤولية كبرى على الاصعدة الرمزية والاعتبارية، وليس بكاتبٍ حقيقي من يتملّصُ من هذه المسؤولية أو يخفف من أعبائها أو يجعل قارئه عاجزاً مركوناً خارج نطاق الحراك الفكري الذي يقودُ العصر.