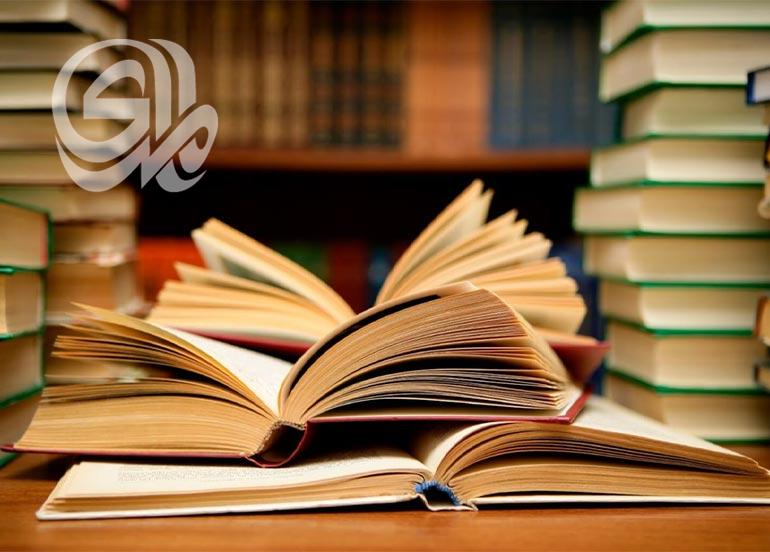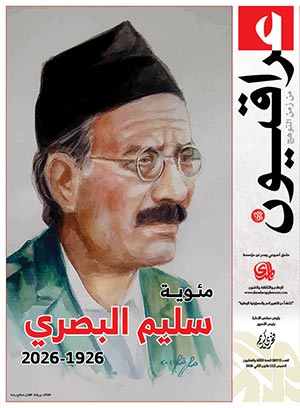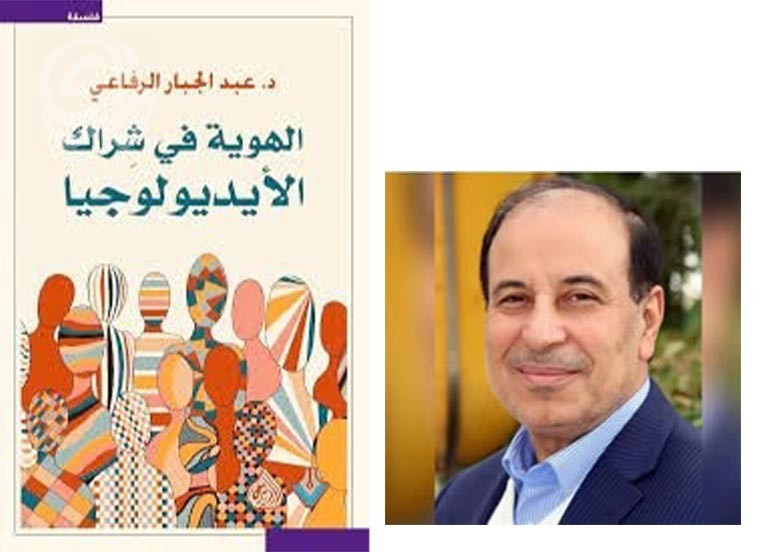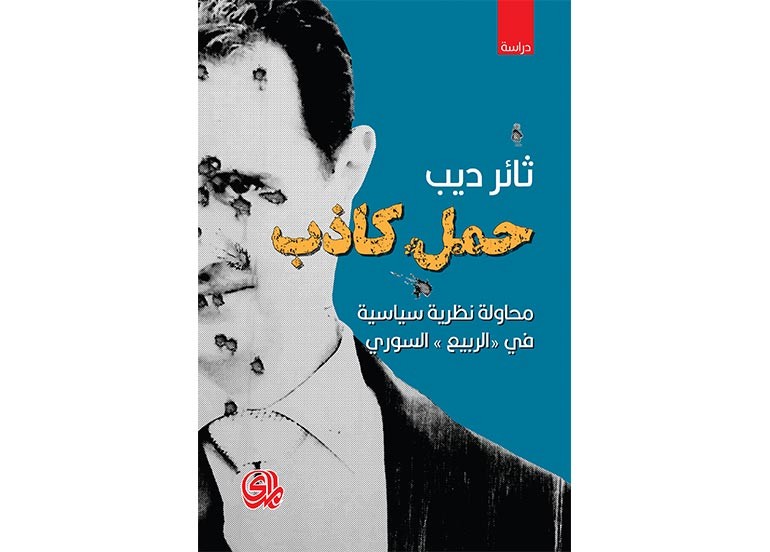د. نادية هناوي
قد لا يكون جديداً القول إن الناقد العربي بحاجة إلى التنظير إن لم نقل إنه يفتقر الى امتلاك مقومات الاجتراح ولا هو مزود بمهيئات الابتكار والإضافة.
والسبب التبعية للنقد الغربي التي قيّدت الثقافة العربية وجعلتها ثقافة استنساخ ومحاكاة وتركت نقدنا المعاصر يتكئ نظرياً على النقد الغربي. وإذ تعني التبعية الانشداد إلى منظومة فيها المركز هو الغالب والمتفوق، فذلك لأن التابع قانع بهذا الانجذاب وراضٍ بأن يكون نسخة أو صورة للمركز الذي منه يستمد الشرعية التي بها يحظى بالقبول عربياً.
وليس وراء الانجذاب والتبعية سوى الانبهار بما لدى الآخر من سمات وقدرات افتتاناً بعقليته وانبهاراً بها وانقياداً لها. وهو ما نجده في كثير من مظاهر حياتنا العربية التي يعجبنا فيها كل ما غربي فننجذب لموضاته وتقليعاته لا رغبة في الاقتداء به ارتقاء إلى مستواه فنضاهيه أو نستقل عنه في أقل تقدير؛ بل هو الانسياق مع روحية التقليد التي فيها نسعى إلى أن نكون مثله وليس أحسن منه. وهو ما يريده المركز كي يظل في صورته المتفوقة ناظراً إلى تابعيه على أنهم موالون وأقل قدرة منه وأدنى مكانة وليس بمقدورهم ـ مهما سعوا واجتهدوا ـ أن يصلوا إلى مصافه أبداً. ولا عجب بعد ذلك أن يكون النقد الأدبي مثله مثل أي ميدان حياتي آخر مشمولاً بهذا الانجذاب أيضا، وإلا كيف نفسر أن لا نظرية لنا نحن العرب في الشعر أو السرد كما لا مناهج في تحليلهما كنا قد ابتكرناها كما لا رؤية عربية خالصة تتوافق مع تجاربنا وتماشي معطيات إبداعنا وخصوصياته استطعنا أن نبتدعها لوحدنا؟ ثم لماذا انقطعنا عن إرثنا النقدي فلم نبنِ عليه أو نستلهم معطياته مجددين ومضيفين؟ وكيف يمكن لنا أن نردم تلك القطيعة المعرفية مع موروثنا الثقافي القديم معيدين تشييد صرح نقد عربي جديد؟
ليس ادعاءً القولُ إن منجزنا النقدي العربي القديم لم يكن مقصوراً على زمانه أو محبوساً في ظروف عصره. أولاً لأن عمر هذا النقد ليس بالقليل فلقد تجاوز أربعة قرون بدءاً من القرن الثالث للهجرة عصر التأليف المنهجي في النقد الأدبي، وثانيا ًأن ما طرحه نقادنا القدماء انطوى على كثير من النظر والتمحيص بعقلية اجتهادية ابتكارية منفتحة على الآخر، مستمدين في الآن نفسه تجارب الأمم الأخر في الأدب والنقد، وثالثاً أن تأثير أدبنا ونقدنا بعمريهما المديدين امتد إلى أمم أخر فأنارها بنور المعرفة بعد أن ترجمتْ منجزات حضارتنا واستوعبت ما فيها حتى إذا ذوت هذه الحضارة صارت تلك الأمم مركزاً وصرنا تابعين لها ثقافياً.
وهذه المفارقة التاريخية هي التي ينبغي أن نضعها نصب أعيننا، إذ ما دام المصير البشري خاضع لهذه المفارقة فلا ينبغي أن ننظر إلى تابعيتنا منغلقين، فلا نستوعب معنى التفاعل الحضاري الذي فيه المؤثر لا يُلغي المتأثر بدورة زمانية يتعالى أحدهم فيفرض على الآخر التبعية المعرفية متفوقاً عليه علماً ومعرفةً.
وليس في بحثنا عن ابتكار فيه تمثل خصوصيتنا النقدية أي تعنصر؛ إنما هي طبيعة الأشياء التي فيها لكل امر عام ما هو خاص به يتميز عن غيره كما أنّ للخاص أن يكون في مصاف العام لا أدنى منه وليس كفرع تابع له ليس بمقدوره الانفصال عنه. ولعل الخاص يكتشف أنه قادر على أن يضيف للعام جديداً أو ينفعه في تعميق مسألة بعينها أو توجيهها وجهة بها تتكامل الامكانيات المادية وغير المادية.
بيد أنّ كثيراً من نقادنا المعاصرين والراهنين ينشدّون إلى النقد الغربي انشداداً فيه علامات التابعية قبولاً بالانضواء في حاضنة أكبر. ولا اعتقد أنّ في هذا القول تجنياً على نقادنا لأننا لو كنا رافضين للتبعية مستوعبين الدرس العولمي، مقتنعين أنّ زمن الاستعمار قد ولى وأننا الآن نعيش في زمن الرقميات المتفوقة والذكاء الصناعي الذي صار ينافس الذكاء البشري، لعرفنا حجم التقوقع الذي نعيش فيه وعلينا أن نرفضه لنبدو بمظهر جديد مختلف شكلاً ومضموناً. والتمثيل على نزعة التبعية للمدارس النقدية الغربية ستؤكد هذه القوة الجاذبة لإمكانياتنا والمقيدة لعقولنا وأيدينا والحائلة دون أن ننجز نظريتنا العربية الخالصة في النقد الأدبي. والسؤال هنا إلى من ينبغي أن تسند مهمة انجاز هذه النظرية النقدية؛ أ إلى الباحث الأدبي أم الناقد الأدبي أم إلى الاثنين معا؟
لا غرو أنّ الفارق بين الناقد والباحث ليس بالقليل، فالأول هو بالضرورة باحث بينما الثاني ليس بالضرورة أن يكون ناقداً، فكل ناقد باحث وليس كل باحث ناقداً. وشخصية الناقد عادة ما تكون بحثية نظراً وعملاً بينما شخصية الباحث لا تتعدى البحث إلى النقد إلا إذا مكنته قدراته البحثية من أنْ يضاعفها لتصل إلى مستوى النقد تحليلاً وتشخيصاً وتأويلاً.
وإذا كانت غالبية الباحثين يظلون في حدود الإنتاج الفكري؛ فإنّ القليل من هؤلاء يمكنهم أن يتجاوزوا البحث الأدبي فيصلوا إلى مرتبة النقد الأكاديمي، متمتعين بوعي يجعلهم ذوي هويات بحث ــــــ نقدية، ممتلكين شخصية الناقد الأدبي.
ولا يستثنى من هذه القاعدة سوى الذين هم في الأصل نقاد لهم حسهم المرهف وموهبتهم الأصيلة التي تمكنهم من امتلاك شخصية الناقد ولا فرق بعد ذلك بين أن يمتلكوا نزعة البحث أو لا يمتلكونها.
ولقد أضاف هذا النوع من النقاد إلى النقد الادبي المعاصر إضافات مهمة فلم تقيدهم الأكاديمية بشروطها التعسفية ومواضعاتها البحثية الصارمة كما لم تخذلهم إمكانياتهم وأصالة مواهبهم عن بلوغ مراتب وخوض تجارب انغمسوا بسببهما طويلا في النتاجات الأدبية حتى صاروا على دراية ووعي كبيرين بأدبنا ونقدنا عارفين متاهاته ومساراته.
ويكاد يكون الغالب على دارسي الأدب العربي ونقاده أنهم باحثون يسعون إلى تحصيل شهادة جامعية عالية كالماجستير والدكتوراه ولا فرق إن كانوا اختاروا هم موضوعات دراستهم أو أن الموضوعات مختارة من لدن أساتذة متخصصين أو لجان سنمارات مشكّلة إدارياً ضمن أقسامهم التي يرغبون تحصيل الشهادة منها.
والمؤسف أن هذه الحقيقة عادة ما يتم تجاهلها، فترانا نصف من دون تدقيق باحثاً ما بأنه ناقد مع أنه لا يمتلك السمات النقدية. ولو كان كل باحث ناقداً لكانت نتاجات أدبائنا ولاسيما المعاصرين كلها موضوعة على طاولة النقد تحليلاً ودراسة، لكن الحقيقة غير ذلك.
وعلى الرغم من كثرة الأعداد المنخرطة في سلك الدراسات الجامعية والعليا في أقسام اللغة العربية وآدابها في الجامعات والمعاهد العربية؛ فإن عدد الذين يمتلكون باعاً نقدياً مبتغين تجاوز البحث إلى النقد يظل قليلاً بالقياس إلى عدد طلبة الدراسات العليا. والسبب شائكية النقد وعدم يسره أمام من يريد إثبات الجدارة النظرية والتطبيقية فيه.
وليس غريباً إذا قلنا إن للنقد أفضلية على البحث، ليس هذا انحيازاً مجانياً ولكنه توكيد للمهارة والبراعة اللتين ينبغي أن يتحلى بهما الناقد. وهو ما قد نلمسه بجلاء في أعمال بحثية ذات جهد أثير في الجمع والاستقصاء مع باع واضح في الاستقراء والتحليل قد لا نجده في أعمال بحثية تظل الإمكانيات فيها واقفة عند حدود الجمع والترجمة والاستقصاء لما كتب وقيل في الظاهرة أو القضية المبحوثة حسب.
وليس عيباً أن يكون للباحث تطلع للتنظير والتقعيد لكن ذلك ينبغي أن يكون مبنياً على إضافة أو تعديل أو رفض أو تعميق لما كان قد طُرح سابقاً أو فُكر فيه قبلاً، فيحظى على إثر ذلك كله بالاهتمام والتقدير. وهذا هو ديدن المنظِّر الأدبي الذي ليس له امتلاك سمة المنظِّر إلا بعد أن يكون قد أسس لنفسه خزينا معرفيا وهوية تحليلية تؤهله لأن يكون متفرداً في مجال البحث النظري.