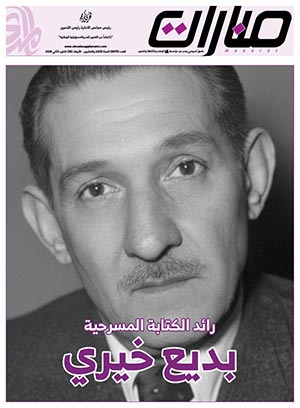عبد الكريم البليخ
لماذا نكتب؟ هل نكتب من أجل الاستعراض؟ أم من أجل أن يُقرأ ما سبق أن كتبنا حتى نسوق للآخرين وجهة نظرنا ببساطة، بعيداً عن التعقيد، وعلى أن يقف القارئ على البحث عن الكلمة الجادّة المفيدة. الكلمة التي تسكن في فكره، في وجدانه وفي ضميره.
أم أننا نكتب من أجل أن نذهب بالقارئ إلى الجحيم وقهره!، والعمل على اسقاط حواسه، وإلزامه بقراءة غير مفهومة. جمل غامضة لا معنى ولا هدف لها، حتى يقول الناس أنَّ ذاك كاتب متمرّس. كاتب بارع يختار جمله وحروفه لجهة اقحام القارئ بصور غير مفهومة، ولا تؤدي الغرض من استعراضه وعقده.
برأيي الشخصي أنّ الكتابة بقدر ما تكون واضحة، مفهومة وسلسة وفصيحة، بقدر ما يستمر العاشق للقراءة في متابعة ما يقع بين يديه وبنهم أكان مقالاً، خاطرة، دراسة، أو حتى قصة ورواية، وغير ذلك..
وإذا لجأ إلى تغيير البوصلة، وبدأ يدبّج جملاً مكان جمل، وينحت من صخر، و ما يدسّه لنا هو المفيد بقناعته، فهذا ما يعني أنَّ القارئ سينتقل إلى صورة أخرى أكثر وضوحاً. صوراً تلفت نظره، سيقف عندها ويسأل عن مضمونها، وهي بالتأكيد تحاكي ضميره ووجدانه، وتلامس أوجاعه ومعاناته!.
يكتب الكاتب ليُفهم الجاهل والمتعلم، وليس من أجل الاستعراض والأستذة.
إنّ اللغة العربية، بصورة خاصة، تزيد من المروءة، وهي من أغنى لغات العالم لأنها تتضمن كل أدوات التعبير في أصولها، ويعجز اللسان عن وصف محاسنها.
لنكن واضحين في رؤيتنا، وفيما نكتب وندوّن، ونقل ما هو مفيد للقارئ، بعيداً عن الاستعراض والأستذة الكاذبة.
***
مع أيام الزمن الجديد الذي يكرر نفسه، ما زال يحمل معه مزيداً من الآلام والأوجاع والعلل والهموم والمآسي، ها هو اليوم يضيف إلى ما نحن عليه بعض الجديد، وإن تركناه يمضي بعيداً عن رغباتنا وأحلامنا، وكل ما له من واقع بتنا نتلمس فيه الكثير من الصور المبهجة، أخذت تدفع بنا نحو الأمل، والعودة إلى أيام الزمن الجميل وما كان يتضمّنه من أوراق تزهو بسحر ألوانها.
الجديد الذي طالما يغيّر في ما نقول، وما نحب من أشخاص وأصدقاء قريبين إلى قلوبنا.. ها هم اليوم يذكّروننا بالماضي، الذي ترك فينا بصمة وأملاً بالمستقبل الذي نحاول أن نغتسل بمائه، ونجدد بعض ما فيه من أمنيات وأحلام، على الرغم من الزفرات الكثيرة والمعاناة التي تزداد أسىً ولوعة وقسوة، وهذه حالنا وحال الكثيرين.
فإلى من نحب ونعشق، نقول:
ستظلون تعيشون في قلوبنا.. نهبكم الحياة، وتهبونا الحب والصدق الذي نتوقف عنده، وهو الذي ما يعني لنا الكثير في زمن صار ملوناً بالخداع والكذب، ونرفض أن نكون جزءاً منه.. كما ندفع عنكم البلاء إن استطعنا.
مع وافر شوقنا واحترامنا ومحبتنا لجميع الأصدقاء والأحبة الذين يقرأون ما نكتب عنه وباستمرار، ونفرح أكثر بمشاركتهم رؤيتنا المتواضعة، وما نقدمه لهم من فصول عديدة من مسرح الحياة التي نجسدها بصدق المشاعر، وهذا ما جبلنا عليه وتعلمناه.
***
أصبح "فيسبوك"، في هذه الأيام الملجأ الوحيد للكثيرين لجهة البوح عمّا في قريحتهم، ونقل معاناتهم وتذمّرهم وشكواهم، ولكن هذه النقلة التي قد تفرحنا ونقرأها لدى عدد كبير من الأصدقاء، تكون منقولة أو مقصوصة من صفحات أخرى سواء عبر "فيسبوك" أو "تويتر" و googel، وغيرها. تلك التي تغني القارئ، وما على صاحبها سوى النسخ واللصق والنشر، ونسب جهد الآخرين باسمه، ويحاول هؤلاء المجتهدون أن يضحكوا على عباد الله وفي وضح النهار، ويتغنّون بجهودهم، وهم بالكاد- على أرض الواقع- لا يعرفون كيف "يفكّون" الخط، مما يدعوهم ذلك على التحايل والتخفّي وراء رؤية وأفكار الغير!..
علينا أن نقدم أنفسنا إذن، وأن نظهر اجتهادنا بعيداً عن التعدّي على حقوق الغير، فضلاً عن إقناع الأصدقاء على أن ما ينشرونه ويعلقون عليه، مبتهجين ومفاخرين في صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي من إنتاجهم الشخصي، فهل نفيق؟
كنا نأمل أن تكون الكثير من المشاركات التي نقرأها ونقف عندها من بنات أفكارهم، وليس بالاعتماد على نسخ وقص ما ينشر وعرضها على صفحات "فيسبوك".. وهذا ما نلمسه، وللأسف، من خلال صفحات الكثير من الأصدقاء!
***
في أكثر من مناسبة كتبنا عن الصداقات المزيفة، المبطنة بالخداع والكذب، والتي تنتهي أكثر ما تنتهي مع انتهاء المصلحة!
هكذا هي طبيعة كثير من الأشخاص الذين يحاولون الإساءة إلى الصداقة بمفهومها العام.
الصداقة، كما عرفنا - ونحن صغار - وما زال يعرفها معنا الأصدقاء والزملاء، ويدفعون باتجاهها الغالي والنفيس لجهة استمرارها وتألقها ونجاحها، هناك بعض النفوس الضعيفة تسعى جاهدة للإساءة إليها وبأي صورة كانت، وأمثال هؤلاء لا يهمهم أي مبدأ أو عرف كان. فالصداقة بالنسبة لهم صارت أكثر ما ترتبط بالمصلحة، فلولا المصلحة لما وجدت الصداقة، ويسعون للحفاظ على هذا المبدأ غير الأخلاقي.. الذي يختلف حوله كثيرون.
أضحت الصداقة في أيامنا هذه تفتقر، وللأسف، إلى كثير من المبادئ والأسس التي يعرفها ويسعى إلى تطبيقها كثيرون، ولكن دون فائدة.
فالصداقة صارت تحمل الكثير من العناوين الفارغة، فضلاً عما تتضمنه من مفردات الحقد والكذب والنفاق والتملق، ولم تعد تلك التي يشرفنا أن نتمسك أو نتعلق ونفاخر بها. أصبحت على الرفّ، ولم يعد أحد يأخذ ويهتم بها بالمطلق، ويراعون آفاقها الواسعة، ويأنسون لها. العلاقات الإنسانية بمجملها لم تعد تثير أحداً… أو يلتفت إليها، حتى وإن كان قريباً من الحلقة الأولى.. المصلحة تأت قبل هذا وذاك.. فهي فوق كل اعتبار، وأهمها المصلحة المادية، ففي حال أغدقت العطاء على أي شخص ما، فإنه يسارع إلى خدمتك، ومد يد العون لك، وفرش الطريق الموحل بالورود والرياحين، وفي حال بررت له عدم قدرتك على الدفع تبرأ منك، وسارع إلى إغلاق أي منفذ تجاهك، ولا يكفه ذلك، بل يبادر إلى الاساءة لك بقذفك بالشتم والمسبّات.. وهلمجرا!
الأهداف الرئيسة للصداقة صارت غاية لأجل تحقيق هدف، ليس إلا.. وهذا منه كثير.
نحن لا نحاول أن نخلق فجوة بين الأصدقاء، يظل بالتأكيد هناك أصدقاء أوفياء مهذبون.. محترمون يتصفون بأخلاق حميدة، وتطلعاتهم صادقة، ورؤيتهم دائماً تصبّ في صالح أصدقائهم باحثين عن الكلمة الطيبة، وأمل العيش حياة ملؤها المحبة والفرح، وهذا ما عرفناه ولمسناه من قبل أصدقاء كنا تعرفنا عليهم، وعاشرناهم، وبادلناهم الحب بالحب، وبكل صدق وتفان، فكانوا مثالاً متفرداً في النبل والوفاء والإخلاص والشرف.. وهذا ما نرجو أن يسير على هداه من عرفنا..
***
شباب عاطلون عن العمل، يحلمون بالفرج من أوضاع يعيشونها. يحلمون بتحقيق الذات، ويرون أنَّ في الهجرة والسفر يُحقّق مبتغاهم، وخاصةً بعد أن طال بهم الانتظار للحصول على عمل.
شباب ذوو شهادات عليا، وآخرون انقطعوا عن الدراسة منذ سنوات ولم يجدوا في سوق العمل فرصةً للحصول على المصروف اليومي، إن صح التعبير، ويزداد سخطهم تأججاً عندما يطلعون على عالم أوروبا الفردوسي عبر أجهزة الإعلام المختلفة، السمعية والبصرية، وبمجرد عودة أصدقائهم وباقي الشباب من الدول الغربية.
سيارات فارهة، أرصدة في البنوك، ورفاهية تُذكي انتظارهم وحرمانهم، كل هذه الأسباب جعلت الشباب يرى في الهجرة السرية العصا السحرية للانتقال من البؤس إلى النعيم.
هذه الظاهرة أخذت تحمل في طياتها معاناة الشباب، وأحلامهم الضائعة، أحلام نشأت منذ الطفولة، وترعرعت بفضل الإخلاص والحب الدفينين، وبين سراب وجده الشباب بعد التخرج، وانتهاء طور الدراسة والتكوين.. إلا أنَّ السؤال الذي يطرح نفسه، بإلحاح حول هذه الظاهرة، ما تعريف الشباب للهجرة؟
إنَّ الاستثمار في التنمية البشرية، من أكثر عمليات الاستثمار ربحية، والتنبّه للحلول المرتجلة، والاعتماد على القدرات الوطنية، وتفعيل القطاعات المختلفة، وإمكانية نموها على غرار ما هو قائم في كثير من البلدان المتقدمة، فحينما يُهاجر الشخص يحلم أولاً أن يكسب المال الكثير، ويغير مستوى ونمط عيشه، ويحقق مستقبلاً أفضل، ويحقّق أحلاماً متعدّدة، منها سيارة فخمة، ومنزل كبير، وثراء وغنى.
لا مانع من هذه الأحلام، إذ لا بد ألا نغفل عن هؤلاء الشباب. ألّا نهملهم لأن ذلك سيخلق حالة من الاضطراب بين الدولة والمواطن، وتتشوه مضامين الانتماء، وتختل العلاقة بين الحقوق والواجبات، وتتنامى القيم السلبية في مجتمعنا، وهذا ما يتربص بنا.