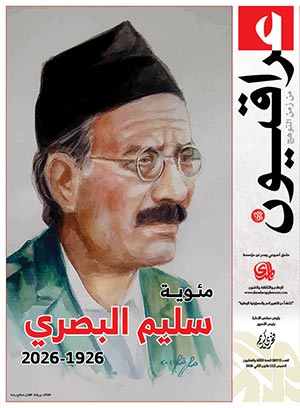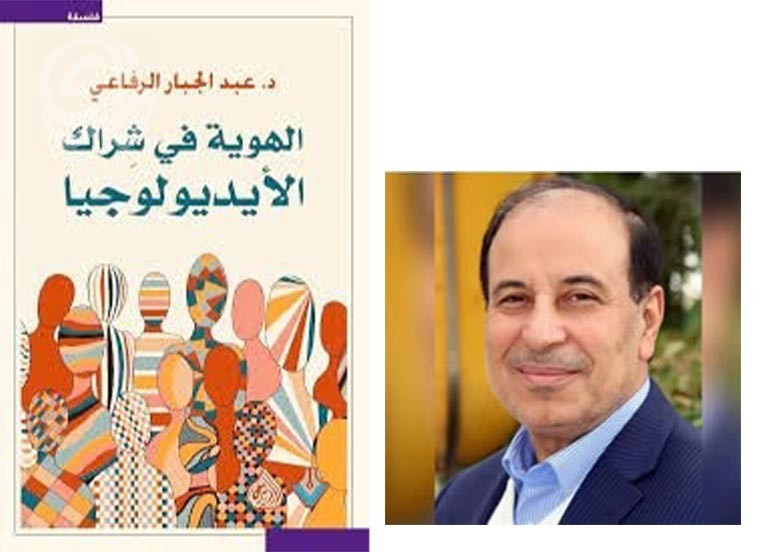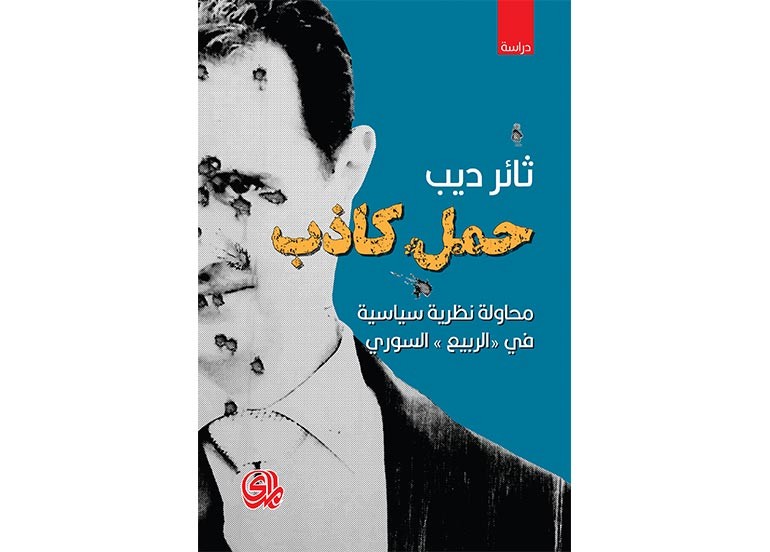يرى أنه يفهم الترجمة على أنَّها حوار بنّاء مع الآخر واقتراب إنساني وثقافي خلاق
علاء المفرجي
الجزء الاول
يعد الشاعر غريب إسكندر أحد أهم الأسماء الشعرية في جيل التسعينيات، فمنذ مجموعته الشعرية الأولى التي صدرت بداية الألفية الثالثة بعنوان (سواد باسق)، وهو اسم مهم في الشعرية العراقية.
أكمل دراسته الأولية في بغداد، ثم تخرج من كلية الآداب في جامعة بغداد، ونال درجة الماجستير من الجامعة نفسها، وحصل أيضا على الماجستير في الترجمة من جامعة وسمنستر بلندن باطروحته عن ترجمات ( أنشودة المطر) الانكليزية. قبل ان يستقر في لندن لينال الدكتوراه من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) بجامعة لندن، ايعمل الان في مركز دراسات الشرق الاوسط في الجامعة نفسها.
له أكثر من خمسة عشر إصدارا في الشعر والترجمة، رشح أخيرا لعضوية لجنة تحكيم جائزة سارة ماكواير لترجمة الشعر العالمي للإنكليزية التي يقيمها (مركز ترجمة الشعر بلندن 2024)، وهي واحدة من أهم الجوائز في بريطانيا..
في حوارنا هذا أثرنا معه مختلف الأسئلة التي تتعلق بتجربته الشعرية، ومن ضمن هذه الأسئلة، كانت عن التجييل العقدي في الشعر حيث قال: " من هنا نفهم أن مفهوم التجييل نشأ في أحضان سياسية أكثر منها جمالية، وإن كان أفراده شعراء، لما تتطلبه السياسة من عمل جماعي وتراتبية hierarchy بينما العمل الجمالي لا سيما الشعري منه فردي بامتياز.".. وهو رأي لم يسبقه اليه أحد في هذا المجال.
حدثنا عن البدايات الأولى وعن المصادر والمراجع التي جعلتك تميل وتدرك الشعر في النشأة الأولى؟
أوّلُ علاقة لي بالشعر بدأت وأنا في سن صغير جداً ربما في التاسعة من عمري. فقد كنتُ طالباً في الرابع الابتدائي وأكتب ما أسميه شعراً على دفاتر المدرسة وأسميها (دواوين): دجلة، الفرات، بغداد، القدس وهكذا. وكنتُ حساساً جداً لما أكتب، أتذكر مرة كنت في سطح البيت وأراد أحد اخواني أن يفتح أحد دفاتري (دواويني) التي نسيتها في الأسفل وصُعقت للمشهد حيث أردت أن أرمي بنفسي من السطح كي امنعه من قراءة ما اكتب!
اللحظة الثانية كنت في الصف الثالث المتوسط فكلفنا مدرس اللغة العربية بكتابة بحث صغير "تقرير" في الأدب فاخترت الكتابة عن الشاعر الرائد بدر شاكر السياب (1926-1964) فذهبت الى المكتبة العامة وقرأت كتاباً عن حياته وقصائده وتأثرتُ كثيراً بشعره (وحتى الآن هو أحد شعرائي المفضلين عربياً وعالمياً) وقد درسته مترجَماً في الماجستير ومترجِماً في الدكتوراه. وما زلت الى الآن أتذكر هذه الأبيات الحزينة والجميلة من قصيدته "وصية من محتضر" من ديوانه "منزل الأقنان" التي تصدرت ذلك البحث الصغير.
أما اللحظة الثالثة فهي دخولي كيلة الآداب بجامعة بغداد لدراسة الأدب العربي. كانت أياماً مليئة بحب الشعر والمعرفة على الرغم من صعوباتها، أذ تعرفتُ على جمع من الأدباء فكنّا نقضي الساعات الطوال في متابعة الشعر وكتابته والنقاشات الحادة حوله كل ذلك كان يجري في الهامش إذ لا مكان لنا في بلد يعيش تحت قبضة حديدية قلَّ نظيرها في التاريخ، والحرب يومئذ كانت في أوجّها. وفي تلك المرحلة السوداء ازداد إيماني أكثر بالشعر وبات يلازمني كظلي أو أكثر من ذلك! فأنا مقيم فيه وهو شغلي الشاغل حياتياً وأكاديمياً. وكلما عَتَمت الحياة التصقت أكثر بالشعر: نبوءة وحلماً. إنّه الضوء الذي يضيء العتمة: عَتَمَة الروح والمكان والزمان. ويظل الشعر بالنسبة إليَّ شيئاً سريّاً وارتجالاً غامضاً ورحلة اكتشاف عصية على الفهم!
تلازمنا كأصدقاء فترة طويلة، وكنت من تلك الفترة وقبل خروجك من العراق، تعيش الغربة، لكنها (الغربة الصعبة) كما يسميها باسترناك، هل وجدت في غربتك الحقيقية فضاءك الإبداعي ومستقرك؟
لم أشعر في لندن بالغربة شعرتُ أكثر بالوحدة كحالي عندما كنت أعيش ببغداد! الوحدة هي منفاي والحبّ هو وطني الحقيقي. وبالطبع لم يكن الأمر سهلاً في البداية لا سيما فيما يتعلق بأجواء الكتابة وآلياتها فقد أخذ الأمر مني وقتاً وجهداً كبيرين حتّى أتلائم مع المكان الجديد الذي أصبحت لي فيه طقوس خاصة. فبعد تَطْواف في بعض البلدان العربية والأوربية قررت الذهاب الى لندن. كان الأمر بالنسبة لي محسوماً كنت أقرأ عن لندن وأعرف بعض الأمكنة والأهم من ذلك هو رغبتي الشديدة في التعرف على الثقافة العالمية عبر لغتها الكونية، الإنكليزية. ولندن مدينة ثقافية عالمية بامتياز يحتاج المرء فيها الى "أعمار" تضاف الى عمره كي يستطيع أن يحضر بعض ما يجري فيها يومياً من أماسيات ثقافية وعلمية وفنية. فمثلاً، تحتاج الى أكثر من زمنك الحقيقي حتى تستطيع متابعة ما يحدث من مؤتمرات وندوات في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) بجامعة لندن حيث درستُ ودرّستُ وأن تشاهد مثلاً البرنامج الثقافية على إحدى قنوات بي بي سي. هذا غير المتاحف والصالات الفنية والمسارح والسينمات.. . الخ. ويمكنك ان تتخيل أن الشاعر والكاتب الإنكليزي الشهير صاموئيل جونسون (1709-1784) قال "عندما يتعب الإنسان من لندن، فإنّه يتعبُ من الحياة؛ لأنه يوجد في لندن كلُّ ما تحتاجه الحياة"، كان هذا في القرن الثامن عشر فما بالك اليوم!
وفي خضم ذلك، كنتُ أبحثُ عن مفتاح ذاتي "الخاص" الذي يقدمني لهذا العالم، كانت مغامرة كبرى (كثيراً ما فشلت في خطواتها الصعبة)، كنتُ لا أريد أن أدخل من أبواب "عادية" لكن ما العمل عليَّ أن أحاول وأحاول لا يأس مع الشعر "ايماني" الذي دائماً ما كان ينتهي بي الى المتاهة! لا أقل منها "التخريب" الحياتي كما عبر ت. س. أليوت عمّا صنعه الشعر به.
ولذلك كان دائماً ثمة شيء غائب؛ شيء ما ينقصني أشعر إزاءه بحيرة وفراغ يطفئ أحياناً كلَّ هذا الكرنفال العظيم من الضوء! تُعمّق هذا الفراغَ الوحدةُ. ففي الغرب ترى الناس متجاورة في "الواقع"، لكن في "الحقيقة" يعيش كلٌّ منهم في جزيرة نائية! ليس هذا ما يشعر به الشرقيون فقط، بل كذلك الغربيون لذلك لا تخلو أحاديثهم الرسمية وغير الرسمية من الحديث عن الوحدة ومشكلاتها. ومكانياً، ما زلت أشعر بـ"الضياع" في هذه المدينة الكبيرة، وأعتقد هذا مهم بالنسبة لي كشاعر، ودائماً ما أشعر بأنني أعيش في "وطن ثالث" ليس وطني الأم، ولا وطني البديل. وفي "لغة ثالثة" ليست لغتي الأم، ولا لغتي الثانية. أن تعيش "المنفى" يعني هذا أنّك تظل تعيش في شيء "ثالث" وفي ثقافة ثالثة يوصم بها حتى احفادك. وأعرف تماماً أنّ تعيش بأكثر من لغة وأكثر من وطن وما يشكل لك ذلك من غنى وثراء، لكنّ ما يشهده العالم "المتحضر" من عنصرية وكراهية للآخر المختلف عنه تؤكد نظرتي "المتشائمة" خصوصاً بعد الإبادة الجماعية في غزة.
أعتقدُ أننا كلنا نبحثُ عن وطن بداخلنا لا خارجنا! وما زلنا، ورحلة الوطن-المنفى رحلة وجدانية عميقة لها شروطها الخاصة، فعليك الاعتناء بها وأنت تسير فيها؛ فهي بعبارة أخرى: وطنك الحقيقي!
والشعر، مثل الانسان، يستبطن كذلك في طياته منفاه الدائم، بحثه الدائم، واغترابه الوجودي؛ تعمّقه الكتابة، تثريه، تصنع منه معنى، وتمنحه اسما وهوية. ولذلك، كشاعر، كثيراً ما، تريد لهذه الرحلة الّا تنتهي، تستطيب لك المغامرة: وطنك المنشود؛ إذ تعيش في رحلة لا نهاية لها، لا هدف لك سوى الحقيقة؛ حقيقة الحب حيث الغموض من أوضح أركانها. وكلما اقتربت من حقيقة الشعر، ومن حقيقة الحبّ، ازداد شعورك بـ"التوطُّن". لكنّه "توطُّن" مفتوح، مشرع الأبواب، لا مكان يحده ولا لغة تُعلّبه حتى لو كان منطلقاً من شعرية بعينها. فكان الشعر العربي، مثلاً، في دراسته وتدريسه واللقاءات والنقاشات التي تجري حوله ويشارك بها من كلّ أطراف المعمورة، كان بلداً بديلاً جميلاً يجمع الناس على الألفة والأبداع والمحبة للإنسان والمعرفة. وبمناسبة الحديث عن "المنفى" كان آخر ما كتبت قصيدة قصيرة "منفى" وقد أهديتها الى الكاتب الكبير محمد خضير، استكمالاً لحديث بدأناه عن معنى المنفى التجريدي والتجسيدي والذي بدأته بمقولة استلهمتها من تراث التصوف العالمي "كلُّ تجَسُّد هو منفى". ويسرني أن أشاركك والقراء الأعزاء بها:
هل أنت مع التقسيم العقدي لأجيال الشعر في العراق.. . وما الأثر الذي تركه جيل التسعينيات الذي تنتمي إليه في الشعر العراقي؟
لا بالطبع! هذا عرف ثقافي لا أعرف بالضبط من سنَّه أوّلاً في العراق؟! والغريب أنَّه ظهر مع شعراء الحداثة في منتصف القرن العشرين الذين يفترض بهم أن يكونوا ضد "ثقافة الجمع"، وهذا ما اشارت له تنظيراتهم. وقبل ذلك استحوذت على الساحة الشعرية العراقية أسماء نجومية مثل محمد مهدي الجواهري وقبله الزهاوي والرصافي.. . الخ. وفي رأيي، فإنَّ الأمر يعود الى أنَّ شعراء الحداثة العراقية استوردوا مفهوم التجييل مع ما استوردوا من تقنيات شعرية من الغرب وخصوصاً إنكلترا.
وذلك عندما أحتك الشعراء العراقيين بالشعرية الإنكليزية في الأربعينيات وجدوا لمصطلح الجيل رواجاً في الأدبيات الشعرية الإنكليزية وأشهر جيل حينئذ كان جيل الثلاثينيات الذي يضم نجمه الشاعر و. ه. أودن، الذي كان يوصف بالطبيب الروحي للجيل الى درجة أنَّ الجيل سمي باسمه (جيل أودن)، إلى جانب شعراء معروفين مثل ستيفن سبندر ولوي مَكْنيس وسيسل دي لويس وكريستوفر إيشروود. ولقد كان لشعراء الحداثة العربية والعراقية معرفة بهذا الجيل، وبالطبع بما سبقوه من شعراء كباوند وأليوت وويليام كارلوس ويليامز والاس ستيفنز، الذين لم يتجييلوا بتلك الكيفية ولهذا سبب سيتبين بعد قليل. وقد ترجم السياب والبياتي بوصفهما رائدي جيل الحداثة الشعرية العربية بعضاً من قصائد جيل الثلاثينيات.
كان جيل الثلاثينيات الإنكليزي سياسياً بامتياز وينتمي الى اليسار وشارك في أحداث سياسية وثقافية وأعمال مجتمعية محلية وعالمية. وحتى أنَّ بعض شعرائه أسهم في دعم الجمهوريين ضد الجنرال فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939) كتابة وعملاً. وقد أعلنت قصيدة أودن الشهيرة "اسبانيا" بوضوح تأييدها للعمل السياسي. وكانت الظروف السياسية والأحداث الكبرى التي مرت بها أوروبا قد جعلت من هذا الجيل الذي بدأ تجديداً الى درجة أن بعضهم يعد أودن هو المؤسس الحقيقي للحداثة الشعرية الإنكليزية لا أليوت لما تضمنته قصيدته من مفاهيم واستعمالات أكثر عصرية من صاحب "الأرض الخراب". أقول إنَّ هؤلاء الشعراء وبتطلعاتهم الجمالية التي تأسست على الحركة الرمزية وجدوا أنفسهم، فجأة، مجبرين على أن يقدموا فنهم في خدمة قضايا سوسيوسياسية. وهذا الأمر حدث ويحدث مع شعريات كثيرة بالعالم تجبرها الظروف أن "تتنازل" عن مبادئها الجمالية في سبيل أهداف حياتية ملحة. وقد ذكرت قبل قليل ما حدث مع شعراء التسعينيات في العراق من تغيير أسلوبي وموضوعي في قصائدهم.
من هنا نفهم أن مفهوم التجييل نشأ في أحضان سياسية أكثر منها جمالية، وإن كان أفراده شعراء، لما تتطلبه السياسة من عمل جماعي وتراتبية hierarchy بينما العمل الجمالي لا سيما الشعري منه فردي بامتياز. وبالمناسبة فإنَّ أليوت لا يؤمن بالتجييل العقدي، فضلاً عن أنَّه ومجايليه لا ينتمون الى أي جيل وأصلاً هذا المفهوم كان غائباً في الأدبيات الشعرية قبل ثلاثينيات القرن العشرين فلم تكن اهتماماتهم السياسية ذات توجهات حزبية ضيقة بل إنسانية بالمعنى الواسع للكلمة. ومع ذلك فقد قال كلمته في التجييل وبأننا نحتاج الى عشرين عاماً كي يبنى جيل آخر ويترسخ ويكون قادراً على التجديد والابتكار. فبدلاً من تكون لنا عشرة أجيال في قرن واحد، لا اختلافات حقيقية بينها، نكتفي بخمسة فقط أكثر فاعلية وتأثيراً. وأهمية "الجيل الجديد" هي فيما يغاير ويخلق من أساليب لا عهد للأجيال السابقة بها، ويضيف روحاً أخرى للثقافة الحاضنة له. وقد يكون هذا الجيل عالمياً فيوثر في آداب العالم الأخرى كما حصل مع جيل ادون مثلاً. وتظل الإجابة قائمة وهي
كيف يمكن للشاعر أن ينخرط بأعمال سياسية فعالة من دون أن يفقد حسه الجمالي ونزاهته الأخلاقية؟
جيل التسعينيات وفي الغالب الأعم وأنت واحد منهم اهتم بقصيدة النثر، ما هي الأسس النظرية لقصيدة النثر برأيك، وهل لها ضرورات معاصرة؟ ويرى منتقدوها أن كُتّابها يجهلون أسس البلاغة العربية وجمال اللغة، بينما يرى من يتبناها بأنها ضرورة معاصرة لا بد منها؟
عندما بدأت أهتم بكتابة الشعر بشكل جاد كانت القصيدة العربية الحديثة بشكلها الجديد الذي يعرف بـ"قصيدة النثر" قد اخذت مديات وأبعاداً كبيرة منذ ستينيات القرن الماضي، على الأقل، إن لم يكن قبلها. وكما هو معروف فإنَّ الشعر العربي الحديث بشكليه: الشعر الحر وقصيدة النثر قد تأثرا بشكل حاسم بالشعر الغربي: خصوصاً الشعر الإنكليزي والشعر الفرنسي. فيما يخص المدرسة العراقية وشعرها الحر فكان تأثير الشعر الإنكليزي عليها واضحاً، لا سيما كتابات الأميركي-البريطاني ت. س. أليوت (1888-1965) الشعرية والنثرية. أما بخصوص المدرسة اللبنانية وقصيدة النثر التي بدأت تهمين على المشهد الشعري العربي برمته، فكان تأثير الشعر الفرنسي عليها بمكان لا يقبل الشك. إلا أننا يجب ألّا ننسى أن ثمة تأثيراً "لاحقاً" على قصيدة النثر من الشعر المكتوب بالإنكليزية من خلال اقتراب الشعرية العربية الحديثة من قصائد الشعر الأميركي والت ويتمان (1819-1892). لم يكتب، بالطبع، لا ويتمان ولا مترجمه، سعدي يوسف، قصيدة النثر بل الشعر الحر، إلا أنّ طريقة كتابته وأسلوبه كان أقرب الى روح "النثر" منه الى روح "النظم" الذي انتهى اليه الشعر التقليدي. فكانت الحرية والانفتاح النصي والثيمات الإنسانية الجديدة: أحلام الشاعر وحياته ويومياته من سمات تلك القصيدة الجديدة. وكما أشرت، فإنَّ التأثير الكبير على قصيدة النثر بدأ من اقتراب الشعرية العربية الحديثة في الخمسينيات من الشعر الفرنسي. وقد أسهمت ترجمات مجلة شعر التي كانت تصدر بيروت وكتابات أدونيس وترجماته بالخصوص، وبقية شعراء "المدرسة اللبنانية" بالترويج لأهميتها وميزاتها ولـ"ـضرورتها" بوصفها شكلاً كتابياً جديداً يتمتع بحرية استيعاب انماط وأنواع لا عهد للشعر العربي بها.
وبالمناسبة، فدور مجلة شعر لا يقتصر أهميته على قصيدة النثر فقط، بل يتعداه الى الشعر الحر. إذ أن مشروعها كان مهتماً بالتجديد الشعري ودور الترجمة في ذلك التجديد. فقد كان لترجمة قصيدة أليوت الشهيرة "الأرض الخراب" التي قام بها أدونيس ويوسف الخال ونشرت في أحد أعداد المجلة عام 1958 دوراً كبيراً في تغيير طرائق الكتابة الشعرية ليس على من ترجمها فقط، وانما على كل المشهد الشعري العربي الحديث. وقد كان لحضور قصيدة أليوت في المشهد الشعري العربي الخارج للتو من الحرب العالمية الثانية وما زال يعيش نكبة فلسطين، وما قدمته من تراجيديا سوداوية صورت خراب الإنسان والأرض بعد مأساة الحرب العالمية الأولى وببناء جديد يقوم على التشظي الملحمي الذي يتحرر من كل قيد وله قدرة منح القصيدة ثيمات جديدة لا عهد للشعر بها من قبل، أقول كان لحضورها سحراً وسط شعراء الحداثة العرب من الشباب حينذاك. والى درجة أنَّ أغلبهم لم يستطع الانفكاك منه حتّى يومنا الحاضر. وفي ظني أنَّ قصيدة ادونيس ما تزال "أليوتية" أكثر منها "بيرسية" برغم أهمية تقديمه الأخير الى الثقافة العربية.
ماذا اذن عن تجربة أدونيس في هذا الصدد؟
فيما يخص تجربة أدونيس الترجمية فهو أحد اهم الشعراء العرب الذين مثلوا ظاهرة الشاعر-المترجم ونظَّروا لها. إلّا أنّ تنظيراته تردد مقولات الآخرين التي أصبحت من "كليشيهات" الترجمة، من قبيل "يجب أن يكون النص المترجَم وكأنه مكتوب باللغة المترجَم اليها" وهذا هو عين فقر الترجمة. وقد ناقشته عن ذلك في محاضرته عن ترجمة الشعر التي عقدت في عام 2018 بالمكتبة البريطانية بلندن بحضور جمهور غفير من العراقيين والعرب والجانب كان من بينه الشاعر سعدي يوسف. ولو كانت ترجمات أدونيس نفسه كذلك لما أضافت كلّ هذا الثراء الى الشعر العربي. فهو في تطبيقاته مغامر كبير تأخذه التجربة الشعرية-الترجمية الى أبعد مدياتها، كما هو الحال في شعريته الخاصة، لذلك رفد الشعرية العربية بنصوص غيّرته تماماً. وعلى ذلك نقده المترجمون "الحَرْفيَّون" الذين لا تشغلهم إبداعية الترجمة وثراها، كما ينقد بعض الغربيين والصينيين ترجمات أزرا باوند للشعر الصيني القديم التي جددت الشعر الإنكليزي وأضافت له أشياء عظيمة.
كيف تفهم الترجمة أذن؟
أفهم الترجمة على أنَّها حوار بنّاء مع الآخر واقتراب إنساني وثقافي خلاق يُغني كلَّ الأطراف. وقد أشرت في كتابي الذي صدر باللغة الإنكليزية عام 2021 بلندن وعنوانه (الشعر الإنكليزي والشعر العربي الحديث: الترجمة والحداثة) وهو في الأصل أطروحة دكتوراه في الأدب المقارن قدمتها الى جامعة لندن بأنَّ كلّ حركات التجديد الشعري العالمية قديماً وحديثاً قامت على الترجمة. وكما قال آزرا باوند "إنَّ عصر الأدب العظيم هو، دائماً، عصر الترجمات العظيمة". ولذلك كل حركات التجديد الشعري قديماً وحديثاً قامت على الترجمة، فإذا ما بقيت في بحيرتك الراكدة لن تصل الى الكنوز التي تخبئها البحور والأنهار الأخرى! وكلّ شعراء العالم الكبار كانوا مترجمين ينسحب هذا على الشعريتين الغربية والعربية يكفي أن نذكر بودلير وأليوت وأزرا باوند وسان جون بيرس واوكتافيو باث وشيمس هيني وأودن وتيد هيوز والسياب وأدونيس ويوسف الخال وجبرا أبراهيم جبرا وسعدي يوسف وغيرهم. وقد بقيت ظاهرة الشاعر-المترجم حية في الشعرية العراقية الى الستينيات ثم انحسرت شيئاً فشيئاً في الأجيال الأخرى.