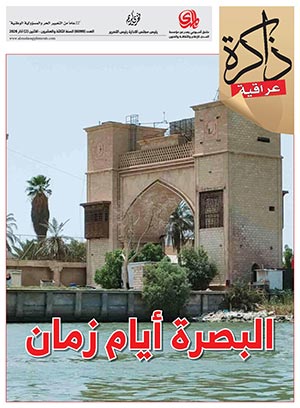احمد حسن
قبل عامين، كُلّفتُ من قِبل أستاذ مادة علم اجتماع الفكر السوسيولوجي بواحدٍ من أكثر الاختبارات الدراسية أهمية وإثارة في إطار دراسة الماجستير. كان المطلوب أن أختار شخصية بارزة من عالم الاجتماع، وأن أكتب مقالًا نقديًا حول إرثها الفكري وتأثيرها. وبحكم تأثري الكبير بنقد المدرسة الشيكاغوية، وقع اختياري على ماكس هوركهايمر، الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني، الذي أعاد صياغة فهمنا لعلم الاجتماع الحديث.
غير أن أستاذ المادة، وبنظرةٍ تحمل تحديًا لافتًا، اقترح أن ألتفت إلى تراثنا الفكري، مطالبًا إياي بالتركيز على علي الوردي، عالم الاجتماع العراقي الاستثنائي. كما طلب مني تقديم مقارنة دقيقة بينه وبين أعلام الفكر السوسيولوجي في العالم العربي، مثل المصري منصور فهمي واللبناني ملحم شعول.
كان هذا الاقتراح في البداية مربكًا بالنسبة لي. فكيف لي أن أتحوّل من شخصية عالمية بحجم هوركهايمر، بأفكاره المتجذرة في الفلسفة النقدية، إلى شخصية إقليمية مثل الوردي؟ إلا أنني سرعان ما أدركت أن هذا الاقتراح لم يكن مجرد توجيه أكاديمي، بل كان اختبارًا حقيقيًا لقدرتي على استيعاب أهمية الوردي في سياقه التاريخي والاجتماعي، وعلى إدراك كيف يمكن للأفكار أن تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية لتصبح عالمية. دفعني هذا التحدي إلى إعادة النظر في الوردي، ليس كعالم اجتماع عراقي فحسب، بل كرائد فكري يحمل مشروعًا فكريًا تجاوز الأطر المحلية ليمس القضايا الإنسانية الكبرى، بدءًا من قضايا الهوية والازدواجية الاجتماعية، وصولًا إلى جدليات التقليد والحداثة.
كان علي الوردي، بعلمه الرصين وفكره المتقد، حجر الزاوية في تأسيس السوسيولوجيا العراقية والعربية، حيث نجح في نقل مفاهيم العلوم الاجتماعية الحديثة إلى العالم العربي بطريقة أضاءت زوايا معتمة في فهم المجتمع وثقافاته المتداخلة. لم تكن إسهاماته مجرد اجتهادات عابرة؛ بل إنها تحولت إلى مرجعيات فكرية عميقة لا تزال تُدرس وتُناقش في أروقة الأكاديميا العالمية، بما في ذلك مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية (EHESS) بباريس. هناك، وبين رفوف المكتبة، صادفت إرثًا غنيًا للوردي، تجسد في أكثر من 13 أطروحة دكتوراه استلهمت نموذجه الفريد حول ازدواجية الشخصية.
لقد كانت أطروحاته حول ازدواجية الشخصية الاجتماعية بمثابة مرآة تعكس واقعًا عراقيًا معقدًا، لكن اللافت أن هذا النموذج لم يبقَ حبيس بيئته المحلية، بل وجد طريقه ليصبح أداة لفهم مجتمعات مختلفة تمتد من البرتغال إلى برشلونة، ومن قلب إفريقيا إلى مدن تشاد. كل ذلك يشهد على عبقرية الوردي في صياغة منهجيات تحليلية عابرة للثقافات، قادرة على تفكيك الظواهر الاجتماعية ضمن سياقات متنوعة.
ما يُثير الإعجاب في مسار الوردي الأكاديمي هو تدرجه بين مدارس فكرية متباينة. فقد نهل من مناهج البحث الكمي في الجامعات الأمريكية، لكنه صاغ نتاجاته بأسلوب ينسجم مع تقاليد البحث النوعي التي تميز المدرسة الفرنسية، وكأنما كان يجمع بين دقة الأرقام وثراء التحليل النوعي ليصل إلى فهم أعمق للواقع الاجتماعي. هذا المزج بين المناهج لم يكن مجرد خيار أكاديمي، بل كان انعكاسًا لمرونة فكرية نادرة وقدرة على التوفيق بين المدارس النظرية المختلفة بما يخدم قضايا المجتمع.
إن ما حققه الوردي يتجاوز حدود العراق. إنه إرث فكري عالمي يحمل في طياته دعوة للتأمل العميق في طبيعة التفاعل البشري بين الحداثة والتقليد، بين الفرد والمجتمع، وبين الثابت والمتحول. ورغم هذا كله، نجد بعض الأصوات التي تُقلل من شأنه، معتبرةً إسهاماته مجرد سرديات حكواتي. هذا التجاهل أو الانتقاص ليس إلا انعكاسًا لحالة من الإنكار لقوة الفكر الذي يستطيع أن يُزعزع الثوابت السطحية ويُعيد صياغة الأسئلة الكبرى.
ما يشغلني بعمق في هذا السياق هو الأثر العميق الذي تركه علي الوردي على النظرية الاجتماعية، لا سيما في تحليله المبتكر للبنية الأسرية العراقية. حينما قارن الوردي الأسرة العراقية بنظيرتها الفرنسية، لم يكن مجرد ناقلٍ لملاحظات سطحية، بل كان يسلط الضوء على فجوة هائلة في الاندماج الاجتماعي الذي شهده المجتمع العراقي، فجوة تشبه ما رصده ماكس فيبر في دراساته عن المجتمعات الأوروبية. الوردي، كفيبر، كان مشغولاً بالسؤال الأهم: كيف يتفاعل الأفراد مع البنى الاجتماعية التي تحيط بهم؟ وكيف تُعيد هذه البنى صياغة سلوكهم وتصوراتهم عن ذواتهم والمجتمع؟
الوردي لم يكن مجرد محلل اجتماعي، بل كان مفكراً حفر عميقاً في الطبقات السوسيولوجية للمجتمع العراقي، محاولاً فك تشابكاته وتعقيداته. كان أشبه بجسر بين مدارس فكرية متباينة، مستعيناً بمنهجياته النوعية في تحليل الأسرة العراقية والتوترات الاجتماعية التي تخترقها، ليصل إلى نتائج ذات طابع كوني. لم تكن نظرياته حول الاندماج الاجتماعي مجرد توصيفات عابرة، بل كانت محاولات لتقديم إطار شامل لفهم الديناميات التي تُنتج التفاوت والتنافر داخل المجتمعات.
ورغم ذلك، لم يسلم من الجحود والهجوم. إن ما يثير الدهشة أن هذا الهجوم لم يأتِ فقط من الأنظمة القمعية التي أرادت إسكات صوته، كالنظام البعثي الذي حاول تسطيح إسهاماته وتقزيمها، بل استمر حتى بعد سقوط ذلك النظام. ما يدعو إلى الحيرة هو أن هذا الجحود لم يقتصر على أنصار الأنظمة السابقة، بل امتد ليشمل بعض المعارضين الذين من المفترض أن يكونوا أول المدافعين عن الفكر النقدي الذي مثله الوردي.
كيف يمكن تفسير هذا العداء تجاه مفكر قدم للعالم العربي أدوات فكرية لفهم ذاته؟ هل هو رفضٌ لتحدي السائد والمألوف؟ أم أنه خوفٌ من فكرٍ قادر على تفكيك الأسس الهشة التي يقوم عليها الخطاب الاجتماعي التقليدي؟ أياً كان السبب، فإن الوردي يبقى، رغم كل محاولات النيل منه، شاهداً على قدرة الفكر على مقاومة الطمس والتهميش، وصوتاً لا يزال يتردد في أروقة البحث الأكاديمي وفي ضمائر أولئك الذين يسعون لفهم المجتمعات في أعمق أبعادها.
قد يكون هذا الهجوم الذي تعرض له علي الوردي مرتبطاً بجرأته الفكرية واستعداده لمواجهة التناقضات العميقة التي تجذّرت في البنية الاجتماعية والثقافية والدينية للمجتمع العراقي والعربي. لقد اقتحم الوردي مساحات ظلت لفترة طويلة محظورة على النقد والتحليل، مسلطاً الضوء على نقاط الصراع بين الحداثة والتقاليد، ومفككاً بنيات اجتماعية كانت تُعتبر ثابتة لا يجوز الاقتراب منها. هذا التحدي الجريء وضعه في مواجهة مباشرة مع التيارات التقليدية التي رأت في أفكاره تهديداً للنظام الاجتماعي القائم.
إن ما ميّز الوردي لم يكن فقط عمق تحليلاته، بل أيضاً شجاعته في استخدام أدوات السوسيولوجيا لكشف المستور والمسكوت عنه، وفضح التوترات التي تمزق النسيج الاجتماعي من الداخل. لقد أثار أسئلة تتعلق بالهوية والازدواجية والنزاع الثقافي، أسئلةً لم تكن مجرد تأملات نظرية، بل محاولات لفهم البنى الاجتماعية في ضوء التغيرات الكبرى التي عصفت بالمجتمعات العربية آنذاك. وفي هذا السياق، لم تكن كتاباته مجرد نصوص أكاديمية جامدة، بل كانت دعوة إلى التفكير النقدي العميق، ومحاولة لتوسيع أفق الفهم الاجتماعي.
في النهاية، يبقى علي الوردي رمزاً استثنائياً في تاريخ السوسيولوجيا العربية، ليس كمجرد منظّر أو مفسر اجتماعي، بل كصانع أسئلة جريئة ومحفّز لتغيير المنهجيات السائدة في فهم الواقع الاجتماعي. إن وصفه بـ"الحكواتي" من قبل بعض منتقديه لا يعكس سوى عجز عن استيعاب مدى تعقيد أطروحاته.