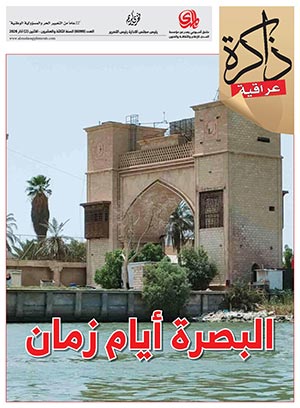أحمد حسن
خلال العقدين الأخيرين، شهدت منطقتنا الشرق الأوسط تحولات سياسية جذرية هزت أسس الدولة والمجتمع على حد سواء، وكانت العراق وسوريا في صلب هذه الزلازل العاصفة. وإذا كانت التجربتان تبدوان منفصلتين زمنيًا ومنهجيًا، إلا أنهما تتقاطعان في كونهما مشهدين مأساويين لنتائج التحولات التي لم تستند إلى رؤية مؤسسية واضحة. كلاهما نموذج لفشل الانتقال من استبداد الطغيان القومي إلى بدائل الإسلام السياسي المتشظية، ما يثير أسئلة عميقة حول طبيعة الحرية ومعنى التغيير.
طوال عقود من حكم حزب البعث بقيادة صدام حسين، كان العراق يعيش في ظلال استبداد صارخ قوامه سياسات الحزب الواحد، حيث أُخضعت الدولة بكاملها لرؤية أيديولوجية أحادية، حوّلت المجتمع إلى كتلة صامتة من الخوف والاستلاب. لم يكن القمع مجرد أداة سياسية، بل تحول إلى نظام حياة يزرع الهيمنة في نسيج المجتمع، كما يقول الباحث العراقي كامل الشياع: "لا تكتفي الأنظمة الطغيانية بتحطيم الجسد السياسي للمجتمع، بل تستهدف بنيته الأخلاقية، فتجعل من القمع ممارسة يومية تُشكّل سلوكيات الأفراد وتُعيد تشكيل الوعي الجمعي وفق منطق الخضوع".
كانت حرب الخليج الأولى والحصار الدولي في تسعينيات القرن الماضي ذروة هذا الطغيان، حيث أصبح الجوع والقهر مصيرًا مشتركًا للعراقيين. ومع ذلك، لم يكن سقوط النظام البعثي عام 2003 على يد الغزو الأمريكي لحظة تحرر بقدر ما كان بداية لفصل جديد من الأزمات. فقد استُبدلت مركزية الحزب الواحد بهيمنة الإسلام السياسي، الذي أفرز نظامًا طائفيًا عمّق الانقسامات الاجتماعية بدلًا من معالجتها.
إن صعود الأحزاب الإسلامية في العراق لم يُنتج نموذجًا ديمقراطيًا أو مشروعًا وطنيًا شاملًا، بل أدى إلى استنزاف الدولة عبر أنماط جديدة من الاستبداد المقنّع بالشرعية الطائفية. وكما يشير الباحث الفرنسي جان بوتين، فإن "المجتمعات التي تنتقل من حكم الفرد المطلق دون مشروع مؤسسي جامع، تجد نفسها في حالة دوران عبثي داخل دائرة الاستبداد، حيث لا يُقصى الطاغية إلا ليحلّ مكانه استبداد آخر بأقنعة جديدة".
على الجانب الآخر، جاءت الثورة السورية عام 2011 كتجسيد للرغبة الشعبية في كسر قيود الاستبداد الذي رسخه نظام الأسد منذ السبعينيات. كان الحراك السوري يحمل في بداياته طموحات الحرية والعدالة، إلا أن العنف المفرط الذي واجهت به السلطة الاحتجاجات السلمية، إلى جانب غياب رؤية سياسية متماسكة، سرّع من تحول الثورة إلى نزاع مسلح فوضوي.
لقد وجد كثير من السوريين أنفسهم أمام خيارات محدودة بين نظام استبدادي يقمع بوحشية، وتيارات إسلامية متطرفة سعت إلى فرض هيمنتها على الثورة. وفي هذا السياق، يبرز ما قاله المفكر برهان غليون: "لم تكن خيارات الثوار سوى انعكاس لمجتمع أُنهكت قواه عبر عقود من القمع والتهميش. في غياب المؤسسات والقيادات الواعية، تصبح الثورة صرخة احتجاج أكثر منها مشروع تغيير، وحينها تتحول الوسائل إلى غايات بحد ذاتها، حتى وإن كانت تلك الوسائل تحمل بذور استبداد جديد".
إن ظهور جماعات مثل "جبهة النصرة" و"داعش" لم يكن تعبيرًا عن توجه فكري أصيل بقدر ما كان نتاجًا لانهيار النظام المؤسسي والاجتماعي، حيث استُبدلت شعارات الثورة بأيديولوجيات تمثل استبدادًا مضادًا، يعيد إنتاج الأزمة نفسها في قوالب جديدة.
سواء في العراق أو سوريا، كان صعود الإسلام السياسي كبديل للأنظمة البعثية مؤشرًا على أزمة أعمق تتعلق بفشل النخب السياسية والمجتمعية في صياغة مشروع وطني جامع. الإسلام السياسي، سواء تمظهر في تيارات طائفية في العراق أو جماعات متشددة في سوريا، عجز عن تقديم نموذج يُحقق الاستقرار ويعكس تطلعات الشعوب.
في العراق، تكرّس نظام المحاصصة الطائفية الذي جعل الدولة رهينة لمصالح حزبية ضيقة، فيما ظل مفهوم المواطنة غائبًا عن الخطاب السياسي. وفي سوريا، تحولت الثورة إلى صراع وجودي بين نظام شمولي وجماعات متطرفة، حيث فقدت الدولة مركزيتها لصالح أمراء الحرب وقيادات الميليشيات.
إن التجربتين العراقية والسورية تبرزان أن إسقاط الأنظمة الاستبدادية ليس سوى الخطوة الأولى في مسار طويل وشاق نحو التغيير. وكما يقول ابن خلدون: "الملك إذا ذهب بالسيف، لا يعود إلا بالسيف، وما كان بالعقل والعدل، فهو الذي يستقر".
التغيير الحقيقي لا يمكن أن يتحقق بإزاحة النظم الحاكمة فحسب، بل يتطلب بناء مشروع سياسي متكامل يقوم على المؤسسات المدنية، واحترام التنوع، وتوزيع السلطة بشكل عادل. إن المأساة التي عاشتها العراق تكمن في غياب هذا المشروع، حيث تحولت طموحات الحرية إلى فوضى سياسية وأزمات وجودية أعادت إنتاج الاستبداد بطرق مختلفة.
يقول المفكر الفرنسي بيير بورديو: "الثورات التي تنطلق دون وعي بسياقاتها الاجتماعية والسياسية، تتحول إلى ردة فعل على الماضي أكثر منها بناءً للمستقبل". وهذا ما ينطبق تمامًا على حالة العراق، حيث بقيت النخب أسيرة التاريخ بدلًا من أن تصنع مستقبلًا جديدًا لشعوبها.
إن التحولات في العراق تظل شاهدًا حيًا على أن الحرية لا تتحقق بإزالة الطغيان فقط، بل ببناء أسس عقلانية للسلطة تحترم الإنسان وتحقق العدالة. فلا العراق ولا سوريا يحتاجان إلى أنظمة جديدة بوجوه قديمة، بل إلى مشروع وطني جامع يعيد للمجتمع ثقته بذاته، ويضع حدًا لدوامة الاستبداد والعنف.
حينما تُبنى الدولة على أسس الحرية والعقلانية، تصبح التعددية مصدر قوة لا انقسام، وتتحول السياسة من لعبة للهيمنة إلى وسيلة لخدمة الإنسان. أما حينما يبقى التغيير أسير اللحظة، فإن الشعوب ستظل تدور في حلقة مفرغة، تتغير فيها الوجوه، فيما يبقى الاستبداد هو القاسم المشترك.