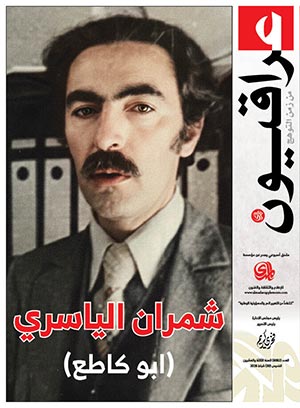طالب عبد العزيز
تنحلُّ قبضةُ المباهج عن كثيرٍ، ظلَّ يسقط منها، فتبحثُ في أقنوم أصابعك عن شيءٍ مما كان لديك ذات يوم، فلا تجد، لا الماءُ الذي يصلك بالمدِّ العذب، ولا النخل الذي كانت تنطبق عليك عرائشه، كنتَ بالأمس القريب قد وسدّتَ الثرى حفيداً، أنّبتَ منذ عام، ومن قبل، وبيديك هاتين كنت قد حملت أخيك من مركبة نقل الجثامين الجنود الى مركبة أيصالهم لبيوتهم، وبأمِّ عينيك رأيت الدودَ، وهو ينهمرُ من المحجرين المنطفئين، وقبل عودتك من مركز المدينة، حاملاً كيس الدواء، كان أبوك قد فارق ثلاثة وستين عاماً، متنقلاً من سرير أبيض، الى آخر أقلَّ بياضاً، ومثل هذه كنت وئيداً تصطحبُ أمَّكَ من بيت الخطّار الى معتزلها الذي ظلَّ يظلمُ ويظلم، حتى أنستْ رملةَ الأرض التي هناك.
تقرأ في كتاب المَخَبّل السَّعديّ " ألمْ تعلمي يا أمَّ عمْرةَ أنني – تخطَّأني ريبُ الزمان لأكبرا" فتقفُ عند مفردة(تخطّأني) يا الله، ما أبلغها من مفردة، وما أقربها الى ما أنت فيه. هؤلاء الشعراء يصلون بغيتهم في مفردات قليلة، فهم يتوسدون حسك المعاجم، ويلتحفون أسرارها، وبأقدام النبيين يطأون أرضها، فتأتيهم بالقاصي المستقرب، وبالوحشي المستأنس، وبالغريب الجميل، أيُّ ملاكٍ حارسٍ هذا الذي هداه الى الكلمة، بالغة العظمة، مستوفية المعني؟ هناك مَنْ تعمل السماءُ على الرفق بهم، لأجل كلمة قالوها، لهذا كانت سهامُ الزمان تطيشُ،عن شمائلهم، وعن جنوبهم، فتخطِئهم، تتخطَّأَهم، لكن، وبأسف نقول: ليشهدوا معنا الكبرَ وذهابَ المباهج، وأفولَ النِّعم، ليس إلا.
نجدُ في المعاجم ما لا نجدهُ في كتب الشعر والرواية والنقد من الترويةِ والتزجيات، ولعلني واحدٌ من أولئك الذين يجدون فيها ضالتهم، فتراني غاطساً مع ابن منظور في محيطه تارةً، أو آخذاً طريقي الى الزمخشري في أساس بلاغته، وكذلك أكون مع النيسابوري الانصاري ابن هشام، في قطْر نداه وبلِّ صداه، ومع هذا وذاك من الكبار، الذين أوقفونا على الحسن والجميل والاستثنائي في لغتنا، نحن الذين لا عزاء لنا خارج الكلمات!
ينشرَ الحزنُ سحائبه السود على أهل البيت بفقد أحدهم، وربما مكث(الحزن) السنةَ والسنوات، وجعل من الغرفات والمخادع مباكٍ لا أول ولا آخر لها، وقد لا يكبح جماحه أحدٌ فيضيّق عليهم في كثير من محطات معيشتهم، فنحن في شرقنا العربي لانحسن صنعةً أكثر من صنعة الحزن، نحن قوم نربّي الكمدَ في أرواحنا، نُطعمه الدمع والحسرات ليكبر، وتراثنا شاهد ودليل على ذلك. بين هذه وتلك لا يجدُ صاحبُ اللغة، المقدودُ من الكلمات عزاءَه خارج الكتب والمعاجم بخاصة، فأنا، غالباً ما أصحو وفي فمي كلمةٌ، الهجُ بها، ربما واتتني في حلم الفجر، فهي تتبعني مثل داجنٍ، أطعمته ذات يوم، تصحبني الى دورة المياه، وأجدها معي الحديقة، وعند بائع البقالة أجدها، وفي المطبخ حيث أعدُّ فطوري أيضاً..
تتسلل الكلمةُ هذه الى معجم صاحبها، دون وعيٍّ منه، فلا اِختيار هنا، إنّما هناك، حاجة ما استدعتها الروح. شخصياً، هكذا أجدني مع الطارئ والغريب من الكلمات هذه. صحوتُ أمس، وأنا أرددُ بيتاً من الشعر، كنتُ قد قرأتهُ في كتاب(النخلة)لأبي حاتم السجستاني، بقول الراجز: "فظلَّ يضوزُ التَّمرَ، والتمرُ ناقعٌ –دماً، مثلَ لونِ الأرجوانِ سبائبه" وفي مكان آخر قرأتُ:" فظل يضوز التمر، والتمر ناقعٌ بوردٍ كلون الأرجوان سبائبه. ومع أنني لم أقف عند معنىً عقليٍّ في (سبائب) إلّا أنَّ الفعل (يضوز) استوقفني طويلاً، فالماضي منه ضازَ، وضازه، ويضوزه ضوزا، بمعنى أكله، وقيل: مضغه، وقيل: أكله وفمه ملآن، أو أكله على كره، وهو شبعان. وراح ابن منظور يقلبها في بحر محيطه، لكنَّ تفسيراً مختلفاً، وبشيء من الحزن استوقفني طويلاً، ففي شرحٍ آخرَ للبيت يقول:" أنَّ رجلاً أخذ التمرَ في الديّة بدلاً من الدم، الذي لونه كالأرجوان!! فجعلَ يأكل التمر فكأنَّ ذلك التمرَ ناقعٌ في دمِ المقتول. يا إلاهي، لماذا لم يتخطَّأه الموت؟ ومن هذا الذي يقبل بالتمر ديةً يا ترى؟