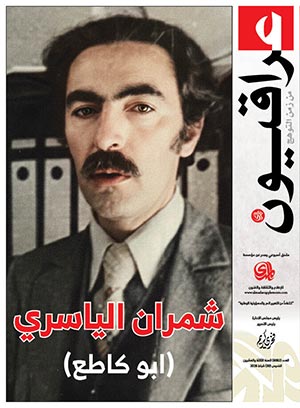طالب عبد العزيز
لا أعتقد بوجود رابط ما بين حي الكريمات؛ الذي بكرخ بغداد؛ وقرية أبو كوصرة، في ابي الخصيب، بالبصرة؛ لكنَّ الحَييّن أو القريتين يشتركان في القِدم، ويغوصان في التاريخ العراقي. وإذا كانت الكريمات(رقّة بن دحروج) كما كانت تسمّى إبان الحكم العباسي، والرقّة تعني الأرض التي تطفح عليها مياه الفيضانات، ويمتهن قاطنوها الحياكة و صناعة الغزول.. ومازال سكانها يحتفظون بالكثير من عاداتهم، فأنَّ أبو كوصرة(الكاف أعجمية) والفصيح منها (قَوْصرّة - سفيف من الخوص، يشبه الزنبيل، يكبس فيه نصف مّنْ بصريٍّ، 32 كغم من التمر-) قرية قديمة، ومن قصبات العهد العباسي ايضاً، يمتهن أهلها زراعة النخيل والخضروات، ويقولون بأنَّ تسميتها جاءت من شخص كان يحمل كوصرة تمر في يوم مطير، ثقل عليه حملُها، فاستودعها قرب ضريح الشيخ أحمد، أحد المتصوفة، وذهب الى بيته، لكنَّ لصاً يتعقّبه أراد سرقتها، وحين همَّ بحملها استحالت حجراً، ببركة الشيخ، فتركها، لكنَّ حفظ الطباع والعادت الاصيلة هو القاسم المشترك بين القريتين.
يتحرك أحدُ المدوّنين الشباب حاملاً كاميرا هاتفه؛ فيصوّر مجموعة من النساء البغداديات، الجالسات في الفسحة المشتركة للبيوت، بحي الكريمات. نساءٌ تجاوزنَّ الخمسين، أو الستين من العمر، يلعب حولهن أطفال، صبيان وصبيّات، حيث تلقي الحياطينُ على الجميع ظلال ما تبقّى من النهار؛ فيسألهن حاملُ الكاميرا ما إذا كنَّ مازلن يرتدين العباءة والشيلة، دون الحجاب المعروف اليوم، عند بقية النساء، فيجبّن: أنْ، نعمْ، في إصرار على حفظ روح بغداد، والبغددة والتبغدد، في مشهد كأنَّه استلَّ من شريط سينمائي خمسينيٍّ، أو ستينيّ. لون البشرة، والثياب الاجمل، والنظرة العفيفة، والصادقة، واللامبالاة بالآخر الغريب، التفاتةُ الرأس البريئة، ثم جعل طرف العبادة على الفم عند الحديث، هذا الحياء الذي لا يباهلُ بقدسية ما، وهذا اللهو المطلق، الذي عند الصبيان خارج المشهد؛ يرجع بنا الى ماضي الضواحي والاحياء تلك، حيث كانت الحياة تمضي بلا معنى، أو بكل معانيها العظيمة.
وفي أبو كوصرة، قبل يومين، كنت قد زرتُ أسعد الدغمان، وشقيقه المحامي الأستاذ حسين، الصديقين، العائديَن من أداء فريضة الحج، مع زائرينَ، آخرين، مباركين لهما الفريضة، والعودَ السالم من الديار المقدسة، لكنني، فوجئت بعدد الزائرين، وبالبيوت المحشوّة بالنخيل، والفاكهة، والمسالك الضيقة، المحفوفة بالأشجار وبالفتيان القائمين على الخدمة، حيث أقاما وليمةً عشاء كبرى، هي الادسم، والاشهى، والألذّ، أشهدُ أنَّ طعم اللحم بالرز، وسط تهاليل وتبريكات الحاضرين كان الاطيب بين ما تنولت وتطعمت. الأكفُّ الخالصة لله، وهي ترتفع بالدعاء، والدشاديش البيض، المؤدّبة بالمكواة طويلاً، واللفظ الخصيبي الأول، الذي لم تشبّهُ عجمةٌ، ولم تمسسه ألسنةُ الآخرين بسوء، ووجوه الناس على الألفة الأولى، التي نعهدها فيهم، وبالسجايا الخالصة، المعجونة بطعوم التمر وأنواعه التي لا تحصى في ابي الخصيب. لا يشبه المكان مكاناً آخرَ في أيِّ بقعة على الأرض، ولا يشبه الناسُ هنا الناسَ هناك، ولا البيوت، كلُّ ما بين النخل وتحت الافياء كان قد قُدَّ من ماضٍ لم يمض، وحاضر لا يريدُ ليد التغيير أنْ تمتدَ اليه فتغيره.
قليلة هي القرى والضواحي العراقية التي ما زالت تحتفظ بهويتها الأولى، وقليلون هم الناس الذين ما زالوا على فطرتهم الأولى، لهجتهم، ثيابهم، عاداتهم، طباعهم. أتذكرُ الآن ما قاله الشاعر الكبير محمود البريكان:" أوثرُ أنْ أظلَّ على جَوادي. ." بالقدر الذي يكون إختلاط الناس فيه نافعاً هناك شيءٌ ما ينهدم في عمارة الرؤيا هذه. مشكلتنا أننا لا نفرّق بين الأصيل والهجين، بين التحضر والبداوة، بين التبغدد والتبصّر والتموّصل ووو وسواه. أنْ تذهب الى مدينة، قرية، حيٍّ ليس لديه/ لديها هوية خاصة به؛ ذلك يعني أنَّكَ تعود من مكان مشوّهٍ، مسخٍ، هجينٍ، لن تحتفظ منه بشيءٍ.