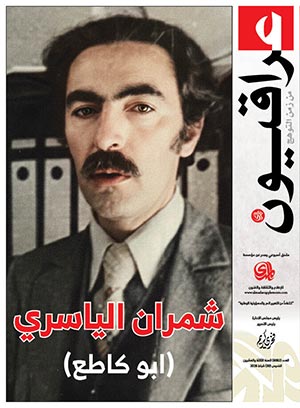طالب عبد العزيز
في حديث لرياض السنباطي عن قصيدة أحمد شوقي (سلو قلبي غداة سلى وتابا) التي لحنها لأم كلثوم نهاية الاربعينات بأنَّ مدير الإذاعة المصرية(البريطاني) أمر بإيقاف بثّ الاغنية بسبب البيت الذي يقول:" وما نيل المطالب بالتمني ولكنْ تؤخذ الدنيا غلابا) تحت ذريعة أنّه يدعو للثورة ضد الاستعمار، يوم كانت مصر تغلي لكنَّ أم كلثوم ذهبت الى المدير الإنجليزي وأقنعته بأنَّ البيت هذا لا علاقة له بالثورة، وهو يحاكي قضية في الدين الإسلامي والنبي محمد، بدليل قول شوقي:" أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك)..
يجدُ المثقف الوطني نفسه محاصراً في دوامة المركزيات، وهي كثيرة، بدءاً من مركزية الدين وليس انتهاءاً بمركزية الطائفة والقبيلة والبيت حتى، وضمن وجوده الفكري، أو الفسلفي، وتدرجه في استحصال المعارف يستشعر غربته، وحين تحاصره مواقف الآخرين، الذين يجدون حياتهم في المركزيات تلك، ولا يودون مغادرتها لا يجدُ سبيلاً يخلصه، فتنهال عليه أكفُّ الاقاويل، وهراوات التخوين، ووسهام التكفير والمروق، وإنْ لم يلجأ الى تبرير لمخالفته لهم في نصٍّ مقدس أو شفيع لغوي ستقام عليه الحجج والحدود، وهكذا ظلَّ المثقف الوطني يكابدُ مواقفه من الحياة والموت والمعتقد والموروث الشعبي، ويبحث في المتون عمّا ينقذه، ذلك لأنها كلها تدخل ضمن دائرة المركزيات التي تكتسي بحضورها المطلق القدسيةَ والمنعةَ، والحجةَ في قمع الآخر المختلف.
نرى كيف أنَّ أم كلثوم تخلت عن قضية الشعب والثورة، التي كانت تغلي أيام الاستعمار الإنجليزي، والتجأت الى المقدّس، مبررةً، الامر الذي ألجمَ الرأي القائل بالضد من ذلك، وهكذا، يفقد الفكرُ قيمته، وتتراجع الآراءُ، ولا يتحقق الفن، وتخفق راية الصدق في مرادها. من المخيب للآمال أننا لا نجدُ وسائط لإقناع الآخر خارج المتون المقدسة، ومؤسف جداً أنَّ تظل حياتنا رهينة العقل المغلق هذا، وأكثر منه أسفاً أن تتحول الطقوس والممارسات الشعبية والشعبوية أيضاً الى سلطة تحولُ بين الوعي والفكر والصدق والمواقف النبيلة، وأنْ تفتك مخالبها في الضمير الإنساني، حتى ليتحول اسمُ العلم الى سُبّة، والتأريخ الى مقصلة، والمتخيلُ؛غير المنصوص عليه الى نصٍّ لا يقبل المحاورة الدحض.
في دوائر البحث عن أسباب تراجع الموسيقى والاغنية والفنون بعامة في العراق على سبيل المثال نجدُ أنَّ المركزيات المقدّسة تلك تكمن وراء ذلك كله، إذ ما زال السؤال الأول قائماً: هل الموسيقى حلال أم حرام؟ ومن السؤال هذا تنطلق جملة الأسئلة الأخر، عن حِليّة الحبِّ، والعشق، والمسرح، والسينما، والاغنية، وحمل آلة الكمان، والعود، وريشة الرسم، وقلم كتابة شعر الغزل، وهكذا تضيق حلقات المنع لتحجب الحياة بأكملها. هناك من يعمل على مصادرة المواقف من الحياة والتطور والمستقبل والرقي تحت ذريعة أنها تتقاطع مع مركزيته، فيما ماتزال مركزيته تلك تعيش في القرن الأول الهجري، فهو لا يريد لصورة أنْ تُرفع في ساحات المدينة إلا صورته المقدسة، دالة الفتك والرعب، ولا نغم لأغنية إلا نغم أغنيته عن الحرب والدم ونثار الجثث، ولا مسرح يقام إلا ما كان يستمدُّ مادته من تاريخه المصنوع من السيوف، وهكذا، لم يعد للوطني المثقف شبرٌ يعيش فيه، فهو غير آمنٍ في بيته، وفؤاده مفجوع في حلمه، وجسده متاح للبنادق في أيِّ وقت. لا ضاحية تسمّى بمشيئته، ولا مدرسة يهتف في ساحتها بنشيده، ولا يجدُ مأمنه في سوق أو شارع أو على ضفة نهر، ترعبه الطبول والسلاسل ومكبرات الصوت، وتلجمه النهايات القاسية، التي تسللت الى السن أقرب المحيطين به. أيها الوطني المثقف: أنت في البلاد التي يضطرك المقدّسُ فيها الى تبرير سماع أغنيةٍ عن الحبّ، ولا تجدُ فيها من ينقذك من السلاسل والطبول ومكبرات الصوت الثقيلة.