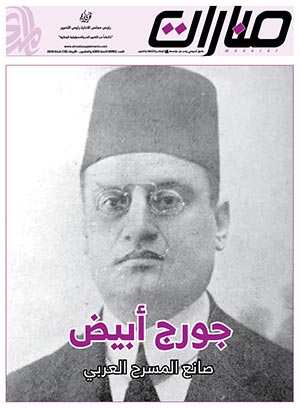أحمد حسن
هل من المعقول أن يتحول ما أُنشئ لتكريم الخير إلى أداة لتبرير الشر؟، هل الجائزة التي حملت يومًا اسم "نوبل" رمز الفكر والابتكار والسلام باتت اليوم تبرر القتل، وتهدي تماثيلها لمن مارس أبشع أشكال التدمير والتمييز العنصري؟. إنها ليست مجرد مفارقة تاريخية، بل انهيار مفهومي كامل لجائزة وُلدت من رحم أزمة ضمير فتحوّلت مع الزمن إلى أداة تزيينية في يد المجرمين.
حين يقوم نتنياهو وهو شخص تلاحقه قرائن موثقة على ارتكابه إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة وغيرها من الجرائم البشعة بترشيح دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، فإننا لا نكون أمام مجرد ترشيح عابر، بل أمام تحول أنطولوجي في بنية الجائزة ذاتها.
دونالد ترامب، الذي أوقف المساعدات الإنسانية عن ملايين المحتاجين في العالم، وشارك في منع دخول الطعام والدواء إلى غزة، بل وساهم في شرعنة الكراهية الدينية والعرقية والهوياتية بصورة عامة، يتحول فجأة إلى مرشح لإحدى أسمى الجوائز العالمية
أي مفارقة هذه؟ بل أي إهانة للعقل الإنساني أن يكافأ رجل جعل من العقوبات الاقتصادية سياسة تجويع جماعي للشعوب ومن دعم الأنظمة الديكتاتورية أداة لمحو العدالة؟.
نوبل، في شكلها الحالي، لم تعد أداة تكريم بقدر ما تحوّلت إلى قناع قيم مزيف يخفي وراءه لعبة سياسية خطيرة. اللعبة تقول، "من يمتلك السلطة والسلاح الفتاك. . يمتلك المعنى"، لذلك فالمجرم، إن أصبح رئيسًا، يعاد تعريفه كـ"صانع للسلام". ومن يسحق شعوبا باسم "محاربة الإرهاب ونزع الأسلحة النووية"، يقدم على أنه مخلص. وبهذا المنطق، لم تعد نوبل سوى منصة لإعادة تعريف القتل بصفته إنجازًا والعنصرية بصفتها "دفاعا حضاريا"، والإبادة الجماعية كضرورة جيوسياسية.
وفي مواجهة هذا الانقلاب الرمزي، لا يمكننا إلا أن نطرح السؤال الديكارتي الجذري، ما هو السلام؟ ومن يحدده؟ وما الجهة التي تقرر من يستحق وسام الإنسانية؟. إن كان من يحاصر الشعوب ويقطع عنهم الغذاء والدواء ويحرض على الكراهية الدينية و العرقية وغيرها ويشارك في الجريمة يعتبر "صانع سلام" فإن معنى السلام نفسه قد تم اغتياله.
نحن لا نشهد فقط اختلالًا في آلية الجائزة بل قتلًا بطيئًا للعدالة الأخلاقية والرمزية التي تمثلها. لذلك باسم العقل وباسم ضمير الإنسانية الذي لم يطفأ بعد، لا بد أن تُخضع جائزة نوبل نفسها لنقد جذري بنيوي. لا بد أن نسأل، من يرشّح؟. . من يقيم؟. . من يقرر من هو "صانع السلام" ومن هو "مجرم الحرب"؟.
لذلك اعادة تعريف الجائزة لا بوصفها وسامًا سياسيًا يعلّق على صدور القتلة بل كمقياسٍ أخلاقي نزيهٍ يكرم من ضحى لأجل الإنسان، لا من استثمر في دمه. إن لم تراجع نوبل معاييرها، فإنها ستتحول نهائيا إلى جائزة "نقتل" لا "نوبل" وحينها لن تكون وسام شرف بل ختم عار. فمن يمنح نوبل اليوم قد يساق غدا إلى المحكمة الجنائية الدولية وما هذا بتناقض، بل هو جوهر المأساة.
في ظل هذا الانحراف الخطير لا بد أن يعاد صياغة العلاقة بين الجوائز والمؤسسات، بين التكريم والقيم بين ما يُمنح من ألقاب وما يُمارس من جرائم. إن جائزة نوبل بوضعها الحالي لا تعكس سوى مأساة الإنسان الحديث الذي تصادر أخلاقه تحت وهج الإعلام، وتدفن معاييره في ركام الدبلوماسية المسمومة. لقد بات من الملح أن ننتقل من مجرد رصد التناقضات إلى مساءلة الجذور. لماذا تُمنح الجوائز؟ ولمن؟ وتحت أي سلطة رمزية؟.
فما لم تخضع نوبل ومثيلاتها لمنطق المساءلة الأخلاقية لا الحسابات الجيوسياسية فإننا سنشهد المزيد من "التكريمات" التي تبيض وجوه الطغاة وتطمس دماء الضحايا. وحين يغيب صوت الفلسفة عن طاولة القرار تصير الجائزة غلافًا أنيقًا للوحشية. وحين يقصى الضمير يحتفل بالجريمة كما لو كانت فضيلة. إن الدفاع عن المعنى ليس ترفا فكريا، بل هو دفاع عن الإنسان نفسه عن حقه في أن يكرم من يبني لا من يهدم، من يحيي لا من يقتل، من يصغي للحق لا من يصادره.