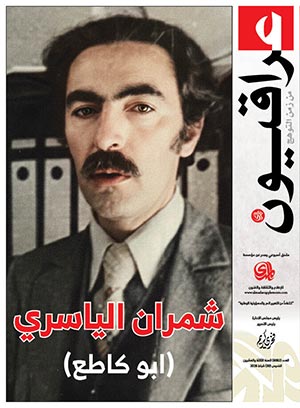طالب عبد العزيز
تنفردُ أمُّ كلثوم من بين عشرات المطربات والمطربين العرب بصلاحيتها في استحضار الماضي العربي، الماضي حسب، فهي الوحيدة التي يصرُّ على سماعها الشيوخُ في مقاهي وحانات المدن العربية، حيث يستحيل سماع فيروز أو عبد الحليم ونجاة وسواهم هناك، هذا الصوت الذي يجمع بين الذكورة والانوثة في آن، خصيصة الشجن والفقد والتأسّي سيظل حتى يشاء الله قرين الأجساد العاطلة، والحيطان القديمة، والمقاعد الخيزران، وأباريق الشاي، وكؤوس الخمرة، وكما لو أنه صنع ليتجمدَ في الزمن لا ليتحرك فيه، صوت معلبٌ بامتياز، لا تنتهي مدةُ صلاحيته.
ندرةٌ من الأجيال الجديدة هم من يستمعون لأمَّ كلثوم اليوم، اللهم إلّا من أصاب قرحُ الهوى قلبَه، أو من نهض بوعيه قليلاً، وتذوق الصوتَ والشعرَ والنغمَ، مع أنَّ عدداً ليس بالقليل من أغنايتها يصلح لمثل هؤلاء، فقد قدّمت للفرح والورد والامل، قوامَ كلِّ موجود، بما يستحقُّ أن يكون فسحةً في تأمل الحياة وتقبلها، إلّا أنَّ الجيل الأول، أبناءَ العقود السالفة الطويلة، من بقي منهم على قيد الماضي، وأميناً على إرث روحه، وخاب أمله في الزمن الجديد، ولم يجد فيه ما يستحق التشبث به، أولئك، وحدهم مازالوا يبحثون في صوت السيدة عن ضالتهم، بعد طوفان الخذلان الذي تعرضوا له.
يشكل صوت أمِّ كلثوم معادلاً موضوعياً عند هؤلاء، نقطة توازن قصوى، ففي أوطاننا العربية قد تتجاوزالخيبةُ معنى الفقد المعلوم الى شيءٍ مضاعٍ آخرَ، لا معنى له، ولا علاقة له بالمال والصحة والتغرّب، إذْ يكفي أنْ يمضي الزمن بأحدنا حتى تبدأ مأساتُه، التي سيعاني منها حتى نهاية حياته، مأساته التي لا يعرف مصدرها أحياناً، هي شعورٌ فطريٌّ بالوحدة والضياع والغربة، يتلبسُ الانسانَ العربيّ، دونما وعيٍّ منه، وإن تنعَّمَ بما يتنعم به الاخرون من حوله، هو يقصده، ويذهبُ اليه طواعيةً، ويظلُّ يبحث عنه في المقهى، والبار، ويأنس به عند سريره في الليل، يلجأ الى الصوت الكلثومي(الوجيب) يسمعه عشرات المرات، ويطيل الاصغاء اليه، يحفظه عن ظهر قلب، حتى إذا تشبّع به ذهبَ الى قراءة جملة ما كتبَ عنه/ها، وقائع وأحاديث وقفشات، فنجد بينهم من تفقَّه في معرفة الشعراء والملحنين والموسيقيين، الذين وقفوا وراءه، والأسباب التي كمنت خلف التأليف والتلحين وغير ذلك.
لكن، قد لا نجدُ بينهم من تورَّط في حبِّ امرأة ما، ولم يعان يوماً من هجران، ونقص في الوفاء، وهناك من شغلته الوظيفة، وتصاعد فيها مديراً ووزيراً، وتمتع بالمال والنساء والسفر، ولم يُضم بضيم، أبداً، لكنَّ هؤلاء لن يسلموا من مرض السماع للصوت ذاك، وسيصابوا به لا محالة، وإنْ تفادوه بهذا وذاك. فواحدهم سيردد وإنْ مكابراً مع نفسه" تفيد بأيه يا ندم، وتعمل ايه يا عتاب، طالت ليالي الألم، وتفرقوا الاحباب، وكفايه بقى، تعذيب وشقى، ودموع في فراق، ودموع في لقاء، تعتبْ عليَّ ليه، أنا في ايديه ايه.. فات المعاد فات." وهكذا يصبح صوت السيدة عنده بمثابة المناجاة والوقوف على الاطلال في الشعر العربي، حيث لا نعدم بينهم من يبكي وينتحب من مجلسه في الأمكنة تلك.
في الذات العربية هناك شيءٌ مفقود دائماً، جرحٌ متوارثٌ، لا نريد البحث في أسبابه، فهي كثيرة، ليس أولها الدرس الديني الملتبس للحياة، وليس آخرها سوء النظام السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، فالعربي يولد وفي قلبه مرض الفقد، وإلا كيف نقرأ القصائد الطللية، التي كتبت قبل الإسلام وبعده؟ إذن نحن أزاء جغرافية بشرية مختلفة تماماً، في وجدانها ظمأٌ أبديٌّ لما هو سالف وذاهب، مع أنَّ قانون الحياة في كلِّ مكان بُنيَ على متواليه الوجود والفقد، وهو كمتوالية الولادة والموت، القانون العملي والواقعي لكل وجود وحياة.
من يتفرس وجوه الجالسين في مقهى أم كلثوم التي في القاهرة، أو التي في بغداد والبصرة ودمشق وسواها من المدن العربية سيقف بقوة على صورة الشرق العربي بأجلى معانيه، هذه الأرض التي تشكلُّ الشمسُ واحدةً من المآل المفزع ذاك، غير المتأتي بالاسباب الظاهرة، وغير الموجز في كلمة، إنما هو الشرق باسراره العظيمة، حيث يكونُ الحزنُ والفقد والخيبة عِرقاً في الوجدان، عابراً التفاسير الى الأسئلة الغامضة الكبرى.