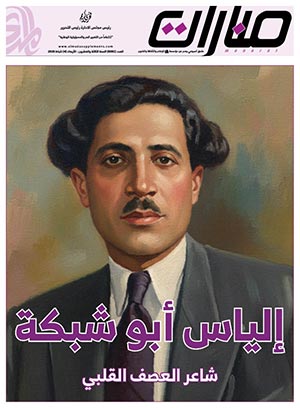علاء المفرجي
بالنسبة للميعة وجدتها، اللتين تعيشان في قرية ريفية في منطقة المستنقعات، فإن حظوظ الفتاة ليست مجرد إزعاج؛ بل هي محنة. فقد طُردت الجدة من عملها الزراعي في الحقول، وبالرغم من أن (الرئيس) وفر شاحنات المياه، لكن الحصول على المواد الغذائية الضرورية، لن يكون سهلًا، ناهيك عن تحمل تكلفتها. وهو استهلال رائع للفيلم، وليس فقط لإحساسه الواضح بالمكان، بل بتفاصيل الحدث.
هذه التفاصيل، تُخبرنا بها عينا لميعة المعبّرتان بكل ما نحتاج معرفته عن التبعات العاطفية لهذه المحنة، وكأن المخرج يصوغ من أدائها مستقبلًا زاهرًا لها في عالم السينما، ولعلها المرة الأولى التي نقتنع تمامًا بأداء ممثل طفل في السينما العراقية، الذي لطالما كان معضلة كبيرة للمخرجين العراقيين في التعامل مع مثل هذه المواهب..
(لميعة)، فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات تضطر للسفر، مع جدتها العجوز، إلى المدينة للحصول على المكونات الأربعة التي تحتاجها لصنع الكعكة، كما أراد ذلك معلمها القاسي. خلال رحلتهما، يلتقيان مصادفة بالطفل سعيد (سجاد محمد قاسم)، الذي كلفه المعلم بجمع الفاكهة. لنكتشف -فيما بعد- أن (الجدة) قد أرادت من هذه الرحلة شيئًا آخر يخص مصير لميعة.
ينتهي الأمر بهروب لميعة من مخططات الجدة، لنتابع رحلة الطفلين (لميعة وسعيد) في المدينة، وهما هاربان ووحيدان، ما يضطرّهما للاعتماد على أنفسهما بلقاءات مُضحكة، وأخرى مُحفوفة بالمخاطر. لتتحول هذه الرحلة إلى مغامرات للأطفال في المدينة، والأشخاص الذين يلتقون بهم ويحاولون التفاوض معهم يتسمون باللطف والقسوة والمكر والاستغلال، لكن الأطفال – وديكهم – يدخلون في كل تفاعل ببراءة أقرب إلى النزاهة والقوة الداخلية، مع كل لقاء عابر. ليفصح ذلك عن التناقض الصارخ بين وهم الرخاء الذي تغذيه الدعاية، والحقيقة القاسية التي يعيشها العراقيون العاديون. في أحد المشاهد، يطلب الجيش تبرعات لعيد ميلاد الرئيس. وفي مشهد آخر، يقايض المواطنون آخر ممتلكاتهم بالطعام والملابس، بسبب انتشار العملة المزورة.
القصة مستمدة من تجربة شخصية، سمعها من أبيه، أو ممن عاصر تلك المرحلة، وبشكل خاص طقوس الاحتفال بعيد ميلاد الديكتاتور، التي كانت إلزامية على كل مواطن، بغض النظر عما يعانيه العراق، ووسائل الضغط أو العقوبات الأميركية. إنه موقف يتناوله الفيلم بروح السخرية السوداء، وجزء صغير من هذا يتضمن سحب الأسماء في الفصل الدراسي، حيث يتعين على الطالب الأقل حظًا تقديم كعكة.
تغوص كاميرا حسن هادي ببراعةٍ في الآثار النفسية للديكتاتورية، من خلال (المازوشية) التي يمارسها الأطفال بعبادة ما يخشونه، والاحتفاء بمن يُجوعهم. فتتجلى صدمة هذا التناقض بين الخوف والرغبة في المشاركة بالاحتفال بوضوحٍ على وجه لميعة، خاصةً عندما تدرك أن هذه الكعكة قد تُكلفها منزلها وعائلتها، الوحيدين اللذين تعرفهما.
بكاميرا المخرج، التي تقدم سردًا يتميز بجمالياتٍ واضحة تُرسخها الموسيقى التصويرية، المشغولة بالعود العراقي بأصالةٍ ثقافية، تبدو أقرب إلى الأفلام الوثائقية في واقعيتها. على الرغم الإيقاع البطيء في الأحداث أحيانًا، والتغاضي عن البناء المحكم للشخصيات في بعض نقاط الحبكة (مثل عدم معرفة ما حدث لوالدي لميعة، ولماذا هي مع جدتها؟) لكن هذا لا يمنع من أن يبقى الأثر العاطفي للمتلقي طويلًا بعد انتهاء الفيلم.