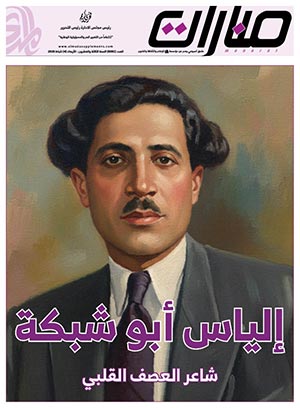أحمد الناجي
انطلق الدكتور علي الوردي منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، في مسار فكري مغاير، مستوعباً ما تيسر له من نظريات علمية عبر تخصصه الأكاديمي في علم الاجتماع، متبنياً رؤية تنويرية تستلهم روح النهضة العربية، وتسعى الى تجديد أدواتها ومفاهيمها، واستطاع أن يحقق استقلاليته كمثقف في تشييد ركائز مسيرة فكرية حثيثة تتجه نحو التجديد، مبتعداً عن التعصب لأي معتقد أو رأي، منطلقاً من رؤيته وتصوراته لطبيعة المجتمع العراقي، متأملاً في معيقات نهوضه، وباحثاً في أسباب تخلفه وجموده، وقد تنبه الى بعض مما هو متجلي من تضاريس وظلال في مشهدية الفكر العراقي المعاصر، ومنها على سبيل الإشارة:
قصور في الإبداع الفكري، سيما في البعد الفلسفي التي يمثل أعلى مراحل التفكير، وضعف الرؤية بسبب الافتقار الى النظرة العلمية، وعدم القدرة على التحليل، وانغلاق الذات الناشئ بسبب إسقاطات الايديولوجيا والعقائد ورواسب الماضي، كما تأمل ما ينتج من معطيات بسبب تلك الحيثيات على الفرد العراقي من تناشز اجتماعي وازدواجية في الشخصية.
وهذا الأمر مهد له الانفتاح والخوض في غمار دراسة طبيعة العقل البشري وطرائق التفكير، فتصدى الى دراسة إشكالية المنهج (الأرسطي القديم) بوصفها معضلة متمثلة في استخدام نمط تقليدي في التفكير، غير قادر على توجيه العقل الوجهة الصحيحة التي تمكنه على اكتشاف حقائق الأشياء، واجتراح ممكنات نقل المتعقلات الى الواقع بما يوازي حاجات الإنسان في وفق ما تقتضيه روح العصر الحديث الساعية نحو معارج الإنسانية، حيث للفرد قيمة وللعلم المكانة الأولى. وقد مثلت توجهات الوردي في هذا المنحى محاولة واعية، رفضت الاستسلام لما هو سائد من جمود على النطاق الفكري، ونشدت توجيه الفكر عبر تطوير رؤيتنا لواقع الأشياء وما حولنا من ظواهر وفق منهج علمي حديث. دخل الوردي بسبب اطروحاته غير المألوفة في مواجهات متعددة، ووجد نفسه في خضم دائرة مفرغة من الجدل المحتدم، أثارته أطروحاته الصادمة بين طيف واسع من المثقفين العراقيين من أكاديميين وأدباء ورجال دين وغيرهم، وقد أوجز وصف معاناته في تلك الأثناء، بقوله: "إنهم يكتبون بواد، وأنا اكتب بواد آخر. إنهم يكتبون على نمط ما كان يكتبه الناس في قرون مضت، بينما أحاول أنا أن اكتب على نمط جديد، وشتان بين تفكير القرن العاشر وتفكير القرن العشرين". وأراد الوردي أن يحتكم بالرهان على المستقبل خارج مدارات الجدل العقيم، في زخم ما كان يوجه اليه من انتقادات، بعضها صدرت من شخصيات بسبب كونها لا تحتمل خطابه التجديدي، وبعضها ابتعدت كل البعد عن الذوق واللياقة، لما راحت تكيل له التهم والشتائم والتهديدات بالقتل، كما يحلو لها أن تمارس سطوتها من منطلق الوصاية على العقول.
وفي استدراك ينم عن معرفة ببواطن الأمور، وصف الأستاذ حميد المطبعي بدقة ما جناه الوردي من مخالفيه ومنتقديه، بقوله: "وبالحق فأن الوردي أنْتُقِدَ بالكثرة، وقيل فيه الشدة، ورمي بشتى التهم". كل ذلك جرى وأزيد مع الوردي الذي كان لا يناقض ليبراليته، مؤمناً بالاختلاف والتعددية، ففي حوار معه بمجلة (قرندل)، منشور على الأكثر في النصف الثاني من عقد الخمسينيات من القرن المنصرم، وفيه أعاد الصحفي المحاور على مسامعه ما كان قد وجه اليه من مقولات لاذعة ونعوت لا تخلو من الاستخفاف والتندر، صدرت عن ثلاثة من منتقديه، وهم من كبار الأدباء والمثقفين العراقيين، كل من: الدكتور علي الزبيدي، وحامد محمود الصراف، والدكتور محمد مهدي البصير، أبتسم الوردي حينها، ورد على محاوره ببرود لافت واتزان مقصود، يعكسان ما في دواخله من ثقة عالية بالنفس، قائلاً: «أنا لا أقول فيهم شيئاً، ولكل واحد وجهة نظره فيّ، (خلهم يكولون خلهم).. دعهم إنها وجهات نظر، وللكل الحق في إبداء رأيه». وهنا تجدر الإشارة الى أن الوردي قد تعرض الى حملة حادة من بعض الأقلام بعد صدور كتابه (وعاظ السلاطين) سنة 1954، واجه سبعة كتب صادرة ضده، وحررت في نقده مقالات لا تُحصى، فضلاً تهديدات بالقتل أكثر من مرة، ولم تقتصر الانتقادات على ذلك، بل طالته تقريعات لاذعة في خطب بعض رجال الدين من على المنابر، حتى أن أحد خطباء التعزية خصص ليالي شهر رمضان بأكملها لنقد الكتاب المذكور وسبّ صاحبه.
قام الوردي بدراسة طبيعة المجتمع العراقي عن كثب، وأدرك آنذاك أن القبول بالرأي الآخر ليس من محمولات ثقافتنا الاجتماعية، فلم نعتد على تقاليد الحوار الجاد والمناظرة العقلانية، ولم يكن لدينا متسع لسماع الرأي المخالف، وغابت عنا أسس المناقشة العلمية الرصينة، ولذلك كله، فضل الوردي أن يترك وراءه كل ما واجهه من تعسف وإيذاء ومعاناة، ووسط تلك الأجواء المشحونة، لجأ إلى أفكار الكاتب الأمريكي ديل كارنيجي، الذي يرى أن كسب الجدل يتحقق بالابتعاد عنه، إذ أن أصحاب الرأي المختلف كل منهما يريد أن يغلب في الجدل، ولكن لا يوجد في ذهنهما أي فسحة أو متسع لكي يقتنع بأدلة الآخر، حتى أن الحق والحقيقة باتت من أبعد الأمور عن الذهن، وكأن (الأنا) هي المحور الذي يدور حولها الفكر في الجدل وليس الدليل العقلي.
ولهذا توجه الوردي الى منتقديه، بالقول: ليس لدينا مقياس عام يقبل به الجميع حتى نحتكم اليه، والمستقبل هو الذي سيكشف عن مبلغ الصواب في تفكير كل فريق. ظل الوردي في واقع الأمر، يتعامل مع هذا وذاك من منتقديه تارة بالمواجهة في ظلال الكلمات، وأخرى بصمت التجاهل عبر ما يعرف بـ( إعطاء الأذن الطرشة)، ولكنه في العموم لم يستكن، ولم يلجأ الى ملاذ الصمت الذي أراد لنا أن نفعل على مقاسات كارنيجي، بل كان يرد بعناية على ما يراه جديراً بالتعقيب –في مقدمتهم الدكتور عيد الرزاق محي الدين- ويساجل خصومه بذكاء العارف بلا انفعال. متشبثاً بالفسحة المتاحة وما هو متيسر من هامش حرية التعبير، فكتب في أشد الأوقات عتمة، حتى تحت سقف واطئ، وكان يُدارِي كتاباته بمرونة الحياد الكاذب، في ظل ما كان يعتريه من رهبة وخوف، يناور بحيلة العارف ببواطن الأحوال والأهوال، ويرد أحيانًا بصلف على الصلف، على ما تناثر من انتقادات حادة طاولته شخصياً، أو استهدفت آراءه الفكرية وفرضياته الاجتماعية المتصلة بالمجتمع العراقي، ولا ضير في أن يكون قد أخفى في ما كتب مضمرات لا تنطلي على ذهن القارئ الحصيف، ولماذا نعيب عليه إن تشاطر دس السم في العسل –كما وصفه أحد المسؤولين في العهد الملكي، وهو ما اعترف به الوردي صراحة- أو لجأ منذ سبعينيات القرن الماضي في زمن النظام الديكتاتوري البائد الى المناورة بالصمت وضعف السمع، ثم حاول الادعاء بالبراءة، صحيح أنه لم يتخذ موقفاً ومواجهة في العلن، إلا أن براءته المصطنعة لم تتحول يوماً إلى مهادنة.
وما يحسب له حقاً في أواخر سنواته، أنه صمد بصلابة أمام عواصف الانتقادات التي لم تكن في أغلبها سوى هجمات تحمل الضغينة، متسقة مع مزاج السلطة الحاكمة أو معبرة عنها، وسط هذا الضغط النفسي والاجتماعي المكثف، بدا الوردي كمن يقف ثابتاً في وجه الرياح العاتية، متشبثاً برؤيته وفكره، متحلياً بشجاعة صامتة تتحدى كل التهديدات والضغائن. في أواخر أيامه، عبر الوردي عن احتجاجه، بوجه أولئك الذين أساءوا التعامل معه، ونسوه أو تناسوه. فقد رد بكبرياء على دعوة نادي جريدة الجمهورية لتكريمه عام 1994، مكتفياً بأن يبعث مع ابنه حسان رسالة وجيزة، تحمل بيتاً واحداً لأبي فراس الحمداني، ولسان حاله يقول: أتت وحياض الموت بيني وبينها وجادت بوصل حيث لا ينفع الوصل كانت تلك الكلمات، بما انطوت عليه من مداليل عديدة، إعلان موقف أخير لرجل ظل وفياً لنفسه حتى النهاية. قال الوردي كلمته، ثم مضى بصمت نبيل في منتصف عام 1995، مترفعاً دون أن يلتفت الى الوراء وسط أجواء الحصار الأسود والكئيب الذي كان يخيم على البلاد.