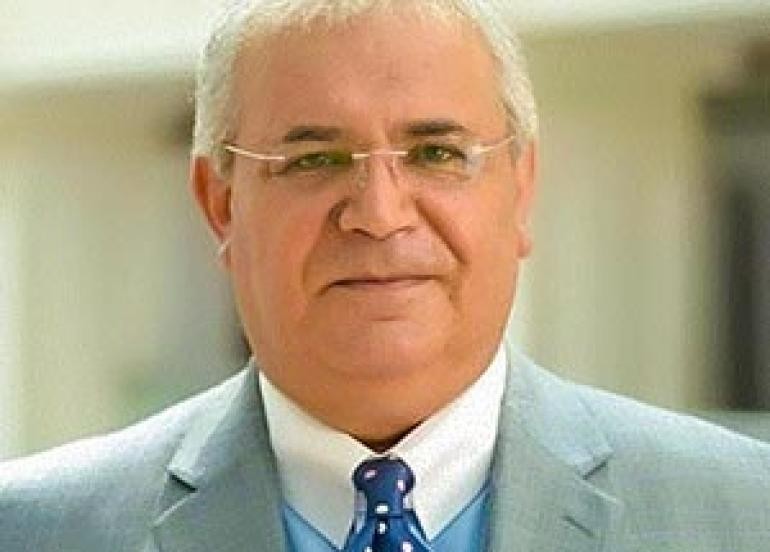إسماعيل نوري الربيعي
يبدو أن بعض العراقيين، في لحظات الغضب أو الفخر أو الضياع الهوياتي، يتحوّلون فجأة إلى أحفاد جلجامش، وأبناء أور، وورثة الخط المسماري. يخرج أحدهم على الناس كاشفاً عن «أصوله السومرية» وكأنه عاد لتوّه من تنقيب أثري في جيناته! يصافحك بثقةٍ متحفية ويقول لك: «نحن السومريين أصل الحضارة!»، وكأنه يتحدث بضمير الجمع عن ملوك الطين الذين رحلوا منذ أكثر من أربعة آلاف عام. هذه الظاهرة، التي تتكاثر في مواقع التواصل كما تتكاثر الأساطير في كتب الميثولوجيا، ليست مجرد طرفة عابرة، بل هي انعكاس عميق لأزمة هوية مزمنة في العراق الحديث: بلد يعيش فوق تربة تفيض بالآثار، وتحت سماء تفيض بالانقسامات. فحين لا يجد العراقي أرضًا ثابتة يقف عليها في حاضره، يستدعي الماضي ليكون سنده الرمزي. غير أن المفارقة أن هذا الماضي نفسه لم يعد موجوداً إلا في المتاحف، وفي النقوش الطينية التي تحتاج إلى عالم آثار لفهمها، لا إلى «حفيد» فيسبوكي يصرّ على أنه من نسل إنكيدو.
السومرية كهوية بديلة عن الواقع
في علم الاجتماع الثقافي، هناك ما يُسمّى بـ “الهوية التعويضية”، وهي تلك التي يُنشئها الأفراد حين يشعرون بأن هوياتهم الراهنة غير مشرفة أو مضطربة. العراقي الذي تعب من الانتماءات الطائفية والسياسية الممزقة، يجد في السومرية مهربًا فخمًا، فهو لا يعود شيعياً، ولا سنياً، ولا عربياً، ولا كردياً، بل يصبح “سومرياً خالصاً”، أي من سلالة ما قبل الصراع نفسه! إنها قفزة تاريخية إلى الوراء تتيح له أن يتحرر من الواقع دون أن يغادره تماماً. لكن، لو افترضنا جدلاً أن هذا الادعاء يحمل شيئاً من الصحة، فالسؤال العلمي البسيط هو: أين كانت هذه السلالة طوال الأربعة آلاف سنة الماضية؟ كيف عبرت المجازر، والغزوات، والمغول، والعثمانيين، والإنكليز، والبعث، والاحتلال الأمريكي، لتصل إلينا سالمةً تمشي على الأرض وتكتب على تويتر؟ هل انتقلت الجينات السومرية عبر الفرات على زورق من القار، حاملةً معها ألواح الطين في حقيبة سفر وراثية؟ العلم الحديث، بكل بروده القاسي، يذكّرنا بأن السومريين كانوا جماعة لغوية – ثقافية، لا عرقاً نقياً يمكن توريثه. اندمجوا لاحقاً مع الأكديين والبابليين، وتلاشت لغتهم كما تلاشت لغات كثيرة. لا أحد في العالم اليوم يتحدث السومرية، إلا بعض المتاحف حين تفتح فمها لتشرح النقوش للسياح. ومع ذلك، تجد بيننا من يكتب على حسابه الشخصي: “أنا سومري، أفتخر بأصولي المسمارية»!
جينات على هيئة تمثال
في مقهى شعبي في الناصرية، قد تجلس إلى شخصٍ يرتدي دشداشة عادية ويشرب الشاي الثقيل، لكنه يهمس لك بفخر؛ “جدّي من أهل أور”. تسأله: “يعني من الناصرية؟” فيقول: “لا، من أور الأصلية، من أيام لوكال زاكيزي!”، وكأن الرجل يحتفظ بسجلٍ عائليٍّ يمتد حتى ما قبل الطوفان. المفارقة أن هذا الجد المزعوم لم يترك لا صورة ولا وصية، ومع ذلك يعيش حفيده الحديث على ذكراه الأسطورية، كما يعيش بعض الأوروبيين على نسبٍ روماني متخيَّل. الأمر لا يخلو من كوميديا أكاديمية أيضاً. فقد ظهرت في السنوات الأخيرة دراسات “هوياتية” كتبها هواة، تحاول إثبات أن العراقيين اليوم يحملون الجينات السومرية في دمهم! وتُستَعمل عبارات مثل “التحليل الجيني الجزيئي” بطريقة تثير الرغبة في البكاء والضحك معاً، إذ يختلط العلم بالحنين كما يختلط الطين بالماء في بلاد الرافدين. هؤلاء لا يميّزون بين الثقافة والوراثة: فأن تكون من بلاد السومريين شيء، وأن تكون سومرياً شيء آخر تماماً، كما أن السكن في باريس لا يجعلك فرنسياً من سلالة فولتير.
جلجامش في المول التجاري
لعل أجمل المشاهد الساخرة في هذه الظاهرة، هي تلك التي تحدث في الفضاء الافتراضي. ترى أحد “الأحفاد السومريين” ينشر صوراً لتماثيل الآلهة القديمة، ثم يكتب تحتها: “هكذا كان أجدادنا يعبدون الحكمة قبل أن يعرف العالم الأديان”! وبعد دقائق، تجده ينشر إعلاناً لمنتج تجميلي جديد كتب عليه “منتج سومري %100” كأن جلجامش قد استبدل بحثه عن الخلود بعرض تخفيضات في أحد المولات. لقد تحوّلت السومرية في بعض الأوساط إلى “ماركة” ثقافية تُستعمل للزينة، أكثر منها فكرة تاريخية. حتى بعض النشطاء يرفعون شعار “نحن سومريون قبل أن نكون عراقيين”، وكأن الانتماء الحديث وصمة، والانتماء الطيني وسام شرف. هذه المفارقة تجعل من الهوية السومرية مجرد ديكور سياسي أو نفسي، يُعلّق على جدار الواقع المتداعي لإخفاء الشقوق. في التحليل الثقافي، هذا النوع من الارتداد إلى الماضي السحيق يُسمّى “الحنين الأنثروبولوجي”، وهو حنين لا إلى زمنٍ عشته، بل إلى زمنٍ تتخيله كما تريد. إنه شكل من أشكال الأسطرة الذاتية؛ تحويل النفس إلى أسطورة لتفادي مواجهة الواقع. فبدلاً من أن يسأل الفرد: “ما دوري في بناء الحاضر؟”، يسأل بفخرٍ بدائي؛ “من كان جدّي في الألف الثالث قبل الميلاد؟”. والنتيجة أن الماضي يصبح جثة محنطة نحملها معنا في كل مناسبة. نُخرجها عند اللزوم ونقول: “انظروا! هذا أنا قبل آلاف السنين!”، بينما الواقع الحديث يئن من الانقسامات والفساد وسوء الإدارة. أليس من الغريب أن نبحث عن هوية في مقبرة، بينما المستقبل ينتظر منا أن نبني له بيتاً؟
العراق بوصفه متحفاً يعيش فيه الناس
في هذا السياق، تبدو الدولة العراقية كأنها متحفٌ كبير يعيش فيه الناس بين الآثار، لا كمواطنين، بل كأمناء متحف منسيين. كل واحدٍ يريد أن يكون تمثالاً قديماً يلمّعه الغبار الوطني. وهذه النزعة، في جوهرها، انعكاس لغياب سردية وطنية حديثة. فحين تفشل الدولة في إنتاج هوية جامعة، يلجأ المواطن إلى هوية أقدم من الدولة نفسها. والنتيجة: عراق يتكلم بلغة القرن الحادي والعشرين، لكنه يحلم بألواح طينية من الألف الثالث قبل الميلاد. من وجهة نظر علمية بحتة، لا وجود لما يُسمّى “السلالة السومرية النقية”. فالحضارات القديمة لم تكن كيانات مغلقة بيولوجياً، بل تفاعلت وذابت في بعضها البعض. السومريون أنفسهم لم يأتوا من العدم، بل اندمجوا لاحقاً مع الأكديين والكلدانيين والآشوريين، تماماً كما تذوب الحروف في نصٍ طويل لا يمكن فصل كلماته الأولى عن الأخيرة. من هنا، فإن ادعاء النقاء السومري يشبه محاولة استخراج نغمة واحدة من سيمفونية عمرها خمسة آلاف عام. ولأن السخرية هي الوجه البشري للعلم حين يواجه الجهل المتأنق، فإن الباحث الحقيقي لا يسعه إلا أن يبتسم بمرارة أمام هذه الموجة من “السومرية الشعبية”. فالعلماء يقضون أعمارهم في تحليل النصوص الطينية لفهم كيف كان السومريون يفكرون، بينما أحفادهم المفترضون يقضون أوقاتهم في نشر صور تماثيلهم على إنستغرام!
الماضي كأفيونٍ للهوية
قال ماركس إن الدين أفيون الشعوب، لكن يمكن القول في حالتنا إن “الماضي أفيون الهوية”. فحين تفقد الشعوب ثقتها بالحاضر، تبدأ بتخدير نفسها بالزمن القديم. والمفارقة أن هذا التخدير يخلق نوعاً من الغرور الحضاري الفارغ، إذ يصبح المرء فخوراً بما لم يفعله، ومعتزاً بما لا يعرفه. إن اعتناق السومرية المعاصرة لا يختلف كثيراً عن ارتداء زيٍّ تاريخي في حفلة تنكرية وطنية؛ لحظة هروب جماعي من الواقع باسم المجد المفقود. لنكن منصفين، ليس في الانتماء إلى الماضي ما يعيب، بل العيب في تحويل الماضي إلى بديل عن الحاضر. فالعراقي الذي يفخر بسومريته يمكن أن يستثمر هذا الفخر في قراءة تراث بلاده بوعي نقدي، لا في ادعاء نسبٍ أسطوري. فالقيمة الحقيقية للحضارة السومرية ليست في دمها “إن وُجد” بل في فكرها، في قدرتها على تنظيم المدن وابتكار الكتابة وتأسيس القانون. هذه هي الوراثة التي تستحق أن نحملها، لا جيناتٍ من الطين، بل وعياً من الحكمة.
إن حفيد جلجامش الحقيقي ليس من يحمل لقبه، بل من يواصل بحثه عن الخلود الفكري، عن المعنى في عالمٍ مضطرب. وربما كان الخلود اليوم هو القدرة على إنتاج معرفة جديدة، لا على تكرار أسطورة قديمة. فالسومرية الحقيقية ليست انتماءً بيولوجياً، بل تمرينٌ حضاري على أن تكون إنساناً يبتكر لا إنساناً يتغنّى بالاندثار. إن من يدّعي اليوم أنه من “أصول سومرية” يسيء من حيث لا يدري إلى السومريين أنفسهم، لأن أولئك العظماء لو عادوا اليوم لدهشوا من أحفادهم الافتراضيين الذين يرفعون صورهم دون أن يقرأوا حرفاً من ألواحهم. ربما كانوا سيقولون لهم: “أيها الأحفاد، لا نريد منكم أن تشبهونا، بل أن تواصلونا”. فالحضارة لا تُورث بالدم، بل تُورث بالفعل، والذين يحاولون إحياء السومرية في زمن الإسمنت والخرسانة، يشبهون من يحاول نفخ الروح في تمثال حجر. ذلك أن الحضارة، يا سادة، لا تعيش في الأنساب، بل في الأفعال. والسومري الأخير، إن وُجد، لن يكون من يصرخ على الملأ: “أنا سومري!”، بل من يكتب، ويبني، ويزرع، ويترك وراءه أثراً يستحق أن يُنقش في طين المستقبل.