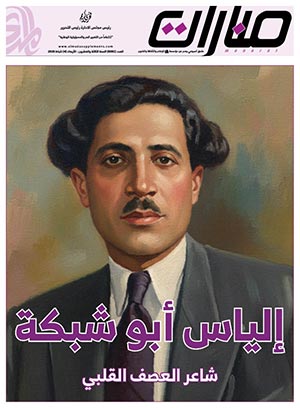طالب عبد العزيز
أراد بعضُ الأهل أن نجعل الطفل؛ ذا السنتين في تابوت من التوابيت الثلاثة الكبيرة، المركونة قرب المغتسل، لكنْ، أنّى للجسد الطفل الذابل أنْ يشغلَ فتقاً واسعاً، قلتُ هذا كثيرٌ عليه، رفضتُ الفكرةَ، فقد أشفقت عليه تقلبه في متاهة الخشب الواسع الطويل. في الليلة قبل البارحة لم يأذن دفّانُ مقبرة الحسن البصري لنا بالدفن في مقبرته، ولأمر لا نعلمه أمرنا أن نعود به في الصباح، إنْ أردنا ذلك، ولأنَّ الليلَ كان في أوله، والفجرَ جدُّ بعيد، فقد اقترح علينا الذهاب به الى المقبرة المجاورة، وهكذا أخذَنا رتلُ المركبات الى هناك، وحين صرنا الى بابتها كان الليل قد اليل كثيراً، والشجرتان العظيمتان عند المدخل توشوشان معاً، فيما لا يضفي صمتُ المقبرة على الرجل الحارس(الدفَّان) أيَّ شيءٍ من الخوف، فهو رجل صلبٌ يجاور القبور من سنوات، ويهرع الى سريره، غير عابئ بأحدٍ.
تختلف مقبرةُ الاحسائيين أو مقبرة السيد أحمد كثيراً عن مقبرة الحسن البصري الكبيرة، التي تأسست بعد دخول العرب المسلمين البصرة سنة 14 للهجرة، أما هذه فقد تأسست سنة 1936 حين دُفن فيها أول طفل اسمه أحمد الياسري، ثم توالى سكأن مدينة الزبير من الاحسائيين الشيعة دفن الموتى من أطفالهم حوله، وحين اكتسب المكان صفة المقبرة ابتنى ذوو الطفل الصغير قبة صغيرة على قبره ليصبح المكان دالةً لمن يضلُّ الطريق الى المقبرة، وهكذا كنا الليلة تلك، حيث لم نهتد اليها إلا بعد لأيٍّ، على الرغم من استعانة المشيعين بمرشدات الـ GBS التي ظلت تشير الى المقبرة الام، ولكي أخفف من وجع الكتابة عن الطفل والمكان والمدفونين فيه فقد توجهت الى صديقي الفاضل عادل علي عبيد، المؤرخ والباحث الذي سكن وأسرته الزبير منذ عقود بعيدة ليعلمني بأنَّ طائفة الاحسائيين الشيعة إنّما يرجعون في انسابهم الى قبيلة عبد القيس، الذين سكنوا أحد أخماس البصرة؛ يوم اِختطها مجاشع بن اذرع السلمي مع من سكنها من العرب المسلمين آنذاك.
كنت قد اخترت مكاناً أقصى المقبرة حين شرع حامل الرفش بحفر القبر ؛ وحين لم تعد ضرباتُ الرفش تتناهي اِليّ أخذت خطوي الى القبر الذي أمسى جاهزاً، مع من كان محيطاً به، خطفت ببصري سريعاً، لم يكن مشهد الحفر مثيراً ومستفزاً لمشاعر من اعتادوا على حمل النعوش، وزيارة المقابر في الليل؛ من الاهل والاقرباء الذين صحبونا الى المقبرة الصغيرة، لدفن سميِّ؛ حفيدي الأصغر، قبل ثلاث ليال، لكنه كان مفزعاً لي، ولأنني لا أحتمل رؤية مشهدٍ غير تقليدي، مثل إيداع التراب كائناً جميلاً، بشعر أحمرَ، وبوجنتين ورديتين؛ خلق ليكون طفلاً أبدياًّ فقد أخذتُ خطوي، بعيداً في سكةٍ ضيقةٍ؛ تحيطها قبورُ صغيرة، هو جزءٌ من هروب أو تعلة وتعزية خفيّةٍ. طال مشهدُ فتح الكفن من جهة الخدِّ اللين الذابل، ووضع الحجارة تحته؛ ومن ثم الدفن وهيلُ التراب، وظلَّ أحدهم يتلو في قرطاس عنده مما أكره سماعه .. ولنفوري الشديد من هذا وذاك؛ فقد أطلتُ خطاي في السكّة الضيقة تلك، باحثاً عمّا يتوازن في نفسي، ويعيدُ تسمية الأشياء في الداخل العميق، الذي لم يعد يستقيم في الوعي والانتباهة.
كلُّ القبور هنا صغيرة ومبتسرة، أو هي مقتطعة في المكان، وربما في الزمان أيضاً، يزاحم أحدُها الآخر، والشواهد التي عليها أصغر مما يجب، هكذا في فعل يوحي بأنَّ الأطفال الموتى يوسعون لبعضهم، ويتفسحون في مجالسهم، على خلاف تزاحمهم في اللعب أمام البيوت، والحدائق العامة، وفي المدرسة، وكمن أخذته سورةٌ من الوجد والحزن معاً؛ كنت أسمعُ همس ملائكة صغار وأبصر رفيف فراشاتٍ، واجنحة عصافير ملونة، وبتلات ورد حمر وبرتقالية تطير هنا وتحط هناك، بعضها يأتي عن مرح وكثير منها عن صخب وشجار؛ عبر حروف وكلمات لم تكتمل بعد، ولغة تعطلت في الزمان، لكنها ألطف وأرق من لغة الملقن التي مازال يتلوها على حفيدي ذي السنتين، بشعره الأحمر الطويل وبوجنتيه الورديتين، وهو يودعه الحفرة اليابسة من الأرض، في المقبرة التي ستكرر خطوات والديه اليها كثيراً.