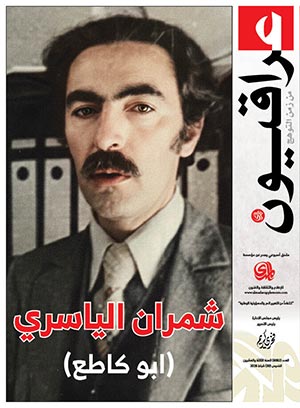عبد الكريم البليخ
ليلةُ الاحتفاء في دبي بدت كأنّها فصلٌ مُنفصلٌ من كتابٍ طويلٍ عنوانه "الاعتراف المتأخِّر". فمنذ اللحظة التي ارتفع فيها اسم فخري كريم عبر نظام الصوت في قاعة "قمة الإعلام العربي" أواخر مايو 2025، تهلّلت الأيدي بالتصفيق لا للشخص وحده، بل للإرث الذي سبق خطاه إلى المنصّة. كانت القاعةُ أشبه بمدرجٍ رومانيٍّ يعرف أنّه يُصفِّق للتاريخ قبل أن يصفِّق للبشر، وأنّه يكرِّم صمت الحبرِ المتمرّد قبل أن يكرِّم صاحبَ الحبر. هناك، تحت أضواءٍ تتدلّى مثل كواكب مُنمنَمة من سقفٍ زجاجيٍّ شاهق، بدا الثمانيني وهو يمشي بكتفين مستقيمين، كأنّ سنواته الطويلة انكمشت حتى غدت خفيفةً مثل ريشة.
تقول الأسطورة إنّ من يسكنه شغف الكتابة يحتفظ دائما بقلمٍ في جيبه؛ ورغم مرور نصف قرنٍ على ضياع أوّل قلمٍ من جيوبه، ظلّ فخري كريم يتحسّس مكانه كما لو أنّه سرٌّ صغير يضمن للطريق إيقاعا.
وُلد الصحافي فخري كريم في البصرة عام 1942، على ضفاف شطّ العرب الذي كان، آنذاك، يتنفسُ الملحَ والحكايات البحرية في آنٍ واحد. البصرة ليست مدينةً فحسب؛ إنّها عُنوانٌ رمزيٌّ لافتتان الشرق بالبحر المفتوح، وللوعد الذي لا يكتمِل إلا حين يمتزج عنقودُ نخيلٍ بصفير سفينةٍ بعيدة. هناك، في الأزقّة التي كانت رياحُ الخليج تدغدغُ شبابيكها الخشبيّة، تنشّق الفتى أوّل رائحةٍ للحبر فاختلطت بأنفاس نهرٍ لا يهدأ، فتعلّم أنّ الكلمة يمكن أن تجري كالماء، وأن تختبئ في الأغصان مثل عصفور. وما إن بلغ السابعة عشرة حتّى فاجأ الجميع بانضمامه إلى نقابة الصحافيّين العراقيّين، ليكون أصغرَ عضوٍ تحت جناح الجواهري الكبير؛ لحظةٌ ساوت بين نضارة الشباب ووقار القصائد التي تحرّك جيوشاً بلا سلاح.
منذ "طريق الشعب" في سبعينات بغداد، مرورا بـ"الفكر الجديد" ثم مطابع بيروت ودمشق، فهم كريم الصحافة على أنّها قدرٌ لا حرفة؛ قدرٌ يضع على كتفه حقيبةً من ورقٍ لا تتعب إلّا لتُنقِّب عن المعنى. لم يكن يعرف أنّ الطريق ذاته، بعثر له فخاخاً متلاحقة: اعتقالاتٌ متكررة، ومحاولتا اغتيالٍ في بيروت 1982، وثالثةٌ في بغداد بعد انهيار التمثال 2003، ورابعةٌ في بغداد 2024. كأنّ الرصاصَ شعرَ بالغيرة من الكلمات، فأراد أن يختبر هشاشتها؛ غير أنّ الحبر، على الدوام، كان يثبت أنّ رائحته أشدّ من بارود الحروب، وأنّ الحروف -حين تتوحّد- تستطيع أن تزرع ساقيةً في صخور الصحراء.
حين أسَّس "دار المدى" في دمشق عام 1994، كانت الجغرافيا تتبدَّل في أعماقه. فهذه الدار لم تُبْنَ كدار نشرٍ وحسب، بل كمدينةٍ مصغّرةٍ بأسوارٍ من نصوصٍ لا تحصى، تُقيم مهرجاناتها مثل أعراسٍ دائمة، وتُشيِّد جسوراً بين العربيّ والكرديّ، بين اليسار والإسلام المعتدل، بين الحداثيّ ورمزيّات السرد القديم. توسَّعت المدى من كتابٍ إلى صحيفة، من مهرجانٍ إلى صندوقٍ ثقافيٍّ منحَ خمسمئة مبدعٍ مساحةً كانوا يتحسَّسونها بأطراف أصابعهم. هكذا بدا المشروعُ أشبه بجغرافيا ثانية، لا تقلُّ رسوخاً عن خرائط الأرض، قوامها الأسئلة: كيف يمكن للكلمة أن تصير وطناً؟ وكيف يمكن للمطبعة أن تصبح معبداً مدنيّاً يدخله الجميع بلا استئذان؟
ولمّا عاد إلى بغداد بعد 2003 بدا المشهد مثل حيلةٍ قدريةٍ اكتمل دورانها: رجلٌ خرج متخفّياً أواخر السبعينات، عائداً الآن بصفته شاهداً على انهيار دكتاتوريةٍ أسست حائطاً إسمنتياً بين المواطن وحقّه في "لا" بسيطة. أطلق صحيفة "المدى" اليومية بشعارٍ مُقتَضَب: "أن نكتب الحقيقة كما هي، لا كما تُراد." قليلٌ من الشعارات -في عالم تتكاثر فيه عناوين لاجئة- ينجح في الترسّخ مثل بذرةٍ في أرض قاسية؛ لكنّ هذا الشعار بالذات افترض أنّ اللغة يمكن أن تتحول إلى مرآةٍ عموميةٍ يطلّ فيها الناس على أنفسهم بلا مكياج.
قُصِفت مكاتب "المدى" في سنوات المأساة المتلاحقة. كان الحبر يحترق ولوحات الصفحات تتطاير متّخذةً شكل فراشاتٍ مثقوبة الأجنحة. وأمامَ الركام، قال كريم لزوّاره يوما "الخسارة الحقيقية أن نتوقف عن الإصدار." لعلَّ تلك الجملة كانت المصل السريّ الذي أبقى المشروع حيّاً في بلدٍ يضع ثقافةً كاملةً على طاولة التشريح كل صباح. لقد أدرك أنّ الكتاب -في لحظته الأعلى- ليس ترفاً ولا تزييناً للرفوف، بل شريان إضافي في جسد مدينةٍ أنهكتها المتاريس.
في خطابه القصير بدبي، والذي اختزل ستة عقودٍ من خدمة الحبر، بدا الرجل أبعد ما يكون عن الاحتفال بنفسه. شكر الإمارات لأنّها "كرّمت العراق كلّه حين كرّمته،" ثم التفت إلى آفاق المدينة، واصفاً دبي بأنّها تمارس "ثورية عمرانية" تعجز الشعارات عن احتوائها. غيرَ أنّه سارع إلى تذكير الحضور بأنّ "الإعمار الحقيقي يبدأ من بناء الإنسان القادر على قول لا." ولعلّ تلك العبارة بدت كأنّها محاولةُ ربطٍ بين طبقات الزجاج التي تتسابق إلى السحاب، وبين طبقاتٍ أخرى من الطموح الإنسانيّ تسعى لملامسة سقفٍ أعلى: سقف الحرية.
كانت الرسالة أوسع من لحظة التكريم. أوّل عراقي يتلقّى جائزة "شخصيّة العام الإعلامية" بدا محمّلاً بدلالاتٍ تُسائلنا عن معنى الصحافة حين تُنْتَزَع من سياج الأيديولوجيا. اللجنة لم تنظر في تاريخه الحزبي إلا بقدر ما لامس أثره الإعلامي. كانت تقول، بطريقةٍ ضمنية، إنّ الزمن الذي تُقاس فيه النفوس ببطاقاتها الحزبية قد مضى، وإنّ الاختبار الماثل للعيان هو ما تتركه الحروف في مسام الذاكرة العامّة. الصحافة، إذاً، هي البصمة التي تُجيد التسرّب إلى اليوميّ والمألوف، فتقترح رؤيةً ثانية للعالم.
ثلاث صفات يندر أن تجتمع في ناشرٍ واحدٍ اجتمعت فيه: عِناد الحرف، إذ كان يُعيد النصَّ حتى يُرهِق محرِّريه قبل أن يتعب هو؛ هَوَس التفاصيل، إلى درجة أنّه قد يطلب إعادة تصميم غلافٍ كاملٍ لأنّ لوناً لم يطابق رائحة الورق؛ وشغفُ التعلّم، الذي جعله يغيّر قناعاته كلّما اصطدمت بمعمل الواقع. هذه الصفات جعلت "المدى" مشروعاً مفتوحاً على احتمالات التمدّد والانكماش بحسب معيارٍ وحيد: المنسوب الأخلاقيّ للحرف. حين حاول المالُ السياسي ابتلاع شاشة "المدى" التلفزيونية، لم يتردّد لحظةً في إطفائها، مؤثراً الخسارة الماديّة على خسارة المعنى.
وقد يكون أجمل ما في التكريم أنّه جاء متأخرا بالقدر الكافي ليبدو شهادة صمودٍ لا شهادة ولادة. فالتاريخ يميل إلى الاعتذار أحياناً، لكنّه لا يفعل ذلك إلا بعد أن يختبر قدرة ضحاياه على الوقوف. وهنا، تحديداً، يكتسب التكريم معنىً مضاعفاً: إنّه اعترافٌ بأنّ "الثقافة كثورة ناعمة" ليست أقلَّ فتكاً من دبابةٍ ولا من سياسةٍ تتحصَّن خلف الخنادق. فالكتاب الذي يُطبع اليوم قد يصير، غداً، شارةً في ذاكرة جيلٍ كامل، ومعياراً يُقاس به مدى جدية الأمم في إخضاع الدم للسؤال.
في مشهدٍ يبدو خارج قوانين الجاذبية، ارتفع نُصْبُ دبي أعلى من سُحُبها، بينما ظلّ فخري كريم ثابتاً على أرضٍ حلمها من ورق. قال لأحد مرافقيه همسا "كلّ ما تحتاجُه الأوطان ناطحة سحاب واحدة… من الورق." فالكلمة، في اعتقاده، لا تكتفي بأن تكون مأوى، بل يتعيّن عليها أن تتجاوز سقفَ البيت لتصبح سقفاً أخلاقياً يُظلِّل الشارع. لعلّ تلك النبرة تضفي على الصحافة بُعداً معماريّاً: هي هندسةُ الفراغ بين السؤال والجواب، وعمارةٌ قَلِقةٌ تسعى إلى إعادة ترتيب الفراغ بحيث يتّسِع لكرامة المواطن.
ولئن كانت الحروب تعلِّم البشر طريقةَ الانتباه إلى صوت الرصاص، فإنّ المنفى يُعلّمهم فنَّ الإصغاء إلى صدى أرواحهم. هكذا حوَّل كريم هجرته الإجبارية إلى مختبرٍ للشكِّ الإيجابيّ: ذلك الشكّ الذي يُعيد اختبار حدود الانتماء، ويفتح، في جدار الهويّة، نوافذ تسمح بدخول نسيمٍ من الضفاف الأخرى. في بيروت الثمانينات كان ينام على وقع القذائف، لكنّه يستيقظ ليسأل "كيف يمكن للصحيفة أن تخلق نهاراً جديداً في مدينةٍ اعتادت لياليَ الإسمنت؟" وفي دمشق التسعينات كان يمشي بين غوطتين خافتتين ليستكشف علاقة الشجرة بالقصيدة، وعلاقة الحجر بالقصيدة المضادّة.
ها هو اليوم، بعد ستّين عاما من الصعود والنزول على الدرج الحلزونيّ للمطابع، يُسلِّم الشعلة لجيلٍ ينمو بين شاشتين: شاشة هاتفٍ لا يَلْمحُ فيها سوى عناوين قصيرةٍ تنهش انتباهَه، وشاشة واقعٍ يزداد تعقيداً كلّ يوم. يُحذِّر هؤلاء من فتنة السرعة: "مستقبل الصحافة لا يُكتب بالمنشورات الطائرة، بل بإصرارٍ طويل النفس يَزِن الكلمة بميزان الضمير قبل ميزان السوق." ولعله يعلم أنّ الورق سينحسر لصالح الضوء، لكنّه يؤمن أيضاً بأنّ جوهر الحكاية سيبقى: حبرٌ أو بيكسلٌ، لا فرق، ما دام هناك من يصرّ على طرح السؤال الصعب بلا خوفٍ ولا منّة.
وفي ما يشبه اللحظة السينمائية الختامية، تنعكس في واجهات الأبراج الشاهقة صورةُ رجلٍ يحمل ذاكرة بلادٍ تتقاطع فيها الأنهر والألغام. المنفى، الاغتيال، القصف، الجائزة.. كلّها لُقىً متناثرة في صندوقٍ واحدٍ اسمه "المسيرة". لكنّ الصندوق يظلّ مفتوحاً، لأنّ صاحبه اختار أن يَترك الغطاء مائلاً قليلاً، بحيث تتسرّب منه رائحةُ الورق لأقصى ما يمكن أن تبلغه الريح. وفي البصرة، حيث ما زال شطُّ العرب يبتلع الزُّرقة ويعيد إفرازها حكاياتٍ بحريّة، سيكبر صبيٌّ آخرُ يلتقط حبراً من أثر حبرٍ، فيصنع من جمرةٍ صغيرةٍ شعلةً ليستمرَّ الحرفُ في حفر مجراه.
إذًا، تكريم فخري كريم ليس مجرّد ميداليةٍ تُعلَّق في صالةٍ أنيقة، بل هو علامةُ فاصلةٍ في تاريخٍ إقليميٍّ طويلا ما نَظر إلى الصحافة كوظيفةٍ لاحقةٍ للمخاوف الأمنية. إنّه إشارةُ مرورٍ تسمح للقافلة بأن تعبر من عصر الرقابة الخشنة إلى عصرٍ قد يصير أرحب إذا امتلك الجرأة على مصالحة مرآته. بهذا المعنى، يُمكن للناظر أن يرى في الجائزة اعتذارا متأخّرا من مرحلةٍ همّشت الحرف تحت حذاء الشعارات، واعترافاً مُستقبليّاً بأنّ البناء يبدأ من لفظة "لا" تُزرع في صدر طفلٍ وهو يتهجّى أوّل حروف اسمه.
على هذه السيرة تتنقّل الحكاية من ضفاف البصرة إلى أرصفة دمشق، ومن أحياء بيروت المربكة إلى شوارع بغداد التي تتدرّب على الأمل، وصولاً إلى حوافّ الخليج حيث تعكس مرايا الأبراج وجوهاً تبحث عن شرفةٍ تطلّ على غدٍ أقلَّ وحشة. هناك، في الطابق الأعلى من الذاكرة، يكتب فخري كريم بخطٍّ صغيرٍ كوصيّة: "لا تطفئوا آخر مصباحٍ في غرفة الحبر." وفي الغرف الكثيرة التي تركها مفتوحةً خلفه، تتردّد أصداء هذه الوصيّة كقرعٍ خفيفٍ على بابٍ خشبيٍّ قديم؛ بابٍ يُغري الزائر بالدخول إلى ما يشبه مدينةً من الورق، حيث يمكن للأمم -إذا شاءت- أن تعيد ترتيب خرائطها بالممحاة قبل القلم، ثم تنقش أسماءها الجديدة على بلاطٍ أكثر رحابة.
وهكذا تكتمل دائرةٌ عاشها ليمنحها الآن للأجيال القادمة: دائرةُ الإيمان بأنّ الصحافة، في لحظتها الأنقى، هي فنُّ بناءِ المعنى وسط ضجيج العالم، وأنّ المدن لا تكبر حقّاً بالطول الذي تعانق به السحب، بل بقدرتها على إنجاب حبرٍ جديدٍ لا يخاف من الفضاء المفتوح.
عن صحيفة العرب