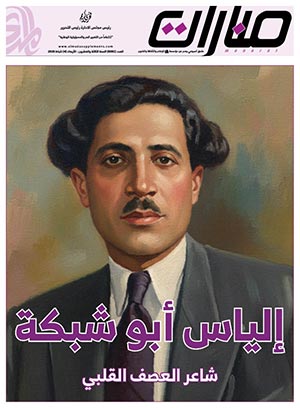طالب عبد العزيز
أهربُ الى السينما؛ الى أفلام ريتشارد كير وجولي روبتس ميريل ستريب ودانيال دي لويس وانتوني هوبكنز وأنجيلا جولي وسواهم كلما ضاقت الدنيا علي، وأطبقت بدوامتها التي تلاحقني في أمكنة كثيرة، ليس أقلها العائلة الكبيرة؛ ولا أكثرها الواقع السياسي والاجتماعي والديني، هناك ضيق في صدري، يشبه الألم، أو هو ألم من نوع آخر، أرجو أن لا يكون عارضاً صحياً في القلب، اتحسسه كلما سمعت خبراً سيئاً، وإن أقلَّ سوءاً، أو عرضت أزمة لا سبيل الى حلها، ليست كلُّ الازمات شخصية، فأنا موجوع بأزمات البلاد ايضاً، وأذهب بآلامي وأوجاعي الى غزة ولبنان وايران وأوكرانيا وفنزويلا ايضاً، هكذا والله، حتى أنني أرددُ دائماً ما كتبه الشاعر الروسي سيرجي يسينن لأمه:" مبكراً حكم عليَّ بأشغال الاحاسيس الشاقة".
نحن نمتهن الحياة بشيئ من الخطأ، أو نحن مرضى العيش، وهناك تدرجات لا تعقل في تسرب المرض الينا ومثلها في التعافي منه، وحين يقتفي أحدنا مسيرة حياته سيعثر على الخطأ ذاك. أنْ تولد وتأكل وتعي وتسكن وتتزوج وتعمل وتكون .. فهذا ما يشترك الانسان فيه مع قرينه في مكان آخر، إذْ أنَّ(مهنة العيش) بتعبير بافيزي، الذي فشل في حرفة الحياة، لا تعني المفاصل التي أوردناها، فهذه مشتركات بين المخلوقات الفقرية كافة، بما فيها نحن. نحن نخفق في امتهان الحياة لا بسبب شضح في الهواء والماء والطعام والعمل والسكن إنما بسبب عدم قدرتنا على العيش داخل المشاعر والاحاسيس الإنسانية، بسبب عدم قدرتنا على المواءمة بين المادي والمثالي(الروحي) هل فكّر أحدُ السياسيين في البرلمان يوماً بحاجتنا الى السينما على سبيل المثال؟ لا بمعناها التجاري طبعاً؛ إنما بما يمكن أن تخلقه من توازن داخل النفس العراقية؛ ذات الازمات النفسية والاجتماعية والدينية الكبرى.
أن تعيش في الزمن لا يعني أنْ تذهب الى القرون التي عاشها أسلافك، إنما أن تبحث فيه عن زمن أولادك وأحفادك. ما الذي يستحصله حفيدي حين أفاضل في سيرة اثنين من أجداده؟ كأنْ أقول له بأنَّ جدّك الثالث عشر كان أطولَ من جدّك السابع عشر! وما انتفاعه بأحد أسلافه إن كان بطلاً، أحمق، لصّاً، قاتلاً، زيرَ نساء، ثرياً، معدماً.. الخ لكنَّ هذا ما يسمعه، أو يحبُّ سماعه، ليفاخر به، فهو يتنفس ريحاً لا تعينه على العيش، إنْ لم تكن مسمومةً، تفسد عليه حياته. أنا أهربُ الى السينما لأنني لا أجد في حياتي ما يمكنني من الحياة! أو لينبثق السؤال الكبير: من الذي يمكِّنني من العيش؟ هل لرجل الدين القدرة على صنع الحياة التي أريد؟ وهو يحجب عنها الغناء والمسرح والموسيقى والرسم، أم هو رجل السياسة والزعيم الحزبي الذي لا يذهب بعقله أبعد من اللجنة الاقتصادية في حزبه، أم هو رجل الاعمال، الطفيلي، المستثمر في الصحة والتعليم والرغيف، أم هو البرلماني الذي رفعته روافع الخديعة والكذب والاوهام، أم هو القائد في المليشيا الذي يرى ضالته في الدم والسلاح المنفلت وحروب الطوائف؟
بوضوح كليٍّ لم يخلق بعد الرجل (الوهم) الذي بمقدوره صوغ مادة الحياة لنا، نحن أمّة لا ترى في حياتها ما يستحق الانتباه، لأننا غارقون في الماضي، نقيس حياتنا بما كان لآبائنا وأجدادنا، نحجب درس الرسم والموسيقى والمسرح في مدارس أولادنا، ونمنع حفلات الغناء والموسيقى لا لأنها تتقاطع مع مناسبة دينية حسب، إنما لأنّها تنتشلنا من الماضي، الذي لا نريد مغادرته، ولأنها توقض فينا الامل بحياة افضل، والامل في الحياة قنبلة موقوتة عند هؤلاء (فقهاء الظلام). أحياناً؛ أذهبُ بمشاعري الى خلق مشهد خيالي، لعله مستلٌّ من معاينة ما لفيلم أختزنه، فأوهم نفسي بمشاهدة حشد من الطلاب الذاهبين الى مدارسهم وهم يحملون آلاتهم الموسيقية ولوحات الرسم وعلب الألوان، تزينهم ثياب ملونة، لا يبحثون في المعاجم عن لفظ وحشي، إنما في متصفح الانترنيت عن قطعة لشوبان طلب المعلم حفظها، أوعن لوحة ليرنوار، أو عن قصيدة تغنّى شاعرها بالطبيعة..
ما الذي يجنيه الطالب في الابتدائية من ضرب صدره في الصباح، وهو يستحضرُ مناسبة دينية، غير التشدد والعنت في معتقده، غير الكراهة لزميله المختلف، لندعه يكبر أولاً، وليستقم عوده، وليكون قادراً على الاختيار، ونأخذ بيده أولاً الى عوالم أجمل وأقل خطراً، وأكثر عافيةً، لأننا نريده للحياة، وليحياها كما هي في العقل، قبل كل شيء، ولفهم المعاني النبيلة التي خلق من أجلها.