لطفية الدليمي
ليلة الجمعة وليلة السبت على الأحد من الأسبوع الماضي عانيتُ واحدة من أسوأ ليالي حياتي. عانيت من سعالٍ جافٍ يأبى ان يتوقف لاصابتي بفايروس متحور . كنتُ مكتئبة وأشعرُ أنّ روحي تتهشّم مع كل نوبة سعالٍ، كأنّ في صدري زجاجاً يتكسّرُ ببطء ليخرج نثارُهُ الجارح مع أنفاسي اللاهثة. استعصى عليّ النوم، واضطررتُ للجلوس على الاريكة طوال الليل، أراقبُ العُتْمة وهي تتمدّدُ في غرفتي وانصت لهمهمات الصمت في تلك الساعات الثقيلة حين يفقد الزمن شكله ومعناه، مضيتُ أفكّرُ طويلاً في حياتنا: كم هي هشّة، وكم نبالغ في الإطمئنان إليها، وكم نخدع أنفسنا حين نظنُّ أن الأمور تحت السيطرة. (يانفسي كلي واشربي وتنعّمي فقد طابت أيّامك): هكذا نخاطبُ أنفسنا ولا ضيْرَ في هذا عندما يكون نتاج تعب من غير تعدّ على الآخرين؛ لكنّما الضيرُ أن نتوهّم إمكانيّة استمرارية هذا الحال حدّ أن يدفعنا لملامسة تخوم السفاهة والغطرسة.
الهشاشة لا تعلنُ عن نفسها في العادة. لا تطرقُ الباب، ولا تُصدِرُ إنذاراً مسبقاً. إنها تظهر فجأة، في لحظة عابرة: في سعالٍ لا يتوقف، أو ألمٍ طارئ، أو خبرٍ صغير يخلخلُ البنيان كله. كنتُ قبل يومين أعيشُ على نحو معتاد واقاوم الفايروس بصمت، أتحرّكُ، أفكّرُ، أخطّطُ، وأؤجل أشياء كثيرة ظنّاً مني أنّ الوقت لا يزال طوع يدي. ثم، في تلك الليلة، انقلب كلُّ شيء إلى سؤال واحد بسيط ومخيف: ماذا لو طال هذا؟ ماذا لو ساء الأمر؟ وماذا لو كنتُ وحدي تماماً؟
كنتُ جالسة وأضم صدري بذراعيّ كمن يحاول حماية ما تبقّى من قلبه وأنفاسه، وأنتظر. لا أعرف تماما ما الذي أنتظره؛ لكنني كنتُ على يقين أنّني أنتظر شيئاً واحداً على وجه التحديد: كلمة حميمة. كلمة عادية، بسيطة، لا تحمل بروتوكول علاج ولا دواءً؛ لكنها تحمل معنى. كلمة تقول لي: لستِ وحدك. كلمة تخفّفُ عني ما أعانيه، أو على الأقلّ تشاركُني ثقله.
في الثالثة بعد منتصف الليل كنتُ وحدي في هذا العالم الموهوم بالتشابك اللحظي. فكرت أن اتصل بإبنتي التي ماغادرتني الا عندما اطمأنت عليّ ذلك المساء.الهاتف قربي، والرقم محفوظ في الذاكرة كما الدُّعاء لكنني تخاذلت. خشيت أن تُصاب بهلع، أن تستيقظ مذعورة على صوتي المنهك. آثرتُ أن أتحمّل وحدي. كان هذا القرار مؤلماً على نحو خاص؛ أن يكون لك من تحبّه ويحبّك، ولا تلجأ إليه في لحظة ضعفك القصوى، فقط لأنّك تخشى عليه من لحظة الهلع المتوقّعة.
في تلك الساعات، لم يكن الألم جسدياً فحسب. كان شيئاً أعمق، أبطأ، وأكثر فتكاً. ألَمُ الشعور بأنّ وجودك نفسه قابل للتأجيل، بأنّ غيابك المحتمل لن يربك نظام العالم ولا جَدْول أحد. المرض لا يؤلمك بقدر ما يفعل هذا الإكتشاف المفاجئ: أنّك، في لحظة ضعفك القصوى، موضوعُ خارج كلّ الحسابات. كان السعال يعلو ثم يخفت، كمدٍّ وجزرٍ عنيفين، أفكّرُ كم يشبه هذا إيقاع حياتنا: نُنْهِكُ أنفسنا طوال الوقت لنبدو متماسكين، منتجين، نافعين، ثم حين نتعطل قليلاً نصبح عبئاً صامتاً. لا أحد يصرّحُ بذلك؛ لكنّ الصمت يقوله بوضوح جارح.
في تلك الليلة، شعرتُ بأنّ الجسد ينسحب من مكانته المركزية في حياتنا. فجأة، لم تعد الأفكار الكبرى مهمّة، ولا القناعات، ولا كلّ ما نظنُّ أنه يشكّلُ هويتنا. كلُّ شيء تقلّص إلى رغبة بدائية واحدة: أن يطمئنك أحدٌ بكلمة أو إثنتين لا أكثر. أن يصدّق ألمك. أن يعترف بأنك تتألّمُ حقّاً. ما أقسى اكتشافك أنّ العالم الذي يطالبك دائماً بالقوة والانتاج لا يملك اللغة المناسبة لضعفك. نحن نعيش في لجّة صاخبة تعجُّ بمفردات النجاح، والتخطيط والبرمجة والتطوير وأوهام العبقرية والغرور ؛ لكننا نفتقرّ إلى مفردات العزاء. لا نتقنُ كيف نقول: أنا هنا. لا نتدرّبُ على البقاء مع بعضنا في العتمة بل نهرب منها سريعاً إلى ضوء مصطنع يفترس انسانيتنا.
في تلك اللحظة، لم أكن أحتاج تشخيصاً طبيّاً، ولا طمأنة عقلانية. كنتُ أحتاج اعترافاً إنسانيّاً بسيطاً: أنّ ضعفي مسموحٌ به، وأنّ خوفي مفهوم ومسوّغٌ، وأنّ انهياري المؤقت لا ينتقصُ من قيمتي؛ لكنّ الكلمات، حين تأخّرت، تحولت إلى عبء إضافي، حتّى لكأنّ الصمت نفسه صار جزءاً متعشّقاً مع المرض.
تألّمتُ كثيراً لحالي؛ لكنّ ألمي لم يقف عند حدودي الشخصية. اتّسع فجأة ليشمل بني الإنسان أينما كانوا وكيفما كانوا. فكّرْتُ في أولئك الذين يمرّون بمحَن أشدّ، في حرب وحشية، في أسرّة مستشفيات، في بيوت خالية موحشة، أو في بلدان لا تمنح أبناءها حتى حقّ الشكوى. فكّرْتُ في العابرين من الألم بصمت، وفي الذين ينتظرون كلمة حميمة لا تأتيهم أبداً.
كم نحن ضعفاء حين نمرض، وكم تسقط عنّا الأقنعة سريعاً. كلُّ ما بنيناه من صورة عن القوة، والإستقلال الشخصي والمادي، والقدرة على الإحتمال، يتبخّرُ أمام ألمٍ صغير يختار لحظة خاطئة ليعلن عن كينونته الخفية. عندها نكتشف أنّ حياتنا، مهما بدتْ مؤسسة على تفاصيل تقنية ومادية، على أجهزة، وخطط، وضمانات، هي في النهاية محكومةٌ بجزئيات صغيرة جدّاً: نبرة صوت، رسالة قصيرة، يدٌ تُوضع على الكتف، أو كلمة جميلة تُقال في الوقت المناسب أو حتّى غير المناسب.
في تلك الليلة، أدركتُ أنّ القسوة الحقيقية ليست في المرض ذاته بل في العُزْلة التي يفرضها: أن تشعر بأنّك منفصلٌ عن إيقاع العالم، ولو لساعات، وأنّ كلّ ما يفصلُكَ عن الطمأنينة هو صوتٌ إنساني دافئ لم تسمعه بعد. نحن لا نحتاج دوماً إلى حلول جذرية، ولا إلى معجزات طبية. أحياناً، كلُّ ما نحتاجه هو أن يعترف أحدهم بألمنا، أن يسمّيه، أن يراه.
نحن نعيش في عالم يبالغُ في تمجيد الصّلابة النفسية والجسديّة . نتعلمُ منذ وقت مبكر أن نتماسك، أن نبتلع وجعنا، أن نواصل السير مهما كان الثمن. لا أحدَ يخبرُنا أنّ التماسك الدائم شكلٌ آخر من أشكال الإنهاك العقلي والنفسي. لا أحدَ يقول لنا إنّ الإعتراف بالهشاشة ليس ضعفاً بل شجاعة. في لحظات المرض أو المحنة القاسية، نعود إلى أصلنا الأوّل: كائنات تحتاج إلى العناية، إلى الطمأنة، إلى الحبّ غير المشروط.
كنتُ أراقب عقارب الساعة، وهي تتحرك ببطءٍ ساخر، وأفكّرُ: كم من العلاقات التي ترسخت عبر الاعوام قد تنهار لأنّنا بخلنا بقول كلمة مناسبة؟ كم من الأرواح انكسرت لأنّ أحداً إفترض أنّ الآخر قوي بما يكفي؟ نحن نهوّن كثيراً من شأن التفاصيل الصغيرة، مع أنها، في الواقع، ما يصنع الفارق النوعيّ كلّه.
حين بدأ السعال يخف قليلاً لم أشعر بانتصار حقيقي. شعرتُ فقط بإرهاق عميق، وبحزنٍ شفّاف. حزنتُ على ليلتي القاسية، وعلى ليالٍ مشابهة اعيشها ويعيشها آخرون الآن، وعلى عالمٍ صار صاخباً بالتقنيات، فقيراً بالقرب الحميمي والتواصل الواقعي ، عالم متخيل نتواصل فيه طوال الوقت؛ لكننا نادراً ما نصل حقّاً إلى بعضنا. في الصباح، حين تسلل الضوء إلى الغرفة، بدا كل شيء أقلّ تهديداً؛ لكنّ أثر الليل لبث عالقاً في النفس. ظلّ السؤال قائماً: لماذا نؤجّلُ الكلمات الجميلة؟ لماذا نعتقدُ أن من نحبّهُم يعرفون، فلا نقول؟ ولماذا ننتظر المحنة كي ندرك قيمة التفاتة محبة؟
تلك الليلة القاسية رسّخت فيّ درساً عرفته وتعاملتُ معه بأعلى أشكال الإلتزام منذ سنوات بعيدة: لا تؤجّل الكلمة الحميمة. قلها الآن. أرسلها. اكتبها. انطقْها، حتى لو بدت لك عادية أو زائدة عن الحاجة؛ ففي مكان ما، في ساعة متأخّرة من الليل، ربّما يكون هناك إنسانٌ في أقاصي العالم يجلس وحيداً، يسعل، أو يتألم، أو يخاف، وينتظر كلمة حسب… كلمة واحدة، تُعيدُ له ثقته بأنّ الحياة، رغم هشاشتها، لا تزال تستحقُّ العناء والعيش.





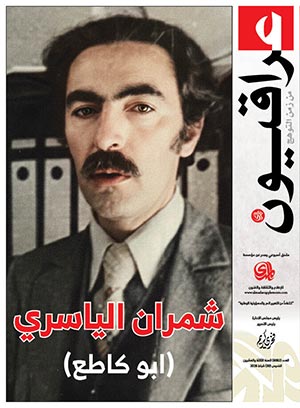





جميع التعليقات 2
د.علي محمد جواد الخطيب
منذ 2 شهور
أيتها الراقيه صاحبة القلم البديع ساكون بالنتظار مقالك كل احد لارى هل من جديد يلامس شغاف القلب واكسر وحشتي في بلدي الجريح. نحن معك مهما بعدت المسافات فتبا للغربه والوحدة اللعينه لكن لدينا رب رحمن ورحيم يؤنس وحدتنا ويكسر صمت انفسنا احتراماتي
د.عبدالرضا عبدالعزيز
منذ 2 شهور
كل المحبة والإحترام للأستاذة لطيفة. مع تمنياتي لك بالصحة والعمر المديد. أقرأ وأطالع كل مقالاتك، فهي موسوعة بحد ذاتها.