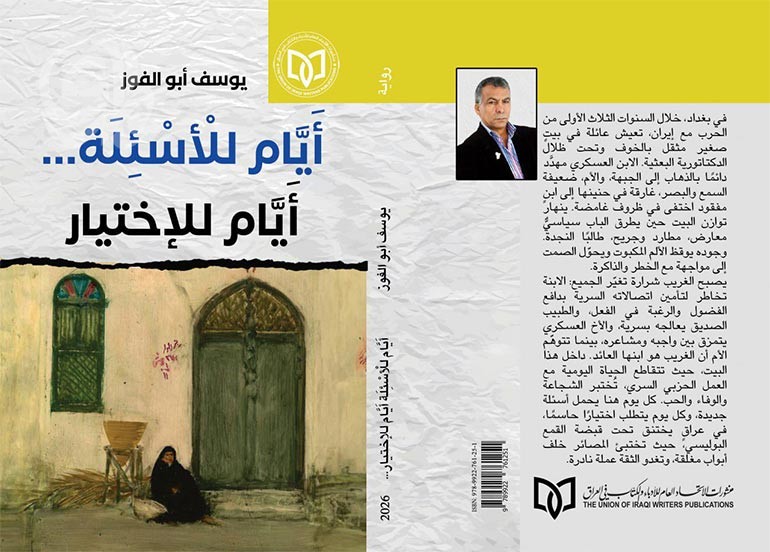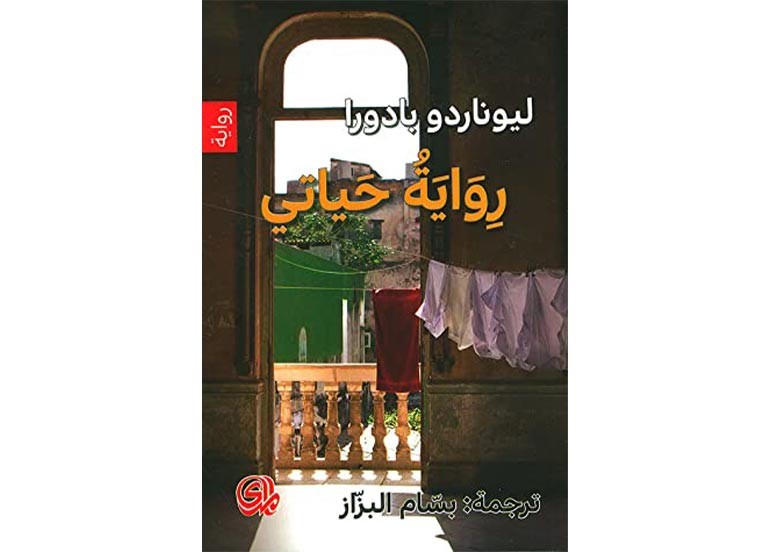لطفيّة الدليمي
ها نحنُ ثانية على مبعدة ساعات من بدءالسنة الجديدة. أهو حدثٌ كبير؟ جديد؟ يستوجبُ التهيئة المكلفة والتقاليد الإحتفائية المكرورة من سنوات؟ ما الذي يحصل كلّ سنة؟ لا شيء. يتبدّلُ وضع العدّاد ويبقى العبء نفسه. يبدو الإحتفال فعلاً ميكانيكيّاً أكثر منه شعوراً نفسياً عميقاً بسعادة حقيقية؛ كأنّ الزمن يغيّر جلده لا جوهره، وكأنّنا مرغمون على الفرح تأدية لفريضة إجتماعية لا تنبع من أعمق دواخلنا. في مثل هذه الليلة، يصبح الصمت نوعاً من البلاغة، والتفكير مقاومة خفيّة ضد الضجيج الصاخب. هذا النص لا أريده مباركة لمقدم سنة جديدة. أريده أن يُبطئ اللحظة، وأن يجعلنا نرقبُ المشهد العام بالحركة البطيئة. أريده أن يضعنا تحت مفاعيل السؤال الحاسم: ما الذي يتبقّى من الأمل حين يكون التفاؤل (أو يُراد له أن يكون) سلعة مستهلكة؟
الأمل ليس قرين التفاؤل
يبدو التفاؤل، للوهلة الأولى، فضيلة محبّبة: أن تتوقع الأفضل، أن تمنح الغد فرصة؛ لكنّه في زمننا هذا تحوّل إلى قناع، إلى ابتسامة مُدرَّبة تُخفي العطب بدل أن تواجهه. التفاؤل يطلب منك أن تُغمض عينيك قليلاً، أن تُخفّف من حدّة الواقع، أن تصدّق بأنّ المنحنى الأعوج سينعطف وحده صوب الإستقامة. أما الأملُ فشيء أكثر خشونة وأقل راحة: الأمل لا يَعِدُ، ولا يُخدّر، ولا يُجمّلُ. الأمل يقول: نعم، العالم معطوب؛ لكنّ هذا لا يعفينا من النهوض بمسؤولية محاولة إصلاح العطب أو بعضه في الأقلّ.
الأمل في سنة طيّبة ليس خطأ ذهنياً أو اعتلالاً نفسياً. ليس حالة مزاجية بقدر ما هو موقف. ليس دفعة معنوية بل انحيازٌ أخلاقي تستوجبه بعضُ ضرورة العيش.. التفاؤل (الذي كثيراً ما يكذبُ ويعدُ بمسرّات زائفة) قد يوجد في الصالات المكيّفة والخطب التحفيزية؛ أما الأمل فيسكن أماكن أقل أناقة: في العمل الصامت، في الإصرار، في القدرة على الإستمرار دون ضمانات. أظنّ هذا هو السبب الذي يجعلُ التفاؤل ينهار عند أول صدمة قاسية؛ بينما يُولد الأمل أصلاً من قلب الصدمة.
تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة
لا أحبُّ الإستعادات الآيديولوجية للعبارات ذات الوقع الرنّان للتضادات الثنائية. لا أحبّها إلّا واحدة هي عبارة غرامشي الشهيرة: "تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة»؛ إذ أرى قدرتها على تمثّل المصداقية الكاملة في عصرنا كما في العصر الذي قيلت فيه. العقل، إذا تُرِكَ وحيداً، يرى الصورة كاملة بلا رتوش: عالم يُدارُ بمنطق الربح الفاحش والقاتل، بشر يُختزلون إلى أرقام، كوكبٌ يختنق ببطء، وحروب تُبثُّ مباشرة كأنّها محتوى ترفيهي. هذا هو عالمنا المعاصر، ولا أظنّ السنة الجديدة ستكون بشيراً بتغيّر الصورة السائدة حتى ولو في أقلّ القليل ممّا يرتجى. لا شيء في هذه الصورة يدعو إلى الإطمئنان. لعلّ التشاؤم، في هذه الحالة، ليس خياراً كيفياً بل نتيجة طبيعية للفهم والتحسّب والخشية من المفاعيل القادمة أن تكون أسوأ وأشدّ وطأة ممّا كانت عليه.
الإرادة أمرٌ آخر. الإرادة لا تناقض العقل بل ترفض أن تكون أسيرته. هي تلك القدرة الغامضة على الفعل رغم إدراك السوء، وعلى الحركة رغم اليقين بالهشاشة. تفاؤل الإرادة لا يعني الثقة بالنتائج، بل الإيمان بجدوى المحاولة. هنا يلتقي الأمل مع الفعل: أن تعمل لا لأنك متيقّنٌ من النجاح بل لأنّ الفشل ليس سبباً كافياً للتوقّف.
حين كانت الأفراح أخف وزناً
لماذا كنّا نفرح أكثر في سنوات بعيدة رغم تواضع إمكانياتنا؟ سؤال يبدو نوستالجيّ الطابع؛ لكنّه في الأصل سؤال بنيوي. لم يكن الماضي فردوساً مفقوداً، ولا كانت الحياة أسهل بأيّ قياس موضوعي. الإيقاع كان أبطأ، والمسافة بين الرغبة وإشباعها أقصر لأنّ الرغبات ما كانت تتعاظم كثيراً فوق سقف توقّعاتنا وقدراتنا المادية والعقلية. لم نكن نرى كلّ شيء؛ لذلك لم نكن ضحايا مأسورين لمرجعية المقارنة اللحظية بين ما نملك وما نسعى إليه. ما ملكناه كان كافياً لإسعادنا.كانت السعادة آنذاك حدثاً شخصانياً صغيراً لا يحتاج إلى توثيق رقمي فوري: ضحكة في مقهى، رسالة ورقية، أغنيةٌ نتلهّف لسماعها في الإذاعة ونحن لا نخشى أن تعاد في اليوتيوب حتى تبهت وتضيع في بركة النسيان. لم يكن مطلوبا من الأفراح أن تكون استثنائية كي تحوز شرعية ما. اليوم، صارت السعادة مشروعاً إنتاجيّاً قابلاً للتسويق تحت مسمّى (المحتوى): يجب أن تُصوَّر، أن تُشارك، أن تحصد إعجاباً. ما لا يُرى كأنه ما كان ولم يكن ولن يكون.
بهذا المعنى، لم نفقد القدرة على الفرح بل فقدنا بساطته. صرنا نطارده في أماكن لا يسكنها، ونستوحشُ غيابه عن حياتنا اليومية. رأس السنة، الذي كان علامة عبور خفيفة في الزمن، صار اختباراً قاسياً: ماذا أنجزت؟ ماذا ربحت؟ من أصبحت ؟
عولمة مضادة للسعادات البسيطة
نحن نعيش، بلا مبالغة، عولمة مضادة للسعادات البسيطة. عولمة لا تكتفي بتوحيد الأسواق والعملات وأنماط الإستهلاك؛ بل تذهب أبعد من ذلك: توحّد تعريف السعادة نفسها، ثم تضعها بعيداً عن متناول غالبية البشر. في هذا العالم، لم تعد السعادة شيئاً يُعاش. صارت هدفاً يُطارَدُ كما الفريسة المنطلقة بسرعة الرصاصة، وكلُّ مطاردة محكومةٌ بالفشل كما تدلّنا خبرتُنا.
العولمة الجديدة لا تُعادي البؤس على نحو صريح؛ لكنّها تسخر من الإكتفاء وتحسبه قرين الفشل والمُتخاذلين في سباق العصر. تنظر بازدراء إلى الفرح المتواضع، إلى الحياة التي تكتفي بالقليل. لقمة هانئة، سقف آمن، وشريك محبّ: هذه، في منطق العولمة الجديدة، ليست قمماً إنسانية؛ بل حدود دنيا بالكاد تُذكر، ولا تستحقُّ عبء الكدح في سبيلها. ومع ذلك، ربما لم تكن السعادة يوماً أبعد من ذلك. أتساءل: هل سيقتنع أرباب العولمة الجديدة يوماً بهذه الثلاثية البسيطة: اللقمة والسقف والشريك؟
أُعيد تعريفُ النجاح بحيث صار -كما الغول- دائم التوسّع: المزيد من المال، المزيد من الحضور، المزيد من السرعة. أما الإكتفاء فصار مرادفاً للكسل أو العجز أو انعدام الطموح. هكذا تُجرَّدُ السّعادات البسيطة من شرعيّتها الأخلاقية وقيمتها المؤثّرة في الحياة، وتُقدَّمُ لنا كبديل عنها حياةٌ لا تشبع أحداً مهما علت به الرتبُ وزادت حظوظه من الملكية بكلّ ألوانها.
هذه ليست مأساة محلية، ولا تخصُّ بلداً بعينه. الفرد في أقصى الشمال يعاني من القلق الوجودي نفسه الذي يعانيه الفرد في أقصى الجنوب وإن اختلفت اللغة والعملة والأوضاع الإقتصادية. هذه بعض سيّئات العولمة الجديدة: الجميع محكومون بمنطق المقارنة، بمنصّة العرض الدائمة، وبإحساس خفي بأن ما يعيشونه وما يمتلكونه لا يكفي حتى لو كان كافياً. في هذا السياق، تصبح السعادات البسيطة أفعال مقاومة للرثاثة المعولمة: أن تُقدّر وجبة تُؤكل بطمأنينة لا على عجل. أن ترى في السقف حماية لا مجرد أصل عقاري. أن يكون الشريك ملاذاً نفسياً لا مشروعاً للمرابحة. هذه اختيارات تبدو هامشية؛ لكنها في الحقيقة إنفلاتٌ صامت من الدوران في فلك منطق عالمي لا يشبع.
خداع الزمن لنا
الزمن، في صورته المعاصرة، لم يعد مجرّد تعاقب للأيام، بل تحوّل إلى خطاب خفيّ لا ينفكُّ يخدعُنا. يوهمنا بأنّ المشكلة في قلّة الوقت، لا في الطريقة التي يُنتزَعُ بها منّا. يقول لنا إنّنا متأخرون دائماً، مسبوقون دائماً، وإنّ ما نعيشه الآن ليس سوى مرحلة عابرة تمهيداً لحياة ستبدأ لاحقاً. هكذا نؤجّل العيش بإسم الإستعداد لعيش لا أظنّه سيأتي.
نصدّقُ، على نحو شبه غريزي، أنّ الزمن يعمل لصالحنا، وأنّ الصبر وحده كفيل بتصحيح المسار. لكنّ ما يحدث فعليّاً هو العكس: الزمن، كما يُدار اليوم، يعمل ضد الإنسان. يُجزّأ، يُسرَّعُ، يُفرَّغُ من المعنى حتى يفقد قدرته على أن يكون عنصراً مؤنسناً. لا يمنحنا فرصة الإستقرار والتلذّذ باللحظة الحاضرة، بل يدفعنا دفعاً نحو التالية وكأنّما الحاضرُ خطأ يجب تجاوزه.
في حُمّى هذا الخداع، نكبر من دون أن نشعر بأنّنا عشنا. تمضي السنوات لا لأنّها ثقيلة بل لأنها متشابهة. تتراكم السنوات وتستحيلُ أعباء ثقيلة. نكتشف متأخرين أنّ الزمن لم يَسْرِق أحلامنا فقط بل أقنعَنا أنّ التخلّي عنها كان خيارنا الحر.
رأس السنة هو ذروة هذا الوهم. نقف على حافة رقم جديد ونُقنعُ أنفسنا بأنّ شيئًا جوهرياً في حياتنا سينقلب تلقائيّاً لا لشيء إلّا لأنّ عدّاد التقويم زاد واحداً في الحساب. إنّها قناعة ميتافيزيقية سفيهة أن نحمّل الزمن ما لا يفعل، ونُعفي أنفسنا، والأنظمة التي تحكمنا محلياً وعالمياً، من المساءلة.
ربما يكون الخلاص الأوّل من هذا الخداع هو استعادة الزمن إلى حجمه الإنساني: أن نراه مساحة نعيش فيها، لا سُلّماّ نرتقيه بلا نهاية مرئية في رحلة سيزيفية لا نهائية. أن نكفّ عن انتظار اللحظة المثالية، ونعترف بأنّ الحياة لا تُعاش لاحقاً، بل الآن، أو لا تُعاش أبداً.
رأس السنة كمرآة لا كبداية
في هذا السياق، تفقد ليلة رأس السنة براءتها. لم تَعُدْ بداية، بل مرآة. هي مرآة تعكس ما نؤجّله طوال العام: أسئلتنا المؤجلة، تعبُنا المتراكم، خوفنا المَرَضيُّ من الزمن. نحتفل لا لأنّنا سعداء بل لأنّ التوقّف عن الإحتفال يبدو كاعتراف بالفشل. لكن ماذا لو تعاملنا مع هذه الليلة بوصفها لحظة وعي لا لحظة وَعْد؟ ماذا لو سمحنا لأنفسنا أن نعترف بأننا مُتْعَبون، وأنّ العالم يوهمنا بإطمئنان مخادع، وأنّ التفاؤل الجاهز لا يُقنعُنا؟ هنا بالضبط يبدأ الأمل الحقيقي.
الأمل كعناد أخلاقي
قلت في بعض ما سبق أنّ الامل بعام طيّب ليس خطأ بل ضرورة مطلقة. الأمل، في صيغته الأصدق، هو عناد أخلاقي وليس إنعكاساً نفسياً لقدراتنا الخبيئة. هو عناد ضد الرداءة، ضدّ التكرار، ضدّ الإنسحاب الكامل. ليس بطولياً ولا صخّاباً، بل يوميّ، متواضع، يشبه التنفّس. أن تكتب رغم شعورك بأنّ الكلمات تُهزَمُ. أن تحب رغم هشاشة العلاقات. أن تُصرّ على معنى حقيقي، محلّي أو على نطاق عالمي، في عالم معولم ضد المعنى.
الأمل لا ينقذك لكنه يمنعك من الذوبان في الرثاثة. لا يَعِدك بعام سعيد لكنه يتيح لك عاماً أقل خضوعاً، وأقل تصديقًا للوهم، وأكثر وفاءً للأسئلة.
في ليلة راس السنة: أمنية شخصية
في ليلة رأس السنة، ومع انتصاف الليل، أظنّني سأكون لائذة بفراشي لأنّني لم أعد أقوى على السهر الطويل. اتوق كثيراً لأن أمرّر رسالة صغيرة حينها لكلّ أصدقائي، ولمن أحبّ، بأن يعيشوا سنة سعيدة من غير أوهام مضلّلة. ها أنا أستبق الأمر منذ الآن وأقول للجميع بعبارة تقليدية شائعة لكنّها تفي بالغرض: سنة سعيدة، وكلّ عام وأنتم بخير. لقمة هانئة وسقف بسيط وشريك محبّ هو أعظم ما أحبّه لكم.
مع تباشير العام الجديد عولمة مضادة للسعادات الصغيرة

نشر في: 31 ديسمبر, 2025: 12:16 ص