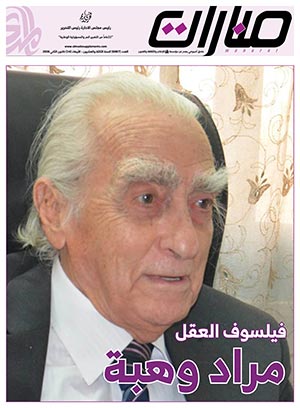سعد سلوم
(1-2)
في عام 2006، وضمن مراسلات نشرتها مؤسسة MICT الألمانية، كنتُ أخوض سجالا فكريا مع الصحفي السوري "كمي الملحم" حول ارتدادات الزلزال العراقي المتوقعة على سوريا. كان هاجسه الأكبر حينها هو تجنب سيناريو الفوضى في أعقاب سقوط الدكتاتورية. ومع اندلاع الحراك السوري عام 2011، تجدد النقاش مع السياسي السوري "بسام القوتلي"، الذي كان يراقب بدقة استخدامي لمصطلحات مثل "المكوناتية"، و"مقاولي الهويات"، و"البزنس الطائفي". وبالنسبة له، كانت المواطنة هي الملاذ الأخير وأساس أي عقد اجتماعي جديد، بينما ظل النموذج العراقي في نظره "خطيئة كبرى" يجب على السوريين تحاشيها.
اليوم، وبعد كل هذه السنوات، أجد أن المثال العراقي لا يزال يفرض نفسه بقوة، إذ تواجه سوريا مأزقا بنيويا تجاوزت خطورته أنصاف الحلول. فالتنوع الديني والقومي، الذي كان يوما ثراء مجتمعيا، استحال بفعل عقود الاستبداد وسنوات الحرب إلى "لغم موقوت" يهدد كل مساعي الإصلاح. وفي ظل هذا المشهد المربك، يطل "النموذج العراقي" برأسه كخيار جدلي: فهل يمكن لمأسسة المكونات، تلك التجربة التي سعت لنقل التعدد من خانة التهديد إلى قاعدة لإدارة الدولة، أن تكون هي "الدواء المرّ" للجرح السوري النازف؟
وفي خضم هذا البحث المحموم عن مخرج، تنقسم الرؤى السورية إلى ثلاثة تيارات فكرية تخوض اشتباكاً نظريا وواقعيا حول جدوى محاكاة النموذج العراقي، ومدى ملاءمته للخصوصية السورية:
1.ترفض المدرسة التحذيرية "عرقنة" سوريا، حيث تصف هذا المسار بـ "الفخ المكوناتي". يرى أنصارها أن المحاصصة ليست سوى متاهة تنتهي بتبديد الدولة، فهي تمنح النخب الطائفية "صكاً شرعياً" للمتاجرة بالهويات الفرعية، مما يؤدي بالضرورة إلى إجهاض أي مشروع لبناء هوية وطنية جامعة، ويحول المواطن من فرد حر إلى مجرد رقم في حصة طائفة.
2.تنظر المدرسة الواقعية (الوقائية) إلى النموذج العراقي بوصفه "شراً لا بد منه"، قد يحمي الجغرافيا السورية من التفتت التام. ففي ظل إقليم مضطرب ومطامع خارجية متربصة، يغدو نظام تمثيل المكونات صمام أمان يمنح الجميع مقعداً على طاولة القرار، ويقطع الطريق أمام أي فئة للاستقواء بالخارج انتزاعاً لحقوقها، محولاً الصراع من الميدان المسلح إلى أروقة المحاصصة السياسية.
3.تصر المدرسة المثالية (نضالية المواطنة) على أن النضال من أجل نظام مدني عابر للولاءات الضيقة هو السبيل الوحيد للاستدامة التاريخية، حتى وإن بدا هذا المسعى طوباويا في زمن تتحدث فيه الرصاصات بلهجات طائفية وقومية حادة.
إن هذا الصدام بين الرؤى يضعنا أمام السؤال الوجودي الأكبر: هل الأولوية اليوم هي لشراء استقرار هش ومؤقت عبر "عقد المكونات"، أم للمغامرة بإرساء عدالة صلبة ومستدامة عبر "عقد المواطنة"؟
ينطلق التيار المحذر من المكوناتية من قراءة نقدية صارمة، ترى في النموذج العراقي مأسسة للانقسام، حيث تتحول التعددية من حالة مجتمعية مرنة وتلقائية إلى هيكلية سياسية صلبة يصعب الفكاك منها. ويرى هذا الاتجاه أن استيراد تجربة المحاصصة إلى الواقع السوري يمثل فخا سيؤدي حتما إلى تفتيت ما تبقى من الهوية الوطنية الجامعة. فالمحاصصة، في جوهرها، تعيد صياغة وعي الفرد قسرا، إذ يجد المواطن نفسه مضطرا لتعريف ذاته عبر بوابته الطائفية أو العرقية كشرط وحيد لانتزاع حقوقه، مما يحيل الدولة من كيان معنوي جامع إلى مجرد ساحة صراع أو غنيمة تتقاسمها القوى، وهو ما يضعف الانتماء الوطني لصالح ولاءات فرعية عابرة للحدود وقبلية في جوهرها.
وعلى المستوى الإجرائي، يحلل هذا الرأي النموذج العراقي بوصفه البيئة المثالية لإنتاج "فساد النخب الممنهج"، ففي ظل تقاسم المؤسسات كإقطاعيات سياسية، تغيب المحاسبة وتتحول "المظلومية الطائفية" إلى درع حصين يحمي الفاسدين، حيث يُصوّر كل إجراء قانوني ضد مسؤول ما على أنه استهداف للمكون. هذا العجز الوظيفي يتفاقم لينتج انسداداً سياسياً مزمنا، يحول أي تباين في وجهات النظر إلى أزمة وجودية تستدعي التدخل الخارجي، وتجعل الدولة رهينة لـ "ديكتاتورية المكونات" التي تملك حق النقض (الفيتو) على أي قرار وطني سيادي.
أما عند إسقاط هذا النموذج سوريّاً، فإن المخاطر تتجاوز التعثر السياسي لتصل إلى تقويض الدولة عبر تطييف المؤسسات السيادية كالجيش والقضاء، مما يهدد بتحويل القضاء إلى أداة للانتقام السياسي، والجيش إلى كانتونات مسلحة ببدلات رسمية، لتنتهي سوريا في المحصلة كـ "خارطة طوائف" تفتقر إلى قلب وطني نابض.
على الطرف الآخر، ترى مدرسة الواقعية الوقائية بناء على قراءة لتاريخ سوريا، أن سياسات إنكار التعددية ومحاولات صهر الجميع في قالب واحد كانت المحرك الرئيسي لانفجار عام 2011، ولذلك يعتبر أصحاب هذا الرأي أن الاعتراف بالهويات المختلفة في الدستور يمثل صمام أمان استراتيجي، والحل الوحيد الممكن لمنع تقسيم البلاد أو بقائها في حالة حرب دائمة. وتقوم رؤيتهم على فكرة أن منح كل مكون حصة واضحة في الدولة يحمي سوريا من التدخل الخارجي، عبر سحب البساط من تحت القوى التي تستغل المظلوميات للتدخل في الشؤون الوطنية، مما يحول المكونات من ثغرات أمنية إلى شركاء في حماية الاستقرار، فضلا عن أن هذا التوزيع يضمن عدم عودة الدكتاتورية وسلطة المركز المطلقة التي تسيطر على كل شيء. ومع ذلك، يدرك هؤلاء أن سوريا تختلف عن العراق في تداخل سكانها الشديد، فهي "فسيفساء" ملتحمة لا يمكن فصلها بسهولة، لذا يحذرون من أن المحاصصة الجامدة قد تؤدي إلى فرز سكاني قسري، ويقترحون بدلا منها "نسخة سورية مطورة" تزاوج بين إدارة المناطق ذاتياً عبر اللامركزية، وبين وجود ضمانات سياسية قوية في العاصمة، لضمان التعايش ومنع تحول الخلافات السياسية إلى صراعات مسلحة على الحدود الإدارية.
وبين استبداد المركزية وفوضى المكونات، رفض التيار الثالث الاستسلام لواقع الانقسامات الطائفية، متمسكا بـ الدولة المدنية كإطار وحيد قادر على استيعاب السوريين جميعا دون تصنيفات مسبقة. ويرى أصحابه أن القبول بالنموذج العراقي يمثل هزيمة فكرية وتخلياً عن حلم الدولة الحديثة، مؤكدين أن المواطنة ليست مجرد مثالية حالمة بل هي ضرورة للاستقرار، لأن أي حل لا يعترف بالفرد كقيمة أساسية سيبقى حلا مؤقتا محكوماً بالانفجار. إن المواطنة في نظرهم بناء تراكمي ينضج من خلال هندسة اجتماعية تبدأ باستقلال القضاء، ومروراً بنظام تعليمي يفكك الصور النمطية، وصولاً إلى مؤسسات شفافة قادرة على صهر العصبيات تدريجياً لصالح الهوية الوطنية. وفي مواجهة المخاوف من سيطرة الأغلبية، يقترح هذا التيار آليات حماية ليبرالية صارمة تضمن حقوق الأقليات بوصفها حقوق إنسان أصيلة تصونها محكمة دستورية عليا، وليست منحة تُعطى لمكون. وفي الختام، يظل الرهان على المواطنة هو المسار الوحيد الذي يحمي كرامة السوريين، فالتمسك بالمكونات هو ارتهان للماضي وجراحه، أما الاستثمار في المواطنة فهو بناء لمستقبل لا تكون فيه الهوية سبباً للتهميش أو القتل.
إن هذا الاشتباك بين المدارس الثلاث يعكس في جوهره صراعا أعمق حول فلسفة الشرعية وشكل الاستقرار الذي ننشده لسوريا، فبينما ارتهن النموذج السوري التقليدي لشرعية المركزية القوية التي فرضت استقرارا قسريا بالأدوات الأمنية، نجد أن نموذج المحاصصة العراقي نقل الشرعية إلى "المكون"، محققاً استقراراً يشبه توازن الرعب الذي يضمن الحصص ويمنع التمرد، لكنه يشرع الأبواب أمام التبعية للخارج. وفي المقابل، يبرز نموذج المواطنة كبديل جذري ينقل الشرعية إلى الفرد، راهناً الاستقرار بسيادة القانون والتلاحم الوطني العابر للهويات، وهو ما يؤدي نظريا إلى تحصين سيادة الدولة وتقليل التدخلات الخارجية.
وعند فحص نتائج هذه الخيارات، تبرز مفارقة حادة، فالنموذج المركزي الذي كان يخشى التدخل الخارجي انتهى به الأمر مرتهنا لاتفاقات دولية لحماية بقائه، ونموذج المحاصصة الذي جاء ليطمئن الأقليات انتهى به المطاف بإنتاج دولة رخوة يسهل اختراقها. أما نموذج المواطنة، فرغم كونه الأكثر استدامة وقوة، إلا أنه يصطدم بمعضلة التطبيق في واقع مرير، حيث يفتقر إلى الأدوات والمؤسسات التي تطمئن المكونات من هواجس تغول الأغلبية، مما يجعل الحلم بالدولة المدنية يواجه تحديات الواقع المأزوم الذي خلفته سنوات الحرب والاستقطاب.
أمام انسداد الأفق في سوريا، تبرز الحاجة إلى طريق ثالث يرفض تجاهل التنوع المكوناتي، وفي الوقت نفسه يرفض تحويله إلى نظام محاصصة جامد. إننا بحاجة إلى ما يمكن تسميته بـ "شراكة المواطنة المطمئنة"، وهو مصطلح يربط مباشرة بين الهوية والأمن. فالمشكلة في سوريا لا تكمن في مبدأ المواطنة، بل في خوف المكونات من بعضها أو من تغوّل الدولة. وحين تتحول المواطنة إلى أداة طمأنة، يزول الدافع للتمرد أو الاحتماء بالخارج، لتصبح الهويات الفردية والجماعية جسوراً تدعم الدولة بدلاً من أن تكون عوائق أمامها.
يرتكز هذا الطريق الثالث، الذي يمثل الجسر المفقود بين واقعية النموذج العراقي ومثالية مفهوم المواطنة، على ثلاث ركائز بنيوية تعيد تعريف العقد الاجتماعي السوري، حيث تبدأ أولى هذه الركائز بمأسسة التنوع من خلال الاعتراف القانوني الصريح بالتنوع السوري كحق ثقافي وديني وتاريخي أصيل، دون أن يتحول هذا الانتماء إلى إقطاعية سياسية أو شرطا إقصائيا لتولي المناصب، لتصبح الهوية بذلك حقاً يُصان دستورياً للأفراد والجماعات بدلا من كونها امتيازا سلطوياً يُستغل للمحاصصة. وتأتي اللامركزية كركيزة ثانية لفك الاشتباك عبر تبني نظام إداري ومالي واسع يمنح المناطق استقلالية في إدارة شؤونها التنموية واليومية، وهو إجراء يقلل في واقع سوريا المتسم بـ "فسيفساء ملتحمة" من حدة التنافس الطائفي المحموم على "المركز"، ويجعل الإدارة أقرب لاحتياجات المواطن بعيداً عن صراعات الهوية، دون السقوط في فخ التقسيم أو الفرز السكاني القسري. أما الركيزة الثالثة فتتمثل في فصل الهوية عن السيادة عبر بناء مؤسسات سيادية، كالجيش والقضاء، تقوم حصرا على معيار الكفاءة الفردية، مع استحداث غرفة ثانية في البرلمان (مجلس شيوخ) تمثل المكونات بعدالة. وتكمن عبقرية هذا المسار في منح هذا المجلس حق "النقض" في القضايا الوجودية والثقافية فقط، ليكون بمثابة الضمانة الوطنية التي تحمي التنوع المحلي، مما يوفر للأقليات "الأمان التوافقي" المنشود دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل فعالية الدولة أو ترهل مؤسساتها.
في النهاية، يبدو أن هذا المسار هو الإجابة التي كانت تبحث عنها حواراتي القديمة، فهو يتبنى هاجس "كمي الملحم" في حماية سوريا من الفوضى، ويحقق حلم "بسام القوتلي" في دولة المواطنة العادلة. إنه الرهان على مستقبل لا تُلغى فيه الهويات، بل تتحول من خنادق للمواجهة إلى لبنات في جدار عقد اجتماعي صلب، يضمن للجميع أمانهم وحقوقهم تحت سقف قانون واحد.