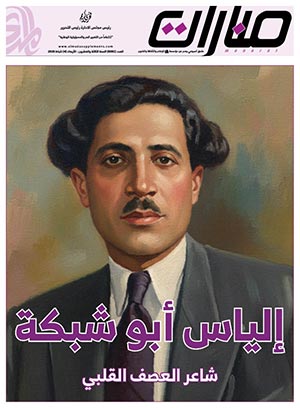لطفية الدليمي
نبحثُ طويلاً عمّا ينقصُنا، ونادراً ما نتأمّلُ ما هو طوعُ أيدينا. نعيشُ وكأنّ الحياة مَدينةٌ لنا بشيءٍ إضافي دائماً؛ بينما العطايا الصامتة تنسلُّ من حولنا بلا امتنان، بلا اعتراف، وكأنها تفاصيل لا تستحقُّ الوقوف عندها. الحقيقة المؤلمة -لو عرفنا- أنّ كثيراً مما نفتقدُهُ ليس مفقوداً بل مركونٌ في زاوية النسيان.
نحوزُ في حياتنا أشياء لو أدركنا قيمتها لخشيْنا فقدانها كما نخشى على أعمارنا: سلامُ الروح، وسكينةُ القلب. نبدّدُهُما بنزقٍ غريب في خصومات لا ضرورة لها، وفي كراهية مستعجلة، وفي أزمات نصنعُها بأيدينا ثم نشكو ثقلها الضاغط على صدورنا.
كم مرّةً خضنا معارك كان يمكنُ تفاديها؟ كم مرّة تشاجرنا لنبرهن لأنفسنا والآخرين أننا على حق، وخسرنا في المقابل راحةَ يومٍ كامل؟ كم مرّة حمّلْنا قلوبنا ضغائن أثقل من قدرتها على الإحتمال، ثم تساءلنا لماذا صرنا مُتعَبين؟
أحياناً، يكفي أن نتوقّف قليلاً لنسأل -أو نسائل- أنفسنا سؤالاً بسيطاً: هل فكّرْنا يوماً في نعمةِ أن نضع رؤوسنا على الوسادة لنغفو، دون أفكار متزاحمة، دون قلق ينهش صدورنا، ومن غير تصارع الأحشاء الداخليّة، بعيداً عن حوارات مؤجلة لا يطيبُ لها ملاعبتُنا بخبث إلّا في جوف الظلام حيث نتوقُ إلى راحة مفتقدة؟
هل نحسبُ هذا أمراً يسيراً؟ أؤكّدُ لك، وهذا بعضُ أثمنِ ما تعلّمتُهُ في حياتي، أنّك لو استطعت أن تنام بقلبٍ تعمّرُهُ السكينةُ، وروح فيّاضة بالسلام، فأنت أحدُ ملوك هذا العالم، حتى وإنْ لم تحمل صولجاناً، ولم تَحِطْك الهيبةُ أو الأضواء. مَلِكٌ بلا ضجيج، بلا عرش، بلا هيلمانات؛ لكنْ بثروة لا تُقدّرُ. أتصدّقُ أنّ كثرةً من هؤلاء يحسدونك على النعيم الذي تقيمُ فيه؟
نحن نبخس أشياءنا الجميلة لأنّنا اعتدناها. نتعاملُ معها بقوّة الإعتياد، ونحسبها أشياء ممنوحة لنا For Granted كما تقولُ العبارة الإنكليزيّة. نستخفُّ بالسّكينة لأنها لا تُرى، ولا تُعرَضُ، ولا تُقاس بالأرقام؛ لكنّها في الحقيقة أثمنُ ما يمكنُ أن يحوزهُ إنسان. ما قيمةُ نجاحٍ مقترن بقلق مزمن؟ وما معنى إنجازٍ يُبنى على خصومة دائمة مع النفس والآخرين؟
***
يُنسّبُ إلى رولان بارت قولُهُ « الفنّان الحقيقي لا يعرف الضغينة». ربّما لا يهمّ كثيراً التحقّقُ من صحّة التنسيب بقدر ما يهمُّ عمقُ المعنى. الفنُّ، في جوهره، فعلُ تحرّر، والضغينة، في جوهرها، شكلٌ من أشكال الأسْر. بهذا الفهم يمكنُ تعميمُ العبارة من غير كثير تحسّب لتكون: الإنسان الحقيقيُّ لا يعرف الضغينة.
الضغينة ليست إنفعالًا عابراً ولا غضباً لحظيّاً. إنها غضبٌ توطّن القلب، وألمٌ رفض أن يَشفى، وجرحٌ قرّر أن يتحوّل إلى هوية. الضغينةُ هي الذاكرة حين تفقد قدرتها على النسيان الذي يرحمُ أرواحنا وأرواح سوانا من البشر، حينها تغدو الذاكرةُ مستودع نفايات مسمومة. ما من شيءٍ يدمّرُ سلام الروح ويزعزعُ سكينة القلب كما تفعل الضغينة.
نخطئ حين نعتقدُ أنّ الضغينة تُرهق الآخر. في الحقيقة، هي تُنهكُ حاملها أولاً. تُثقِلُ الصدر، وتُعكّر النوم، وتُفسِدُ حتى اللحظات التي كان يمكن أن تكون جميلة. نضحك، نعم؛ لكنّما الضغينةُ تتربّعُ في زاوية القلب تراقب. ننجح؛ لكنّها تهمسُ لنا بأنّ النجاح ناقص ما دام الغريم لم يُهزَمْ. نهدأ ظاهريّاً؛ غير أنّ دواخلنا في حالة استنفار دائم بفعل الضغينة. أيُّ سلامٍ هذا الذي لا يتحقّقُ إلّا مقترناً بمقادير مميتة من التوتّر الصامت؟
الضغينة عدوّة السّكينة لأنّها تُبقي الإنسان في حالة دفاعيّة متواترة فتنهكه. تُعيد تشغيل الحوارات القديمة، والمشاهد المؤلمة، والخصومات المنتهية زمنيّاً لكنّما المستمرّة في إعطابِنا نفسيّاً. يبدو الأمرُ كأنّ العقل يرفضُ أن يُغلق ملفّاً ما، فيظلّ يفتحه ليلاً عندما نتوسّلُ السكينة، بلا فائدة، بلا نتيجة. ليس سوى استنزافٍ جديدٍ لأرواحنا وقوانا. الأخطرُ من هذا أنّ الضغينة تتبدّى لحاملها شكلاً من أشكال القوّة أو الكرامة. نخلطُ بينها وبين حفظ الحقوق، وبينها وبين الوعي بالظلم؛ بينما الفارق شاسعٌ بين الإثنيْن. أن تعرف ما جرى لك، وأن تضعه في مكانه الصحيح، هذا وعيٌ؛ أمّا أن تسمح له بأن يحتلّ قلبك ويستوطن ذاكرتك فهذا خراب ذاتيّ وتدميرٌ غير مسوّغٍ لا بطولة فيه.
سلامُ الروح لا يعني أن نُبرّئ الجميع، ولا أن نمحو الذاكرة، ولا أن نُمارس العمى الأخلاقي. هو يعني -ببساطة- أن نرفض بقاءنا رهائن لما لا يمكِنُ إصلاحُهُ. أن نُدرك أنّ بعض المعارك انتهت، حتى لو لم نربحْها، وأنّ بعض الأسئلة لن تنال جواباً، وأنّ الإصرار على حملها لن يمنحنا سوى إرهاق إضافي غير منتج.
الإنسان الذي يعيشُ السكينة المديدة في داخله ليس إنساناً ضعيفاً أو واهناً أو عاجزاً عن المقاومة وخوض الصراعات. هو إنسانٌ اختار أن لا يخسر نفسه. اختار ألّا يحوّل قلبه إلى ساحة تصفية حسابات. اختار أن لا يُعلي شأن النوازع الصراعيّة فيه سعياً لأن ينجو بروحه بَدَلَ أن ينتصر في معركة خاسرة في أثمانها النفسية التي سيتكفّلها وحده.
في عالمٍ يفيض بالإستفزاز، ويكافئُ الغضب، ويضخّمُ الأحقاد، يصبحُ التحرّر من الضغينة فعلَ مقاومةٍ هادئة. مقاومةٌ بلا ضجيج، بلا شعارات؛ لكن بنتائج عميقة؛ فحين يسكُنُ القلب تستعيدُ الروح قدرتها على التنفّس. أخطرُ ما يمكن أن نتعايش معه وكأنّهُ خصيصةٌ طبيعيّةٌ فينا هو أن نسمح للضغينة أن تقيم فينا إقامة دائمة. ما كلُّ ما يؤلمُنا يتوجّبُ أن يسكننا، وليس كلُّ مَنْ أساء إلينا يتوجّبُ أن يرافقَنا إلى النوم.
الضغينةُ في جوهرها ناتجٌ ثانويٌّ للكراهيّة. المُحِبُّ لا تعرفُ الضغينة طريقها إليه مهما تلوّنت وسائلُها واحتالت في إغواءاتها. لستُ رومانسيّةً حدّ المطالبة بأن تكون قلوبنا مستوطناتٍ عامرةً بفُيوض المحبّة وإن كنتُ لا أرى شططاً في هذه الرغبة؛ لكنّما أعرفُ أنّ عالمَنا -كما نعرفه اليوم- لا يُتيحُ مثل هذه الإمكانيّة. يمكنُ في الأقلّ ترويضُ أنفسنا على أن لا نكره. أن نُبطِلَ فعل الكراهيّة تجاه الآخرين. لو فعلنا هذا ونجحنا فيه بعد تدريب ومشقّة فأظنُّنا سنعيشُ حياة أفضل بكثير، وبكُلّ المقاييس، ممّا نفعل اليوم.
***
سلامُ الروح ليس انسحاباً من الحياة. هو مصالحةٌ معها. سكينةُ القلب لا تعني غياب الألم. إنّها القدرةُ على ألّا يتحوّل الألمُ إلى سُمّ دائم يديمُ الإستيطان في أرواحنا. سلامُ الروح المفضي إلى سكينة القلب هو أن نعرف متى نتجاوز، متى نصمت، ومتى نختار أنفسَنا بدل الإستمرار العابث في نزاعات لا رابح فيها.
لو عشتَ في محيطٍ لا يضمرُ لك الأذى، بين أناسٍ لا يتمنّون سقوطك وانكسارك، ولا يفرحون لحزنك، فأنت ذو حظّ عظيم. محظوظٌ أكثر مما تتخيّلُ حتى إنْ لم تدرك ذلك الإمتياز السّخي؛ فقلوبُ البشر، حين تخلو من الغدْر والإحتيال، نعمةٌ نادرة لا تُعوَّض.
لسنا في حاجة إلى المزيد من الصخب بل إلى القليل من السّلام.
لسنا في حاجة إلى كسْب كل معركة بل إلى النّجاة بأنفسنا.
لا نحتاج إلى جهد ملحميّ لتغيير العالم. هذا جهد ضائعٌ. الأسبقيّة دوماً هي أنّنا نحتاجُ أوّلاً إلى أن نكفّ عن تدمير هدوئنا وسلامنا بأيدينا.
لا تبخسْ أشياءك الجميلة والعطايا الثمينة التي وهبتْك إيّاها الحياة؛ ففي عالمٍ يزداد قسوة سيكون إمتيازك العظيمُ أن تعيش بسلام الروح وسكينة القلب.