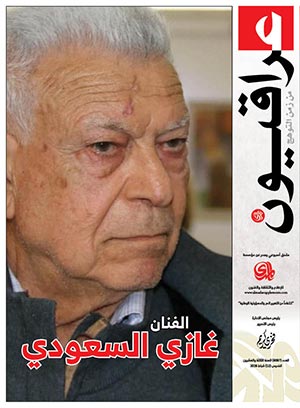في وقت الكاتب الحر وعشقه
نجم والي
الكاتب ووقته الحر؟ هل يملك الكاتب وقتاً حراً مثل بقية الناس؟ لا أبالغ، إذا أجبت بالنفي! كل من جرب الكتابة يعرف، حتى أولئك الذين وضعوا نظاماً يومياً لهم للكتابة، سيفاجئون أنفسهم، بأن الكتاب الذي يعملون عليه، خصوصاً إذا كان رواية، سيظل يلاحقهم باليقظة والنوم، يزورهم حتى في أحلاهم، ربما طور بعضهم إستراتيجية خاصة به لتجنب ذلك، فإنهم سيكتشفون أن شخصياتهم تلك ستصاحبهم حتى في ساعات وحداتهم، دون أن يعني ذلك تقديم شكوى من قبلهم، على العكس، أنهم يفعلون ذلك بطواعية، لا يتمنون لأنفسهم الانتهاء من العمل قريباً. يخطأ من يظن، أن الكتّاب وهم يفعلون ذلك، تعبيراً عن لذة الكتابة، كلا، الأمر أبعد من ذلك.
أعتقد أن الأمر له علاقة بالخوف، الشعور بالوحدة أكثر، حتى إذا استدعى ذلك التضحية بامتلاك وقت حر. نعم، أنه الخوف من فراغ قادم، من أن يجلس المرء وحيداً، بلا رفقة أو صديق، أن يخسر كل ما جمعه المرء في كل الوقت هذا، كل ما ظن، أنه كنز غير قابل للفقدان. كم جلس المرء في غرفته وحيداً؟ سنتين؟ ثلاث سنوات؟ لا يهم الوقت الذي استغرقته كتابة رواية؛ في كل الحالات، وحتى إذا بدا الأمر من الناحية النظرية، أن الكاتب الذي جلس إلى طاولة الكتابة، وأغلق الباب عليه، جلس وحيداً، إلا أن جلسات الوحدة تلك، هي من الناحية العملية، وهذا ما يعرفه كل كاتب، هي محاولة لكسب صداقات جديدة، معارف جدد، زوار جدد، من كل الأجناس والألوان، والأعمار، شيوخ وشاب، سود وبيض، صفر وحمر، إناث وذكور، حيوانات ونباتات، وكثيراً ما تحضر مدن بقضها وقضيها، غابات وبساتين، أنهار وجبال، وديان وسهول، كل ما له علاقة بحياة كل ذلك يأتي إلى غرفة الكاتب، من غير المهم، حجم الغرفة أو مساحتها، علوها أو نقاء هوائها، المهم أن حياة تحضر فيها لا علاقة لها بالحياة التي تجري خارجها، وهذا ما عرفه الكاتب، منذ أن قرر الجلوس أمام طاولة الكتابة، من غير المهم العدة التي هيأها لنفسه، أوراق وأقلام، أقلام بكل أنواعها (من قلم الرصاص إلى قلم الحبر)، من غير المهم الوسيلة التي سيعمل عليها، الكتابة بخط اليد، التي جربها الكتّاب قديماً، وما يزال يجربها البعض، ربما لتصور "رومانتيكي" للكتابة وعلاقة خط اليد بذلك، اليوم عدد كبير من الكتّاب، خصوصاً أولئك الذين جربوا الكتابة على آلة الطابعة، تضرب أصابعهم على مفاتيح حروف الكومبيوتر، تبحلق عيونهم عميقاً في عمق المومنيتور، كل كلمة تظهر على الشاشة، هي بداية صداقة لا يُعرف الزمن الذي ستمتد عليه؛ المهم، مع الوقت، كلما استيقظ المرء صباحاً، كلما أنجز طقس استعداده للدخول إلى مكتبه، كلما عرف أنه سيدخل إلى عرينه الخاص به، وبطواعية، ليبدأ بعد قليل بمصارعة الكلمات، بمصارعة نفسه، لا بد أن يتغلب على نفسه، على شعوره بالوحدة هناك، هذا الشعور الذي صحيح أنه سينتهي، وسيصبح ماضياً بعد ساعات، لكنه أيضاً، وما أن يستنفد الوقت الذي كان بحاجة إليه، ما أن تضرب أصابع الكاتب على آخر حرف بتعب، ما أن يبدأ جفنا الكاتب بالسقوط على بعضهما بوهن، ما أن يشعر الكاتب بالإرهاق، حتى يسري في الكاتب في تلك اللحظة بالذات، شعور مألوف يبدأ بالهجوم عليه، يضربه في المرة هذه في العمق!
إنه أمر غريب، لأن الشعور بالوحدة هذا، ليس بجديد، أنه شعور يأتي كل يوم، يتسلل بهدوء مثل نسمة هواء تدخل نافذة المكتب، لكن، ولأن الكاتب يعرف، انه حتى الآن، صحيح أنه كان يشعر بالوحدة بعد إنجاز عمله اليومي (ستة أو سبع أو ثماني ساعات؟)، بعد أن يكون تقدم خطوات بالقصة التي يصر على روايتها، أن عليه أن يتوقف لا محالة بسبب تعب ووهن هجما عليه، إلا أنه من الناحية الأخرى، يعرف، أنه فراغ مؤقت، وحدة عابرة، أنها فقط استراحة قصيرة على الطريق، وغداً؟ غداً سيكمل الرحلة مع أصدقائه المجهولين. وفقط عندما ينتهي من الكتاب، عندما يخط جملته الأخيرة، ويضع النقطة الأخيرة، حتى يشعر بوحدة رهيبة تهجم عليه، حزن يستحوذ عليه، يصاحبه في كل خطوة سيخطوها بعد الآن.
قديماً ومنذ انطلاقة الرواية قبل خمسة قرون وحتى بدايات القرن العشرين على أكثر تقدير، واظب الكتّاب على تزيين نهاية كتبهم بوضع كلمة: انتهت! ربما أرادوا منح أنفسهم الشعور، أن العمل أُنجز، من الأفضل طوي صفحته، مثلما يطوي المرء صفحة كتاب، لكن إلى أي مدى صحت كلمة "انتهى"؟ هل هي كلمة "حقيقية" أم كلمة "تزويقية" وحسب؟ بالتأكيد هي محاولة لإقناع النفس! لكن، ألا نفعل ذلك أيضاً، بعد الانتهاء من قصة حب عميقة، عندما نقول: كل شيء انتهى ونعرف أن القصة لم تنته بعد؟
عمودمنطقة محررة عدد(2617)
نشر في: 9 أكتوبر, 2012: 05:57 م