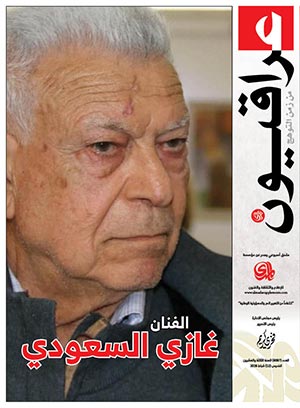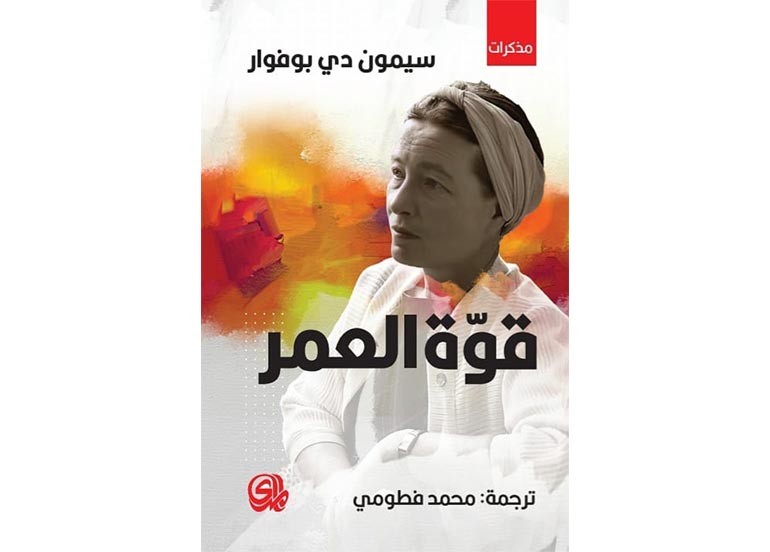في عام 2002، حين كنت أعمل أستاذاً في كلية التربية بصحار، في سلطنة عمان، كنت مقرراً للجنة التحضيرية لسوق صحار الثقافي السنوي، والمسؤول عن اختيار الشعراء غير العمانيين للمساهمة في السوق، فكان أول الأسماء التي عرضتها على اللجنة اسم الشاعر علي جعفر العلاق، وكان حينها في جامعة الإمارات، ببساطة لأني كنت متأكداً من أنه، وبما عرفته عنه مما سآتي عليه بعد قليل، سيُضفي على الأمسيات الشعرية للسوق الثقافي جواً من الحلاوة والغنى.
أتذكر في تقديمي له في الأمسية التي شارك فيها استعدت معرفتي له قبل أكثر من عشرين سنة منها، فذكرت ما عرفته في العلاق من حلاوة إلقاء لشعره وحلاوة هذا الشعر، ثم عبّرت، وأنا انتظر والجمهور الذي كان كبيراً في كلية التربية، عن تشوّقي لتلمس علاق الأمس في علاق اليوم.. قلت هذا وأنا أتخوّف عميقاً في داخلي من أن لا أجد مثل هذا فيه، خصوصاً أن الشاعر الإنسان العاطفي المنفعل كان هو اليوم الأكاديمي الدقيق والمنطقي والعملي والمتأني... ولكن المفاجأة كانت مع أولى الكلمات حين انسابت منه لتطير إلى الجمهور فتدخل مباشرة وبدون استئذان مسامعهم وقلوبهم بما تعبر عنه من أرقّ المعاني وأكثرها قدرة على الحوار مع الناس والقلوب والعقول على حد سواء، وبما تتسم به من موسيقى وخصوصية التشكّل والبناء. وقد تأكدت من تلقي الجمهور هذا وأحسسته بقوة من خلال فعل وردة فعل: الفعل تمثّلَ في ما تحرك في داخلي أنا من عمق تلقٍّ وعمق انفعال، وردة الفعل أو لنقل ردود الفعل تمثّلَت في مستويين متناقضين.. صمت القاعة إلا من صوت العلاق يتهادى من مكبرات الصوت من جهة، وفي صخب هذا الجمهور تصفيقاً وإشادةً بعد كل قصيدة، بل كل مقطع من مقاطع قصائده من جهة ثانية.
تلك الأمسية أعادتني إلى ما قبلها بعشرين سنة حين كنا معاً في جامعة إكستر ببريطانيا، وفي تلك العودة نقول إن حلاوة أن نُنصتَ للعلاق لم تكن في إلقاء شعره أو في طريقة انطلاق شعره من بين جوارحه وشفتيه فحسب، بل في مروياته وتعليقاته على كل شيء، فما كان يحكي قصة أو حكاية أو خبراً إلا ويلحّنه ويعيد تنظيمه، بل حتى يموْسقه بإيقاعات تمنحه خصوصية هي خصوصية علي جعفر العلاق. فهو مثلاً كان يعمد إلى تفصيل الحكاية التي يحكيها الأمر الذي كان يعني عدم إهمال الجداول الصغيرة إن لم تكن مثل هذه الجداول في كثير من الأحيان توابل الحكاية، وإني لأتساءل إن كان مثل هذه السمة الأسلوبية من ضمن سمات شعر العلاق ذاته كما هي في إلقائه؟ نقدياً لم أكن لأحسم أمر هذا حينها، خصوصاً أنني حين التقيتُ العلاق لم يكن قد أصدر غير ثلاثة دواوين شعرية، وهي "لا شيء يحدث لا أحد يجيء"، و"وطن لطيور الماء"، و"شجر العائلة"، والأول لم أكن قد اطلعت عليه وقتئذ.
وعلى أية حال، حين أعود إلى شعر العلاق اليوم، سواء ذلك الذي قدمه في دواوينه الثلاثة السابقة، أم في عموم دواوينه الثلاثة عشر، فإني أجد خصوصية هذا الشعر تتعدى ذلك الرجع المُمَوْسق الموصول، وهو في كل الأحوال يزيده حلاوة، وهذه التفصيلية المحببة، وهي مما قد يتجاوزها الشعر في ضرباته ولقطاته و(مشاهده ولمحاته) النابضة والمعبّرة عن كم هائل من أبعاد ومستويات المعنى والدلالة والإيحاء.. أقول أنني أجد هذه الخصوصية تتعدى نوعية الإلقاء وأسلوبية التفصيل إلى شيء أكثر شعريةً وأدخل في الأدب الخاص.. إلى صدق التجربة وصدق التعبير عنها وصدق الانفعال في هذه التجربة وفي هذا التعبير عنها. فهو في هذا يُحب الموضوع الذي يتناوله، ويعشق الألفاظ التي يعبر بها عن الموضوع أو المعنى، وينفعل باستخدامه لهذا الألفاظ والعبارات التي يصوغها منها. وهو يكاد، في ذلك كله، يحول الجامد إلى حي، والسكون إلى حركة، والمهمل إلى شيء ذي قيمة، وما لا نلتفت إليه إلى ما يشدنا، وما لا تجد العين العادية شيئاً فيه إلى كنزٍ من المعاني والمشاعر وإلى مكمن مكين للحب والعاطفة والتفاعل. فهو مثلاً حين يتكلم عن مدينة ما، فإنه يلتقي معها بالروح والوجدان، وهذا ما ذكرته في كتابي عن "الآخر في الشعر العربي الحديث" حين قلت: "إن ما يميز شعر العلاق في هذا أو يزيد على الآخرين هو أنه إذ ينغمر وجدانياً في ما يراه أو يقوله، فإنه يصل، في انغماره في هذا حد تجسيد المدينة ليتلاقى بهذا الروح والوجدان من حيث لا ندري، إلى وعيه ونكون هو من جهة، والمادة التي هي المدينة الحسية حين ننساق مع الشاعر ومن خلال وعيه نحو المدينة ذاتها من جهة ثانية".
ولعل أغرب وأجمل ما رصدته في هذا الجانب في شعر العلاق، هو أنه لا يختلف في قوته وجماليته وتحقّقه أيّاً كان موضوعه، وطنياً أو ذاتياً أو عاطفياً أو اجتماعياً، الأمر الذي تأكد لي، عودة إلى الحاضر، حين طلبت من الشاعر قصيدة كنت أعرف أنه كتبها ولم أطلع عليها عن مدينة (إكستر) التي جمعتنا قرابة أربع سنوات منذ أكثر من ربع قرن، وذلك لألقيها هديةً للجمهور في ختام محاضرة عن "الآخر في الأدب العربي" كنت أعدها لإلقائها في معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر نهاية عام 2009. وهو الأمر الذي جعلني أقتبسها كاملةً وأضمها إلى نصوص ملحق كتابي "الآخر في الشعر العربي الحديث" الذي صدر عام 2010، إلى جانب استشهادي بقصائد أخرى له حضر فيها (الآخر) الغربي بقوة. وكما ختمت محاضرتي عن "الآخر في الرواية العربية" بقصيدته الجميلة (إكستر)، وشاء الترتيب المنهجي لفصول ومادة كتابي أن تكون هي مسك الختام ايضاً، أجد مناسباً جداً أن أختم شهادتي القصيرة هذه بمقطع من قصيدة (إكستر) هذه، وأنا أظن أنها ستجسّد جل ما قلته في هذا الشهادة عن الشاعر الكبير الصديق علي جعفر العلاق:
غيومٌ من الأصدقاءِ القدامى
تُلوّحُ لي، أم حجرْ؟..
صَخْرةٌ
تقتفي حُلُمي،
أم خُطى امرأةٍ في المطرْ؟
ذاكَ بارٌ قديمٌ
يضيء كراسيَّهُ الليلُ،
والساهرونْ
تلكَ سيّدةٌ من حنينٍ
وفَرْوٍ،
وذاكَ فتىً من أسىً،
وجنونْ..