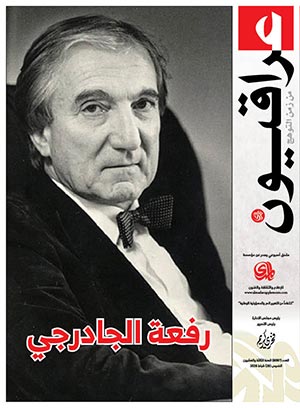بأسرع مما تصورنا نحن دعاة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وبأسرع مما تصور السياسيون الإسلاميون أنفسهم بعد أن وصلوا إلى السلطة بأشد الطرق التواءً وانتهازية، سقطت الأوهام التي ارتبطت بهم التي راهنوا على جرجرة المصريين خلفهم باسمها.
أشاعت قوى الإسلام السياسي أنها مفوضة من الله - سبحانه وتعالى - لهداية الشعب المصري وقيادته إلى الجنة على الأرض أولا وفي الآخرة ثانيا، وانقاد وراءهم في البداية جمع غفير من المواطنين البسطاء المتدينين بسماحة وصدق، ولكنهم سرعان ما اكتشفوا أن أبناء الله هؤلاء مزورون وكذابون بل ومتوحشون في الدفاع عن سلطتهم، وسقط القناع الذي وضعوه على ممارساتهم، واختبرت أعداد كبيرة من المواطنين - وبخاصة شباب ثورة 25 يناير - اختبروا ازدواجية الإخوان المسلمين وحلفاءهم الذين كان بعضهم رفاقا لهم في بعض أيام الثورة، هذه الثورة التي التحق الإسلاميون بها متأخرين ثم تركوها مبكرا لينخرطوا في ألاعيب سياسية، كثير منها غير أخلاقي بل وشديد الغباء والانتهازية، وكانت عيونهم دائما على السلطة «وطز» في الثورة «وطز» في مصر وشبابها المناضل.
اكتشف ملايين المصريين أن قوى الإسلام السياسي إنما تتلاعب بهم وتضللهم بل وتعتدي بأساليبها البذيئة على تدينهم المنفتح الواسع والمتسامح حين تؤجج أشكال التعصب الطائفي، وتعادي المسيحيين وتسعى لمحاصرتهم وصولا إلى تقسيم البلاد وتمزيق نسيجها المتين الذي جرى عزله من كل مكوناتها الثقافية والدينية والحضارية والشعبية عبر العصور ليخرج هذا التكوين الفذ الفريد المسمى بمصر، مصر التي هي وطن يعيش فينا على حد تعبير البابا الراحل شنودة الثالث الذي شنت عليه جريدة «الحرية والعدالة» الناطقة باسمهم مؤخرا هجوما كاسحا، وصولا إلى مطالبة المواطنين أو المسلمين بالأحرى بمقاطعة البضائع التي تنتجها مشروعات المسيحيين المصريين، تمهيدا لإشعال الفتن الدينية التي من المؤكد أن ملايين المصريين لن يسمحوا لهم بها بعد أن تكشفت لهم حقيقة الأوهام التي أغرقوا بها الناس.
وكان أول الأوهام التي جعلت مرشدهم السابق يقول إنه يقبل أن يحكمه ماليزي أو أندونيسي مادام مسلما وطز في مصر، هو وهم إحياء الخلافة الإسلامية بعد ما يقارب التسعين عاما من تحلل الخلافة العثمانية، التي مارست كل أشكال الاستبداد والاستغلال والفساد في الولايات التي حكمتها، وسقطت هذه الخلافة بفعل تآكلها الداخلي حتى قبل أن يتعاون العالم الاستعماري ضدها، واندلعت الانتفاضات والثورات في البلدان التي حكمها العثمانيون قبل أن يشيعهم التاريخ إلى مثواهم الأخير.
والآن، وبالتقرب إلى تركيا التي يحكمها حزب أصولي إسلامي وتنتعش فيها نزعة إمبراطورية عثمانية جديدة، يتصور حكامنا أنهم يخطون في اتجاه إحياء الخلافة بصرف النظر عن حركة التاريخ، ورغم عضوية تركيا في حلف الأطلنطي وهي المكلفة إلى جانب إسرائيل بحماية المصالح الإمبريالية في المنطقة.
ومع ذلك ورغم هذا التهافت للالتحاق ببقايا الخلافة فإنهم ودعوا «رجب طيب أردوغان» بعد زيارته مصر باللعنات، لأنه قال إن في الإسلام أسسا قوية للعلمانية، وأنه ليس هناك تناقض بين الإسلام والعلمانية، وهو ما سبق أن قال به «مهاتير محمد» زعيم ماليزيا الحديثة الذي أكد أنه مسلم علماني، وأن فصل الدين عن السياسة ضرورة، ولكن دعاة الخلافة في مصر انتقائيون ولا يرون تناقضاتهم.
وقد تآكل وهم الخلافة الذي يغذيه التنظيم الدولي للإخوان المسلمين مع انكشاف حقيقتهم أمام ملايين المصريين الذين سخروا من أحلامهم الإمبراطورية ورفضوا أسطورتهم الأممية البائسة التي عجزوا تماما عن تسويقها.
أما الوهم الثاني فهو ادعاؤهم احتكار الدين وتمثيلهم له، وقد علمهم المصريون درسا بليغا ندعو الله أن يستوعبوه، وذلك في شكل الإصرار المتزايد من قبل جماهير بسيطة على أن «الدين لله والوطن للجميع» وليس هناك من هو مفوض باسم الله - سبحانه - لكي يقودهم إلى الجنة، وأثبتوا أنهم أعلم بشؤون دنياهم، ورفضوا تحويل الجوامع إلى منابر للدعاية السياسية بعد أن أثمرت جهود القوى المدنية الديمقراطية التي دعت بكل السبل لفصل الدين عن السياسة التزاما بشعار ثورة 1919 المجيدة «الدين لله والوطن للجميع».
وثمة وهم آخر يتمثل في تصوراتهم حول إعادة الشعب المصري إلى ما قبل 25 يناير 2011، ناسين أن المصريين بإسقاطهم مبارك قد أسقطوا حاجز الخوف إلى الأبد، وأن الإرهاب الأسود الفاشي باسم الدين لن يعيدهم إلى الوراء وإن عطل مسيرتهم موقتا نحو تحقيق أهداف ثورتهم التي سطا عليها الإسلاميون بادعاء أنهم كانوا شركاء فيها، فارضين دستورهم الباطل الذي ولد ميتا.
إن متابعة مظاهر الإفلاس الفكري المعنوي والسياسي في ممارسات الإسلام السياسي الحاكم لابد أن يفتح لنا باب الأمل لاستعادة الوطن المخطوف وإسقاط حكمهم كما سبق أن سقط حكم «مبارك» حتى تواصل الثورة مسيرتها من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وإنّ غداً لناظره قريب.