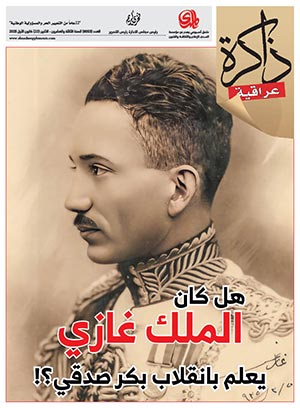حارث حسن
مؤخراً، التصقت على جدران بغداد المنهكة، «بوسترات» وزّعتها رابطة تزعم أنّها «شعبية»، اسمها «الحراك الشعبي المستقل لمبادرة الحزام والطريق – تنسيقية بغداد»، تطالب بتفعيل ما يعرف عراقياً بـ»الاتفاقية الصينية»، وهي اتفاقية أعلنتها حكومة عادل عبد المهدي السابقة، تقضي بتخصيص عوائد قيمتها 100 ألف برميل نفط عراقي يومياً لتوضع في حساب خاص لتمويل آجل لمشاريع إعمار تتولى الشركات الصينية تنفيذها في العراق.
وإذا كانت هذه الاتفاقية تشبه اتفاقات أخرى وقعتها الصين مع بلدان عالم ثالثية واستندت إلى فكرة الدفع الآجل لمشاريع البنى التحتية والإعمار، فإنّها سرعان ما اكتسبت مكاناً في الجدل والاستقطاب السياسيين، عندما قرّرت الفصائل المقربة من إيران تبنيها كشعار أساسي ينسجم مع توجهها الأيديولوجي بمزيد من الانفتاح على الصين، وهو بمثابة خطوة للابتعاد من الولايات المتحدة، “الشيطان الأكبر” في قاموس هذه الفصائل.
تدريجياً، أصبحت “الاتفاقية الصينية” جزءاً من سردية الفصائل، الى حدّ اتهام احتجاجات تشرين الأول (أكتوبر) 2019 التي أطاحت بحكومة عبد المهدي أنّها “أميركية” وأحد أهدافها هو إسقاط “الاتفاقية الصينية”. في هذه السردية، تظهر الاتفاقية الصينية باعتبارها وعداً مؤكداً لتطوير العراق وتحسين وضعه الاقتصادي والارتقاء بمكانته الدولية، وأنّ المسعى الأميركي المفترض لتخريبها، هدفه إبقاء العراق ضعيفاً ومعتمداً على الولايات المتحدة. ورُبطت الاتفاقية بأمر آخر كما في بوستر “الرابطة الشعبية” المذكور، بمبادرة الحزام والطريق الصينية (المعروفة عراقياً بطريق الحرير)، رغم عدم وجود علاقة مباشرة واضحة بين الاثنين. والفكرة هنا أنّ العراق، بموجب مبادرة الحزام والطريق، يمكن أن يصبح ممراً رئيسياً للسلع الصينية الذاهبة نحو تركيا وأوروبا، لأنّه المنفذ الجغرافي الأقرب إلى الخليج والذي يمكن أن يسهم بتقصير طريق السلع الصينية نحو أوروبا ويستفيد من تجارة الترانزيت التي سيوفرها تحوله الى عصب أساسي في “طريق الحرير».
بالطبع، ظهرت آراء لخبراء حقيقيين أو مزيفين، تدعم الاتفاقية ودخول العراق في مبادرة الحزام والطريق. عادل عبد المهدي لعب دوراً مهماً في الترويج عبر مقالاته لفكرة “الاتجاه شرقاً”، مبشراً ليس فقط بالمنافع الاقتصادية التي سيجنيها العراق من مزيد من الارتباط بآسيا، بل وأيضاً بالمنافع الجيوسياسية المتمثلة بالتخلص من الهيمنة الغربية (وفي قاموس عبد المهدي اليساري - الإسلامي، الهيمنة لا يمكن لها الّا أن تكون “غربية”)، وبحقيقة أن الصين هي القوة الناهضة التي يجب الاستثمار فيها مع تراجع الغرب وبروز عالم متعدد الأقطاب. وإذا كانت نظرية عبد المهدي قابلة للنقاش، فإن مجموعة من “خبراء” الانترنت ومعلقي الفضائيات، من غير المتخصصين، انبروا بدورهم – غالباً لأسباب أيديولوجية مقنّعة بلغة تقنية، وأحياناً لأسباب منفعية – للتبشير أيضاً بهذا الوعد “الصيني”، فقدّموا سلة من المعلومات الخاطئة، والاستشرافات المبالغ بها، ونظريات المؤامرة الجاهزة.
وسط هذا الصخب، غالباً ما تضيع بعض الحقائق البسيطة. أولها، أنّ الصين موجودة في العراق منذ سنوات وهي أكبر شريك تجاري للعراق (بقيمة تجارة تبلغ ثلاثين مليار دولار سنوياً)، والعراق يمثل ثالث أكبر مصدر للنفط إلى الصين، وشركات الطاقة الصينية مثل “بتروجاينا” و”سينوبيك” تنشط في العراق منذ أكثر من عقد، بل إنّ السؤال المطروح اليوم بخصوص دور الشركات الصينية في قطاع الطاقة العراقي (وهو القطاع الاقتصادي الوحيد المنتج في البلد) ليس في ما اذا كان مسموحاً للصين دخول العراق، بل ما اذا كانت الصين ستهيمن على قطاع الطاقة في هذا البلد، خصوصاً مع انسحاب العديد من شركات الطاقة الغربية كـ”شل” و”أكسون موبيل” وتهديد “بريتش بتروليوم” بالانسحاب.
الأمر الثاني، هو أنّ مشكلة العراق ليست في العثور على من يتولى إعماره من الشركات والجهات، بل في خلق بيئة مناسبة سياسية وأمنية واقتصادية، بإدارة بيروقراطية كفوءة وبأقل قدر من الفساد، تسمح بمثل هذا البناء. بالطبع، نجحت الصين في بناء نموذج جذاب في التنمية الاقتصادية، ووجودها في العراق والمنطقة طبيعي جداً، لكن سلوك الشركات الصينية وغيرها سيتقولب بطبيعة البيئة التي تنشط فيها، فإذا كانت تلك البيئة تتسم بالفساد الشديد وبهيمنة المافيات وإهدارها للمال العام، فإن “الإعمار” الصيني لن يختلف في نتائجه عن غيره من أشكال الإعمار، كما كشفت مثلاً صفقة بناء المدارس التي أحيلت من الحكومة العراقية السابقة لشركات صينية ليتضح لاحقاً أن تنفيذها جرى من شركات عراقية وقد شابها قدر كبير من الإهدار والفساد. الأكثر من ذلك، إن التجربة الصينية في أفريقيا وميانمار وسريلانكا وغيرها، أثبتت أيضاً أن الصينيين يستسهلون التعامل مع الأنظمة الفاسدة والمافيات التي تسيطر عليها، أكثر من الشركات الغربية، من دون الدخول في الموضوع الذي هو اليوم محل نقاش حول ما يعرف بـ”شرك الديون” الصينية.
باختصار إنّ ما يقال غالباً عن الولايات المتحدة من أنّها “ليست جمعية خيرية” يجب أن يقال عن الصين أيضاً. في عالم اليوم، سيكون من الخطأ لبلد عالمثالثي أن يتجاهل الصين أو الفرص التي يتيحها التعامل التجاري معها (الصين هي المستورد الأكبر للنفط العراقي)، لكن خلق الأوهام حول ما تستطيع الصين فعله في العراق إنما يدخل في سياق التلاعب السياسي بالجمهور لخدمة أغراض معينة.
وهنا تحديداً يمكن أن نفهم لماذا تصرّ بعض الفصائل المقربة من إيران على السردية الصينية وإلباسها طابعاً سياسياً، حتى حينما تحاول الصين نفسها تجنب إعطاء هذا الطابع حول انخراطها الاقتصادي في المنطقة. يتعلق الأمر أولاً بالتأثير الإيراني الميال الى تدعيم خيارات إضعاف الوجود السياسي والاقتصادي الأميركي في العراق وربط هذا البلد أكثر بخيارات السياسة الإيرانية. لكن التأثير الإيراني ليس هو التفسير الوحيد، بل إنّ لهذه الفصائل أهدافها الخاصة التي تتعلق بكونها قد طورت مصالحها التجارية وشبكاتها الاقتصادية، ويبدو أن بعضها استسهل خلق الشراكات مع الصينيين، والاستفادة من تساهل الشركات الصينية مع بعض النشاطات التي يمكن تبويبها كأنواع من الفساد.
وأخيراً، فإن هذه السردية المبسطة حول طرف خارجي ما يأتي ليعمر العراق ويخلصه من خرابه، وهي لا تختلف في تهافتها عن تصورات بعض معارضي الفصائل عن طرف خارجي يأتي لينقذ العراق منها، إنما تعكس، من جهة، عجز هذه الأطراف عن فهم تعقيدات الوضع العراقي وسبل الخروج من أزماته الحادة، ومن جهة أخرى، مستوى تغلغل الثقافة الريعية التي تتصور أنّ العراق، البلد الذي يعاني من تضخم حجم فئاته الشابة الباحثة عن عمل، لا يمكن أن يكون سوى مشترٍ لسلع وخدمات الآخرين.
«الاتفاقية الصينية” هي الى حد كبير ابنة الثقافة الريعية، وتعبير عن حالة بلد لا يصنع ولا ينتج شيئاً غير مورد طبيعي صادف وأنه موجود تحت الأرض العراقية. وما هو أخطر في هذه الثقافة، هو قدرتها على اقناع الشلل الريعية المستمكنة من السلطة، والتي تفتقر الى تصور واعٍ لتحديات العصر وشروطه، ويغرق بعضها في أوهام ماضوية ومقولات أيديولوجية تنتمي الى منتصف القرن العشرين، أنّ بوسعها الاستثمار في صراعات الأقطاب الدولية، بدلاً من قبول الإصلاح الداخلي.
إن جزءاً من “الإغراء الصيني” لا يتعلق بالتوق الى الإعمار، بل بالتوق الى بقاء الأشياء على حالها.