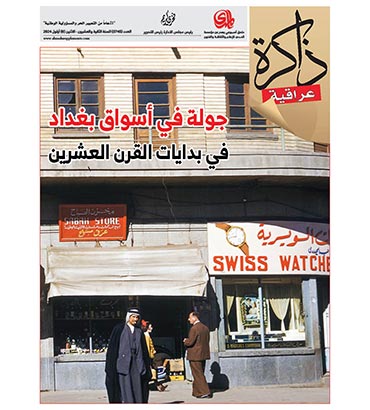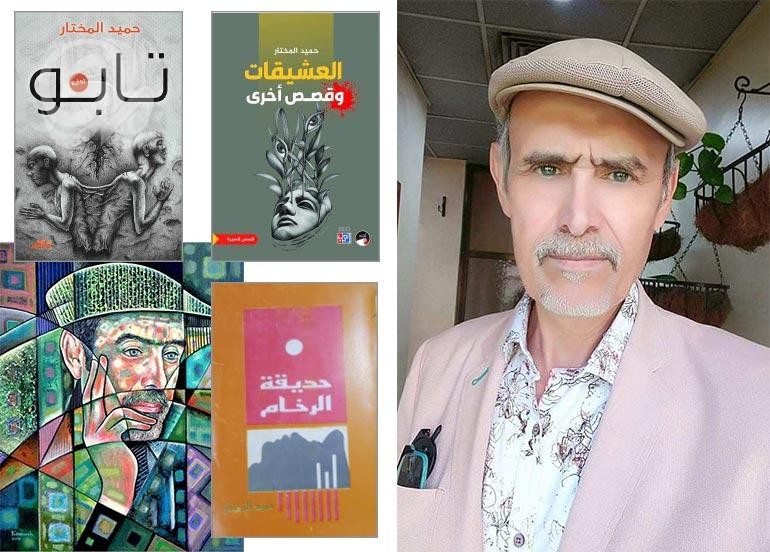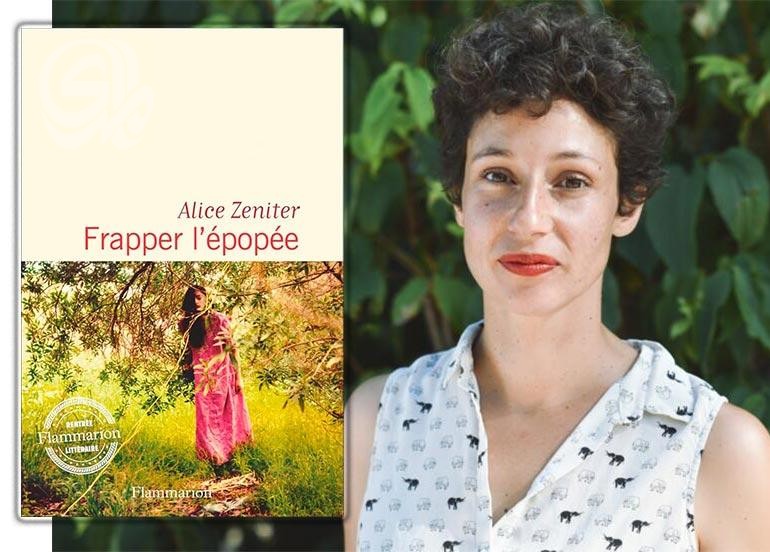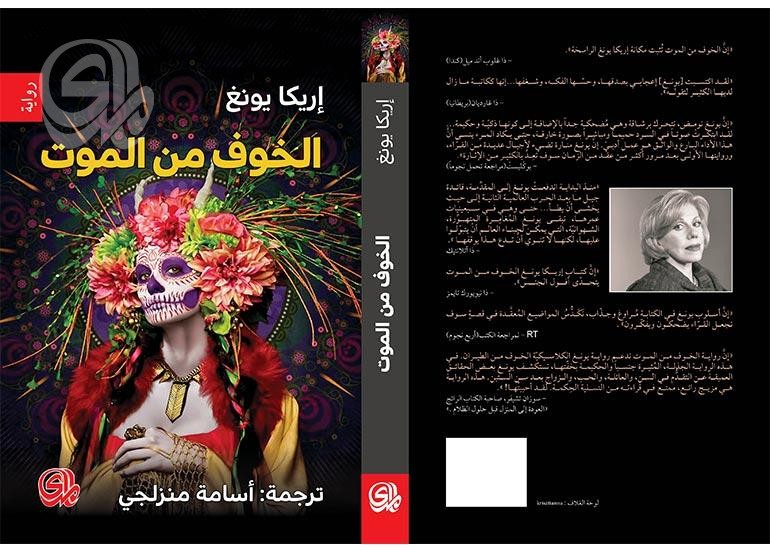يرى أن حساسيته كمحرر صحفي تدفعه لمتابعة كلمات المتحدثين وتعيد ترتيب السرد
حاوره: علاء المفرجي
عرفت زهير الجزائري عندما كنت صبياً, يوم اقتنيت في منتصف السبعينيات روايته (المغارة والسهل) فقد كان زميلاً وصديقاً لشقيقي الكبير، وكنت حينذاك أعمل في إتحاد الطلبة، وهو الواجهة الطلابية للشيوعيين.. وكنت اتعمد في وضع هذه الرواية مع كتبي المدرسية، لأُعيرها لزملائي في المدرسة، وخاصة زملائي في اتحاد الطلبة.. وفي نهاية السبعينيات وبعد اشتداد الحملة القمعية ضد الحزب الشيوعي والحركة الوطنية، كان زهير الجزائري مختبئاً في بيتنا، المرصود أصلاً من قبل أجهزة الأمن، قبل أن يغادر الى بيروت، وأغادر أنا أيضاً الى بيروت لنفس السبب، وها أنا وبعد أكثر من أربعين عاماً أحاور الجزائري، لأقف عند محطاته الإبداعية والحياتية تلك.
القسم الثاني
عاش طفولته في مدينة النجف مع أب علماني محتفظ بثقافة دينية، وتأثر بأخواله الشيوعيين الذين كانوا منخرطين في نشاط مع صعود الثورات الطلابية أواخر الستينيات، وانضم إلى المقاومة الفلسطينية وزار مقارها في دمشق وبيروت وعمّان بصفته صحافياً، مع تفكك حركة المقاومة عام 1970، عاد من بيروت إلى بغداد وجدّد صلته بالحزب الشيوعي العراقي، وعمل في مجلة (الإذاعة والتلفزيون). كما عمل في جريدة (طريق الشعب)، قبل أن تبدأ حملات القمع لليساريين في نهاية السبعينيات. حينها، اكتشف أنه ممنوع من السفر، فاضطر إلى الاختباء حتى استطاع مغادرة العراق عام 1979. رحل إلى لبنان وعمل في إعلام المقاومة الفلسطينية من جديد إلى أن جاء الاجتياح الإسرائيلي، واضطر إلى ترك بيروت باتجاه الشام، رحل إلى لندن في عام 1990، شارك في العديد في الأمسيات والندوات بالعراق.
من أعماله: في الرواية، “المغارة والسهل”، 1974، “حافة القيامة”، 1998، “الخائف والمخيف”، 2003، “حرب العاجز: سيرة عائد، سيرة بلد”، 2009، “أوراق جبلية”، 2011، «ضباب الامكنة» 2020، «يوميات الألم والغضب» 2021 ونتاجات أخرى: “الفاكهاني”، 1981، “أوراق شاهد حرب”، 2001، “المستبد: صناعة قائد – صناعة شعب”، 2006، “أنا وهُم 2003، “النجف: الذاكرة و المدينة”، 2013
لا يخطئ من يتابع أعمالك الروائية ملاحظة أن أثر الحس الصحافي، حاضرٌ على الدوام: فضول، ومراقبة لالتقاط أي معلومة أو ملاحظة أو حركة الناس وكلامهم من حوله، وهكذا يتحوّل كل شيء يقع تحت عينيك أو يتناهى إلى سمعك، إلى مادة صالحة للكتابة، هل ترى في ذلك عيباً ما أم ميزة أخرى للمهارة في السرد؟
ج:أكثر من خمسين عاماً قضيتها في الصحافة، الجزء الأكبر منها في الميدان، حيث الحدث ومهمتي أن أغطيه. حواسي، عيناً وأذناً وأنفاً وفوقها وعياً تدربتْ على التقاط الحدث وأحياناً قبل حدوثه، خلال حياتي الصحفية غطيت تسع حروب ، في الشرق الأوسط وأفريقيا: الصحفي يرافقني ويدير رأسي وأنا ساه ليقول لي: انتبه! هذا موضوع صحفي. الصحافة علمتني أن أرى ماليس مرئياً للآخرين، وعلمتني الإصغاء، وفي نفس الوقت التشكيك بما أسمع، علمتني الحس العام common sense الذي لا يُلقن في التدريب الصحفي، إنما يتشكّل من الخبرة والفضول. ولي كروائي علمتني الصحافة الاهتمام بالحدث اليومي بمقدار اهتمامي بالتاريخ، وعلمتني كحرفة أن أكتب دائماً حتى بغض النظر عن المزاج، أسمع كثيراً من يقولون (أخذته الصحافة من الرواية) وكأنهما خصمين. بينما كنت مثل ماركيز أعتقد أنه في البلاد الكثيرة الاضطراب ستلتقي الصحافة والأدب في مكان واحد ولكن من جانبين. الصحافة بحبوها المحدود تلم الروائي الى الاختصار في الجمل الفائضة عن الخط الأصلي للرواية، تعلمت من الصحافة وربما تمهيداً للرواية أن استحث الآخرين للحديث عن تجاربهم مهما بدت ثانوية وان أسجلها في يومياتي، الصحفي والروائي يتزاحمان على الاستماع، كل يريد أن يأخذ التجربة له. صحفي يريد أن يسجل شهادة، في حين أن شخصية الشاهد وشهادته تشكلان مادة الروائي، الحروب تقسمني الى نصفين، الصحفي يهتم باللوحة العريضة لمصالح الطرفين وقدراتهم العسكرية ، بينما ينشغل الروائي بانفعالات المقاتل الواحد وهو على حافة الموت، وأنا مع الاثنين الصحفي والروائي،
«ضباب الأمكنة»، رغم أنه منح المكان حقه جغرافياً وتاريخياً، إلا أنه لم يكن معنيّاً بذلك فقط ، بل هو سيرة ذاتية وشخصية للمكان متمازجاً بالشأن الاجتماعي السياسي، والذي يبدو أنه كان المُلهم لتوثيق هذه الأمكنة... ما تعليقك؟
- صحيح، المكان بالنسبة لي إطار، قيمته تكمن بما يحتويه، فهو ليس ساكناً، إنما يكتسب قيمته من الحياة الاجتماعية التي يحتويها ويتغير وفقها، أنا كتبت عن أمكنة أعرفها، وكلمة (أعرفها) لا تفي ما أريد أن أقوله، لأنني عشت فيها أو تأثرت بها، كثيراً ما تأتي الأمكنة في ذاكرتي قبل ناسها، أسميها وأدخلها بذاكرة شغوفة، ثم يدخل الناس الصورة، (مدينة الثورة) كانت ببالي دائماً ولكنني لا أعرفها جيداً، لذلك تركتها لصديقي عبد الله صخي، ابن المدينة وسجلها الروائي. يحيطني المكان، أنا الذي قضيت ثلثي عمري خارجه، كنت أتوهم وأُوهم نفسي بأنه الأخير، أدق المسامير في الجدران وأشيد رفوفاً للكتب و دولاباً لملابسي، و أفرش شرشفاً فوق السرير و أشبك يديّ خلف رأسي وأقول : هذا منفاي الأخير! ثم أُقتلع منه دون أن أترك ظلاً، لكي أتكيف مع منفى جديد عليّ أن أغادر السابق دون أن ألتفت للخلف، تعاودني الأمكنة مثل وخزات في الخاصرة ثم تتسع مثل الألم، فيها تركت قطعة من حياتي ومنها عرفت لماذا يبكي الشعراء على الأطلال، في هذا الكتاب ( ضباب الأمكنة ) وفي كتابي عن النجف وقبلهما (حرب العاجز) عودة للأمكنة، وفي الحقيقة هي ليست عودة، لأن الأمكنة لم تعد كما أتذكرها، ومن هنا فأنها انكسار في الزمن ، انكسار الى الخلف وصدام دائم بين المكان في ذاكرتي وبينه الحاضر، كلاهما يجرني إليه، استغل هذا التجاذب لأعطي الواقع الاجتماعي في الحالتين وأعطي للتاريخ من خلال المشاهد الحية دماً ولحماً.
حرب العاجز.. سيرة عائد.. سيرة بلد.. هل هي سيرة ذاتية للروائي أم هي جانب من هذه السيرة ، في رصد لحظة العودة بعد ربع قرن.. هل كانت عودة منتصر!، أم تراها سيرة بلد بعد التحرر من الصنم ؟
- هذا الكتاب عن عودتي بعد ٢٦ عاماً في المنفى وبعد أربعة حروب وحصار ١٣ عاماً، عدت الى البيت الذي فارقته يوم ٢٦-٤-٢٠٠٣ . عدت وجلاً من ثلاثة مخاوف بانتظاري : النسيان واللوم والموت ، أسرح بنظري الى المدينة تائهاً بين رغبتين : الرغبة في أن أرى المدينة كواقع لأفند أوهامي وتخيلاتي عنها، ورغبة معاكسة لأن أفند الحاضر وأرى من المدينة ما يعزز ذكرياتي عنها، وبين الرغبتين أتيه بين الحاضر والماضي والواقعي والمتخيل.
خلال الثلاثة عشر عاماً بعد عودتي كنت أبذل جهداً خارقاً لأجسّر الفجوة الزمنية بيني وبين البلد وناسه، أن أرى أكثر يمكنني، لكن البلد ملغوم بالمخاوف، لا مساحة فيه لوقفة تأمل ، جو الطوارئ يدفعك لأن تغادر بسرعة، فعما قليل سينفجر المكان، هذا ما يريده المهندسون الجهنميون الذين سيضغطون على زر التفجير، أن يعززوا شكوكنا بالمكان فنغادره بسرعة، في هذا الفضاء الملغوم لن تكتمل القصص ولا تأخذ مداها لذلك كنت أعيشها مبتورة بلا بداية ولا نهاية، مع ذلك كنت أفتح عينيّ على اتساعها لأستوعب أكثر ما يمكن من مشاهد، لذلك تجد الكتاب مشحوناً بمشاهد مبتورة: هذا ما رأيته وأنا أعبر بسرعة.
إضافة للمشاهدة النهمة، كنت مستمعاً صبوراً لمتحدث غير صبور يريد أن يروي كل ما رآه في أقصر وقت. حساسيتي الصحفية تحثني على أن أسأل واستمع لحكايات لم أرها. أقاطع الحكايات متوسلاً التفاصيل: ماذا ومن ومتى وأين...كيف.؟
حساسيتي كمحرر تدفعني لمتابعة كلمات المتحدثين وتعيد ترتيب السرد، أسمع وأسال نفسي: لِم كل هذه الاستطرادات التي تشتت ذهني عن جوهر الحكاية، متى سيعود لجملة الابتداء. كأنني وأنا استمع أدخل في متاهة من القصص، لم أعرف أن الحكايات الحقيقية كانت تتراكم على بعضها طوال أعوام من عالم سري، الآن رفع غطاء القدر وتدفقت الحكايات معا كالبخار.
كانت لك مشاركة نوعية في حركة الأنصار، وهي تجربة غنية، وكبيرة أرى أنها لم تنل من التوثيق والتاريخ نصيبها، وكان الأدب بعيداً عنها مثلما هي السينما مثلاً، إلا من خلال أعمال خجولة ويتيمة.. ما الذي تركته بتصورك مثل هذه التجربة على كل الصعد؟ وهل نحن بحاجة الى إعادة تقييمها؟
- ماهو نوعي في مشاركتي في حركة الأنصار كوني كاتباً، حقاً إن التجربة لم تنل حقها من التوثيق، حتى ابنتي تسألني: ماذا كنت تفعل هناك؟ حملت البندقية، لكني لم أكن مقاتلاً بالمعني الحرفي، سرت مع المجاز وأخذت مواقع دفاعية، لكني لم أكن مقاتلاً بالمعنى الحرفي.
ما تركته التجربة في داخلي ككاتب إنني قبل هذه التجربة كنت ابن مدن، ولدت في المدن وعشت فيها، علاقتي بالطبيعة ضعيفة، آكل وأشرب ما تنتجه الطبيعة وأراها كمتفرج عابر، أجهل وقت البذار والحصاد، خلال السنوات التي عشت فيها في جبال كردستان، انقلبت علاقتي بالطبيعة كلياً، صرت أنام في حضن أمي الطبيعة وأحياناً على قماشة مشدودة الى غصنين فوق مجرى الماء. استعداداً للشتاء المثلج الذي لا يرحم أقطع حطبي من الأشجار وأجمعه لتدفئة مهجعي وأطبخ طعامي، بيتي أصنعه بيدي من حجارة الجبل وطين الأرض وأغصان الشجر، تماماً مثل فلاح يصارع الطبيعة ويتحاور معها، تحت شجرة جوز أكتب يوميات صراعي مع الطبيعة وأرصد تحولاتها.
الأمر الثاني هو صداقاتي، ففي المدن كانت صداقاتي محصورة مع أبناء مهنتي، الكتّاب والفنانون، في الجبل اتسعت صداقاتي بكل الاتجاهات، مع فلاحين وعمال ومهنيين لا أعرف حتى مهنتهم، لم تكن مجرد صداقات، انما شراكة مصائر، في منافينا كنا نشكّل عصبة غريبة بين الذين لم يشاركونا التجربة، نتحدث عن تجاربنا بحماس غريب في حين ينسحب الآخرون، بما فيهم زوجاتنا لأننا سنتحدث بمفردات غريبة على أسماعهم عن مدن وقرى لم ولن يروها، وعن أدوات لم يروها.
الأمر الثالث هو الشعب الكردي الذي كنا نتعاطف مع قضيته دون أن نعرفه، أنا من بين الأقل تجوالاً، مع ذلك زرت ما لا يقل عن مائة قرية، بعضها لا يزيد عن خمسة بيوت، خلالها عرفت كرم الشعب الكردي وسعة صبره وعمق ما عاناه.
اعتبر هذه الأمور إضافات عميقة لتجربتي دخلت في صلب أحلامي، سجلت تجربتي هذه في ثلاثة كتب(أوراق جبلية، مدن فاضلة، والأنفال) ولدي ثلاثة دفاتر يوميات لم تنشر.
تواجدت كعنصر مشارك فاعل ومراقب ومثقف في انتفاضة تشرين وثقتها في كتابك (يوميات الألم والغضب).. تعرفت على شباب الساحة وأشرت الى مواقف المثقفين من الانتفاضة التي كانت متفاوتة تماماً، بعضهم مشارك والبعض محرض ومنظم، والآخر سجل حضوراً أخذ صورة ثم توارى، وهناك مَن اتخذ موقفاً معادياً لها مع السلطة حيث مصدر رزقه.. ما الذي خرجت به من هذه التجربة؟
- شاركت في مظاهرات 2011 و2015 وما بينهما، وكنت أعرف الجمهور صدرياً كان أو مدنياً ووعيت بالتجربة كيف تعيد الأحزاب الحاكمة نفسها بعد كل هزة، لكن مظاهرات 2019 فاجأتني، كما فاجأت الكل، بتوقيتها و بجمهورها وأساليبها. فاجأتني في لحظة يأس قلت فيها (لا فائدة)
فقد تمأسس الفساد وصار هو الدولة، حين نزلت الى الساحة شعرت بأنني غريب وأن هذا الجمهور الذي ملأ الساحة وما حولها غريب عني رغم إني كنت أقرّ في داخلي بأنه الشعب الشاب الذي لم أعرفه.،في البداية كنت أسير في الساحة وأنا أقيس معارفي بما أراه وفي نفس الوقت أعيد تقييم نفسي بالمقارنة بهم. بماذا يختفون عني وعن جيلي.
وأقولها بصراحة إنني كنت أخاف منهم.…حين أريد أن أركب تاكسي أختار السائق الذي بعمري أو أصغر قليلاً، لأن هذا الجيل في مخيلتي هو جيل الحواسم، في الساحة وخلال الحوارات معهم عرفت لأول مرة الجوهر النبيل فيهم، وعرفتهم أكثر حين استبدلوا شعار(نازل آخذ حقي) بشعار (أريد وطن). عرفتهم خلال أفعالهم الشهمة وهم يرفعون جريحاً سقط على الأرض قرب الحاجز وكيف يعاملون امرأة شاركتهم الاحتجاج، وحيف كرسوا التكتك مصدر رزقهم لإنقاذ الجرحى ونقل الشهداء، وكما قلت في كتابي عنهم «روح التعاون في الساحة في أعلى تجلياتها، كُّل واحد يريد أن يقوم بعمل ما، البطالة الطويلة والطاقة المحبوسة تريدان أن تفعلا وسط مهرجان من الأفعال، أمشي على الأرض التي يمشي عليها الكل، أقلص جسدي ليشغل أصغر حيز كي أمر وسط الحشد، هناك من يرشدني لطريق أقصر بحيث أدخل ثلاث (تكاتك) لأعبر إلى الجهة الأخرى، رفعت رأسي فرأيت برجاً من شباب يصعد من الساحة حتى الطابق الأخيرمن المطعم التركي. شبان لم أتعرف عليهم، كنت أتحاشاهم، وأخطأت بحقهم، يحاذونني في مسيري أو يقطعون طريقي، شبان وقفوا فوقي ينظرون لهذا الكهل المتعثر الخطوات الحائر وسط دنياهم: ماذا يفعل هنا؟ للحظة واحدة رفعت رأسي وفكرت بأن أكون شاباً مثلهم، للحظة فقط، فوجدت ثلاثة أياٍد ممدودة إلّي. قَّدمُت يدي فتلاقفوني بينما كانت يدان ترفعانني من تحت. خلال هذه اللحظة حصلت على ثلاثة ألقاب (حجي وعمي وأستاذ).
برأيك هل الالتزام يقيده الكاتب أم يحدّ من حريته؟
- منذ مراهقتي كنت ملتزماً وكما يقول المثل (ثلثين الولد على خواله)،علاقتي بالحزب الشيوعي بدأت منذ العشرينيات غادرت الحزب وعدت إليه ثلاث مرات، ودائما تجذبني فكرة مشاركة آخرين في أهداف مشتركة، وحدي ومع الجمع تعتني رواياتي بشخصيات متعددة ومتوافرة.
تزداد هذه الآسرة حين يكون الحزب في محنة، مع الحزب أو حركات التحرر التي شاركت فيها عشت على الدوام تجربة الثورات المحبطة، ولذلك تنامى لدي الخوف من الانتشاء المنتصر ، انظر للقمة فأتهجّس الهاوية التي تليها، قريحتي الروائية تتبّعت الثورات وهي ترتجف على القمة وإذا أردت أن أتفاءل عن عمد سيأتي الأمل رمزياً وليس حقيقياً، مشيت ملتزماً بالفكرة، ولكن الرواية مثل الحياة تعاند الفكرة المسبقة، تقلّبها وتفندها أحياناً. حين أكتب أتتبّع هذا الخط المرتجف المرتد السائر مع خط الدم فأساند الرواية في صراعها مع الفكرة، وعلى ما يقول الشاعر (سعدي يوسف) أمشي مع الجميع وخطوتي وحدي.