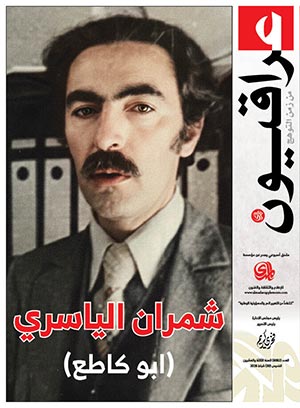شاكر لعيبي
في البدء يجب القول إن تلك النسخة التي نسميها "المسوّدة" يمكن أن تكون باباُ للاطلاع على أسلوب الأديب، فالأسلوب يظل دائماً هو نفسه، هنا وهناك. لماذا يتغيّر في المسوّدة؟ لكن وقبل ذلك فالمسودّة فسحة للاطلاع على كواليس عمله. إذا كانت الكواليس مَشْغلاً لما هو غير مُعْلَن، للسريّ والممارسة المنفلتة تقريباً من الرقابة الثقافية والاجتماعية، فإنها في كواليس الكتابة مصدر للغريب أحياناً. إنها تعلن في بعض الحالات أن الكتابة هي نوع من الصناعة بالمعنيين المُشْرق (الفن) والآخر الأقل إشراقاً (الحرفة). مما أتذكّره جيداً في المقام الملتبس للمسوّدة أن خروج المثقفين من بيروت بعد حصارها عام 1982 دفع أحد الشعراء الذي كان يسكن في شقتي إلى ترك دفتر مسودات ضخم، للتخفيف من حمل الخروج. ولقد اطلعتُ عليه من باب الفضول. ماذا وجدتُ فيه؟ أنه كان يجمع فيه كل جملة نثرية باهرة يقرأها (من روايات عالمية مترجَمة غالباً) وقد فهمتُ - لأني أعرف شعره جيداً - أنه كان يعيد صياغة الجمل شعراً موزوناً حيث كان يكتب شعر التفعيلة، إضافة لعثوري على سلاسل طويلة من المفردات ذات الروي الواحد (القوافي) لكي يستخدمها في شعره نفسه. كنت أمام نوع من الصدمة غير السارّة بالضرورة، لأني كنتُ أظنّ أن شعره ناجم عن عفويةٍ وتلقائيةٍ. لعل انطباع عفوية كتابة الشعر في أذهاننا ليس صحيحاً، ولعل الكثير من الشعراء يقومون بأمر مماثل بدرجاتٍ، بعضها مقبول تماماً وسليم. منذ أقدم عصور الشعر العربيّ كان يجري (تنقيح) و(تشذيب) الأصول الشعرية، ونحن لا نعلم فيما إذا كان هناك شيء مشابه لما وقعتُ عليه في زمن بيروت.
ما زلتُ أحتفظً بدفتر مسودات وحيد محض مصادفة. البقية أتلفها، فالنص الأخير غير المتلف يخرج أحياناً مغايراً لمسودته، كأن المسودة توشك أن تكون (دافعاً)، (إمساكاً) بتلابيب حالة أولية (صافية) لكن غير (مُصفّاة). قليل من مسودات النصوص الشعرية تكون مُصفَّاة حقاً. ذلك أن خيار المفردات في ثقافة تعج بالمفردات والمرادفات وتاريخ متموج لاستخدام الكلام يحتاج إلى توقف وتأمل أحياناً. كتبتُ الكثير من قصائد مجموعتي (الأدنى والأقصى) في محلّ اسمه (الباشا) في مدينة قابس جنوب تونس. كنت أكتبُ يوميا تقريباً على الغطاء الورقيّ الأبيض للطاولة التي أحتسي عليها شرابي، من قصيدة إلى ثلاث. كنت أقوم بقطع الغطاء وفق المكان الذي كنت أكتبُ عليه، حتى أن العامل كان يندهش من هيئة الغطاء الورقي بعدئذ. في مكتبي في المنزل أعاود قراءتها والعمل عليها. أو تجاهل القليل منها، ثم إتلاف المسودات جميعها. هذا مصير ملائم للمسودة إلا إذا كانت هناك ملاحظة أو جملة أو صورة مثيرة أفلتتْ من التشكُّل اللحظويّ فتُركتْ عائمة على ورقة المسودة جوار نص ما. بعض هذه الجمل اليتيمة تبقى دائماً يتيمة: إنها نتاج لحظة خاصة لا يمكن (خلق) سياق آخر لكتابتها في نصّ مكتمل.
غالبية المثقفين، في ظني، يستخدمون أذهانهم وذاكرتهم بمثابة مُفكّرة (هذا هذه المفردة مرادف للمسوّدة؟)، خاصة فيما يتعلق بالنصوص القائمة على الخيال والاستعارة والحلم: الشعر. الشعر هو (حالة) بالمقارنة مع الرواية أو الفكر الخالص. وإذا ما أتيح لي أن أسوق مثالاً شخصياً مرة أخرى، أذكرُ أني في مينة جنيف كنت أستخدم طيلة حياتي درّاجة هوائية للتنقل. ذات مرة أثناء قيادتي مسرعاً للدراجة، انفجرت في ذهني حالة يمكن أن نسميها (عربيّ على درّاجة هوائية) ورنّت أْبياتها، فتوقفتُ عند أقرب مقهى وشرعت بكتابة النص، الطويل، دون مفكرة ملموسة، الذي صار عنوانه (عربيّ على درّاجة هوائية). بالطبع وقع أيضاً تشذيبه فيما بعد.