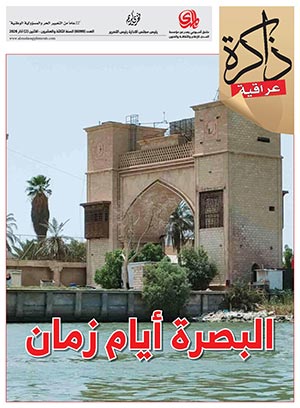أحمد حسن
حينما يقف العقل أمام الظواهر الاجتماعية التي نشأت عن الدين، يثور السؤال: هل الدين، في جوهره، حركة إنسانية تسعى للعدالة، أم أنه يتحول حتمًا إلى مؤسسة تخدم مصالح السلطة؟. هذا السؤال لا يُطرح من باب إنكار الدين، بل من باب التفكر العميق في جوهره وتاريخه. إن العقل، حين يتأمل ظاهرة كالتشيع، يواجه حقيقة مزدوجة: حركة ولدت من رحم المقاومة للظلم، لكنها عبر الزمن خضعت لتحولات جعلتها جزءًا من بنيان السلطة.
هنا يتعين علينا، بوصفنا باحثين أو أكاديميين، أن نقف موقف الملاحظ لا المتحيز، موقف من يشكك فيما يراه ليعيد بناء الحقيقة وفق أسس جديدة. وإذا نظرنا إلى ما قدّمه علي الوردي وعلي شريعتي، نلاحظ أنهما قدما قراءتين مختلفتين لكنهما متقاطعتين لظاهرة التشيع، قراءتين تهدفان إلى تحرير الدين من قيوده التاريخية وإعادته إلى أصوله الثورية.
هل يمكن للعقل، إذ يتبع مسارًا منهجيًا، أن يُعيد اكتشاف المعنى الأصيل للتشيع؟ أم أن التاريخ قد أغلق الباب على إمكانيات التجديد؟ لن يكون من الحكمة تقديم إجابة متسرعة، بل ينبغي أن نبدأ بتحليل الجذور والتأمل في المسار التاريخي، تمامًا كما فعل الوردي وشريعتي، لكي نفهم كيف تحول الدين من أداة للثورة إلى مؤسسة محاطة بالطقوس.
الوردي، المفكر العراقي الذي ارتكز على السوسيولوجيا لتحليل المجتمع، كان يقرأ التحولات الدينية ضمن سياقها التاريخي والسياسي. بينما شريعتي، الفيلسوف الإيراني الذي انصهرت أفكاره مع الثورة، سعى إلى إحياء التشيع كطاقة تحرر ضد الظلم، متخذاً من كربلاء رمزاً للمقاومة.
شريعتي صاغ رؤيته عبر مفهومين أساسيين: "التشيع العلوي" و"التشيع الصفوي". الأول، بالنسبة له، هو حركة مستمرة تسعى للعدالة وتستلهم من تضحية الحسين في كربلاء مشروعاً ثورياً لا ينتهي. أما الثاني، فقد رآه انحرافاً عن جوهر التشيع، حيث تحوّل إلى أداة بيد السلطة الصفوية لإدامة نفوذها من خلال الطقوس والمظاهر الشكلية.
على الجانب الآخر، الوردي كان يرى الظاهرة من زاوية أكثر واقعية وربما أقل رومانسية. في تحليله، الطقوس لم تكن سوى انعكاس لاحتياجات اجتماعية وسياسية فرضها تاريخ طويل من الصراعات والضرورات. الدولة الصفوية، في رأيه، لم تخلق التشيع الطقوسي، لكنها وظّفته كوسيلة لتكريس هويتها السياسية في مواجهة الدولة العثمانية.
شريعتي كان أكثر صراحة وحِدة في نقده لهذا التحول. يرى أن البكاء على الحسين، الذي كان ينبغي أن يكون خطوة أولى نحو الثورة، أصبح نهاية الطريق. يقول: "البكاء ليس غاية، بل وسيلة لإشعال النار في ضمير الأمة". بالنسبة له، الطقوس التي تغرق المجتمعات دون هدف تحرري هي أقرب إلى أدوات لتخدير الشعوب، تحول الدين إلى مؤسسة مغلقة تخدم مصالح السلطة.
أما الوردي، بأسلوبه الساخر، فقد تساءل: كيف تحولت الطقوس من شعائر لإحياء الروح الثورية إلى مجرد عادة اجتماعية تستنزف الطاقة؟ يقول في أحد تحليلاته: "عندما ينفصل الدين عن حاجات الإنسان الحقيقية، يتحول إلى مؤسسة جافة لا تحرك سوى قشور المجتمع".
الاختلاف بين المفكرين يتجاوز المنهج، لكنه يشترك في تشخيص واحد: التشيع بدأ كحركة مقاومة ضد الظلم والاستبداد، لكنه بفعل التاريخ والسياسة أصبح أداة للهوية السياسية أو وسيلة للهرب من الواقع عبر الغرق في الطقوس.
شريعتي، بفضل تأثره بالماركسية والوجودية، طرح رؤية مختلفة للدين. استلهم من ماركس مفهوم التحرر، لكنه عارضه في اختزال الدين بـ"أفيون الشعوب". كما استفاد من ماكس فيبر في النظر إلى الدين كقوة اجتماعية قادرة على التغيير. وفي الوقت نفسه، حملت رؤيته بعداً وجودياً يركز على المسؤولية الفردية في مواجهة الظلم. أما الوردي، فقد كان أكثر ميلاً إلى قراءة التحولات الدينية عبر نظريات اجتماعية تقليدية، لكنه لم يكن بعيداً عن استشراف دور الدين في مجتمعات تعاني من صراعات متراكمة.
رغم اختلاف الأدوات الفكرية التي اعتمدها علي الوردي وعلي شريعتي في تحليلهما لظاهرة التشيع، يلتقي كلاهما عند نقطة محورية تتعلق بجوهر الدين ودوره في حياة الإنسان والمجتمع. فكلاهما يعتقد أن الدين، إذا فقد طاقته الثورية التي انبثق منها، فإنه يتحول تدريجيًا إلى مؤسسة شكلية تفقد غاياتها الكبرى، وتُختزل في ممارسات طقوسية تُفرغها من محتواها التغييري.
شريعتي، بنزعته الثورية وأسلوبه التحريضي، يرى أن المشكلة تكمن في تحول الدين من وسيلة لتحرير الإنسان إلى أداة لتكريس الطغيان. بالنسبة له، لا يمكن فصل الطقوس عن السياق الاجتماعي الذي تُمارس فيه، إذ إنها غالبًا ما تصبح وسيلة لطمس الوعي الجمعي بدلًا من إحيائه. من هنا، يدعو شريعتي إلى العودة إلى التشيع العلوي الذي كان في جوهره حركة ثورية ضد الظلم، رافضًا ما أسماه بـ"التشيع الصفوي" الذي خدم السلطة وجعل الطقوس أولوية على القيم.
أما الوردي، بمنهجه السوسيولوجي الناقد، فقد ركز على العوامل التاريخية والاجتماعية التي دفعت الدين للتحول إلى مؤسسة بيروقراطية تخدم مصالح القوى الحاكمة. الوردي لا ينكر أهمية الطقوس، لكنه يعتبر أن التغير في غاياتها يعكس تحولات أعمق في بنية المجتمع والدولة. من وجهة نظره، فإن الطقوس لم تكن دائمًا عائقًا أمام الثورة، لكنها تصبح كذلك حين تُستغل لتثبيت السلطة وإخماد الروح الثورية.
هذا الالتقاء بين الوردي وشريعتي، رغم اختلاف مشاربهم الفكرية، يثير تساؤلات جوهرية حول علاقة الدين بالتاريخ. هل يمكن لأي دين أن يحافظ على طاقته الثورية في وجه تقلبات الزمن؟ أم أن التحول إلى مؤسسة طقوسية هو المصير المحتوم لكل حركة دينية؟.
الإجابة ليست بسيطة، فالدين في جوهره يتأرجح بين القيم المطلقة التي يدعو إليها والواقع النسبي الذي يتفاعل معه. من جهة، تحمل الحركات الدينية بذور الثورة والتمرد على الظلم، ومن جهة أخرى، تخضع تلك الحركات لقوانين التاريخ والاجتماع التي تميل إلى تحويلها إلى كيانات منظمة تسعى إلى البقاء على حساب المبدأ.
لعل الوردي كان أكثر واقعية في تحليله، حيث اعتبر أن التحول الطقوسي للدين هو انعكاس لاحتياجات اجتماعية وسياسية أعمق. بينما كان شريعتي أكثر طموحًا في دعوته لاستعادة جوهر الدين الثوري، متجاهلًا في بعض الأحيان تعقيدات التاريخ والواقع الاجتماعي. ومع ذلك، تبقى أطروحات الاثنين تلهمنا للتفكير في إمكانية إعادة قراءة الدين بوصفه مشروعًا إنسانيًا يهدف إلى تحرير الإنسان لا إلى تقييده.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل يمكن للدين أن يتحرر من أسر الطقوسية ليعود إلى جذوره الثورية؟ أم أن هذا التحول، كما أشار الوردي، هو حتمية تاريخية لا يمكن تجنبها؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب منا النظر بعمق في العلاقة بين الدين والسلطة، وبين الطقوس والقيم، وبين التاريخ والمبادئ التي نشأ الدين من أجلها.