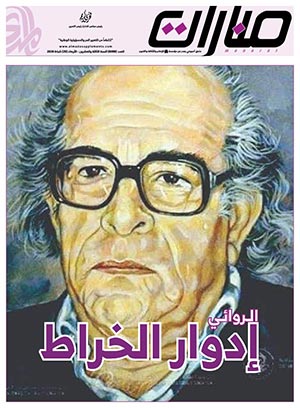يتناول الباحث السياسي كل الأسباب التي تقوم في أساس الخراب والتدهور والتخلف التي تصيب الأنظمة السياسية في العالم العربي والإسلامي، الا علاقة ذلك بالثقافة والمثقف، ودورهما والموقف منهما.ويدور البعض أحياناً، على استحياء، حول الثقافة نفسها، ليكتفي بالاست
يتناول الباحث السياسي كل الأسباب التي تقوم في أساس الخراب والتدهور والتخلف التي تصيب الأنظمة السياسية في العالم العربي والإسلامي، الا علاقة ذلك بالثقافة والمثقف، ودورهما والموقف منهما.
ويدور البعض أحياناً، على استحياء، حول الثقافة نفسها، ليكتفي بالاستنتاج بان تراجع الثقافة بالمعنى الواسع، بوصفها عملية بناء وتحديث، يرتبط بالموقف السلبي للسلطة، منها ومن الوسط الثقافي، متناسياً ان العملية الثقافية هي قاعدة البناء وجوهر التطور، وبها يمكن قياس محتوى السلطة السياسية، ومستوى إدراكها لمتطلبات النهوض بالمجتمع والأساليب الضامنة والمؤثرة في تحفيز قواه وتحفيزها.
وإذ ندرك العلاقة الترابطية والتبادلية بين عملية التطور الاجتماعي - الاقتصادي، والبنى السياسية التي تؤطرها، نرى بوضوح تميّز مكانة الثقافة ودور المثقف وتأثيرهما في اللحظات الانعطافية، التحولية في المجتمع من خلال مظاهر ضمور وانزياح قوى التخلف والجهالة، وتجرؤ الأفراد والجماعات على رفض ما يتبدّى عليه البلى، وتفكيك الشبكات الاجتماعية التي تشكل حواجز معرقلة للنزوع نحو التطور.
وتلعب الثقافة، بالمعنى الضيق الإبداعي، بتجلياتها في مختلف فروع المعرفة الإنسانية، كالشعر والرواية والتشكيل والمسرح والسينما والتعليم والاستعادة الإيجابية للتراث، دورا محورياً في نهضة المجتمعات والامم، ورافعة لانزياح القديم البالي، وحاملة للقيم الجديدة.
ويضعنا النظام الحالي، والسلطة السياسية المعبرة عن قيمه، امام استعادة "اطلال" الماضي، الذي يبدو في كل مجال من مجالاته بالمقارنة مع الحاضر المعاش، انجازاً انسانياً فجّر الطاقات الخلاقة في المجتمع العراقي، ورفع من سويته وتشوفاته الى رحاب الحضارة البشرية المعاصرة. والخيبة مما عليه الحال، لا تتمثل في "السكون" الذي صار عليه المجتمع العراقي منذ تصفية الشمولية المستبدة السابقة، التي أطيح بها في نيسان عام ٢٠٠٣ بفعل عامل خارجي طغياني، بل بالاتيان على ما تبقى من التراث الانجازي في كل ميادين الثقافة بالمعنيين، الابداعي والواسع، وتخريب القيم التي شيدتها، والتعمد في تشويهها وتلويث رصيد حواملها في المجتمع والجسد الثقافي.
ولو استعدنا خمائل مراحل الصعود السياسي، الاجتماعي - الاقتصادي، بُعيد تشكل الدولة العراقية شبه المستقلة في اواسط العشرينيات من القرن الماضي، لتلمسنا بواكير النهوض اللاحق والدور الريادي للثقافة في تدفقاته، ومدها بعناصر الانفتاح على الجديد والنمو والازدهار. ولاتضح لنا كيف أصبحت القيم الابداعية التي انتجتها الثقافة، منابع لإنتاج وتجديد ادوات المجتمع، في السياسة وفي النزوع التقدمي، وفي اشاعة الوعي بالحقوق والحريات والإرادة الحرة.
واصبحت تلك الحقبة المضيئة ذاكرتنا المتوهجة، نسترجعها كلما راودتنا الشكوك بقدرتنا على تجاوز الحال التي اصبحنا عليها، ونستعيذ بها من رثاثة ما ينتجه لنا النظام السائد، من ادوات وقيم متخلفة، ونتغنى بأطلالها الشامخة كلما دفعتنا الحاجة المعنوية "لِمَسٍّ" من املٍ يفتح علينا باب المرتجى، مستوراً بالمؤجل. وفي كل مرة نعود فيها الى تلك الاطلال التي كانت عليها الثقافة والمثقف في زمن التغييرات العاصفة، نجد ذلك التماسك الذي كان عليه النسيج الاجتماعي، والذي توَحَدت فيه الهويات الفرعية، وتداخلت عناصر ثقافتها في بوتقة واحدة، لتشكل روافد لثقافة وطنية عراقية، تراصت فيها ومن حولها، كل المكونات والاعراق والنزعات والآمال والاماني.
ويومذاك، انتج الشعر العراقي، الذي كان يشمخ فيه الجواهري، والتشكيل، بقامة جواد سليم والرواد الأوائل، الحداثة العربية، وتدفقت الرواية والمسرح والسينما، بإضاءاتها، لتُغني بما أنتجته صروح الثقافة العربية.
كان الاسلام رحباً، ومذاهبه روافد سمحة يتقوى بها المجتمع في مواجهة عدوه الخارجي، ويتسلح بغزارة ايمانه في محاصرة الظلم الاجتماعي والطغيان والتمايز الطبقي الفظ ضد الاقطاع والكمبرادور والسلطة الاستبدادية.
وكانت الاديان المتجاورة مع الاسلام، اكتمالاً للرسالة السماوية، وتكويناً تنوعياً يتكامل مع التنوع القومي والاثني والمذهبي، لتتعزز بها مناعة الوحدة الوطنية العراقية، التي خاض بها الشعب غمار كفاحه ضد الاستعمار والامبريالية، وحقق بالاعتماد عليها انتصاراته في الوثبات والانتفاضات المجيدة، وفي معارك الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
لم يكن لاحد من العراقيين، أن ينبش في ضمير العراقي، ولا يبحث في هويته "دينه ومذهبه"، واذا شاء أن يغتني بمعرفته الشخصية، فإنه يتطلع في لون بشرته، التي يتغنى بتدرجاتها المغنون، اذا كان "اسمر أبو عيون وساع" او "ابيض" لا يدانيه جمالاً غير العراقي.
وشكّل التعدد العقائدي والسياسي، في زمن الصعود والرقي ذاك، مساحة مضيئة يجري التنافس فيها على القيم الوطنية والتضحيات دفاعاً عن حقوق الشعب، أو الكادحين والمهمشين، او تكريساً للمفاهيم والمبادئ التي تجمع القوى وتوحد الأهداف والأماني المشتركة.
والشعائر الدينية والمذهبية ومنابرها وخطباؤها، كانت توظف لصياغة الشعارات المشتركة ونشر مفردات ومفاهيم التوجهات والبرامج الوطنية. وكل مناسبة منها شكلت إطاراً لفضح الفتن التي سعت لبث الفرقة الدينية والمذهبية والطائفية ولتشتيت القوى. وهكذا كانت أعياد المسلمين والمسيحيين والمكونات المتآخية الأخرى.
في الزمن الثقافي المضيء ذاك، كان المفكر والناقد والباحث، يكتب ليعمم قيماً ابداعية جديدة. والروائي يؤلف ليشيع بين الناس نماذج إنسانية بطولية، تتحدى الظلم والتخلف. والفنان، في السينما والمسرح والتشكيل، يخلق بالصورة والحركة واللون، أنماطاً حياتية تتوثب حيوية واندفاعاً وتطَلُّباً، وهي تخترق بنماذجها الحاضر إلى المستقبل. كان هؤلاء جميعاً مبدعين خلاقين، يبتكرون من وحي الواقع وانعكاس ما يتمثلونه في حركته، مضمخاً بحس الضمير، ورهافة الشعور الوطني والانساني العميق، بطلات وأبطال واشكال وتلوينات، ترمز للتوق لكل ما هو جديد، وما يشكل حافزاً لاكتشاف الذات، واستشراف المستقبل. لم يكن الخلق والابداع في زمن التوهج، قد تحول الى سلعة، او بضاعة معروضة للبيع. ولم يكن المثقف "حرفياً" مكشوفاً، قابلاً للمساومة او المقايضة، بما يمثله أو ما ينتجه.
والعلاقة بين عملية الابداع والخلق، حتى في لحظة فرادتها، كانت خياراً مسوراً بالحصانة والتمنع والتحدي ازاء كل اغراء او تنازلٍ وتهادن، مع السلطة او مع مراكز القوى في المجتمع. كان الابداع الثقافي، والمثقف نفسه، تجسيداً للاستعصاء التاريخي في المنازلة بين التخلف والتقدم، بين الماضي والمستقبل.
والسياسة في زمن التنوير ذاك، كانت في جوهرها وأدواتها، عملاً ثقافياً فكرياً إبداعياً بامتياز، يكتشف السياسي، بأدواتها وآلياتها، منصات نشاطه وخياراته.
والتنوع الثقافي - السياسي، كان يستمد غناه من التعدد والتنوع في المجتمع، ويستنير بطيفه ويعبر عن نبضه، ليتحول في نهاية المطاف الى مصهر للإرادات، ونولٍ لنسيجٍ اجتماعي سياسي يرسم المستقبل ويمد خطواته بأسباب الحيوية والتدفق.
ألم يكن هذا الدور للثقافة والمثقف تاريخياً، معجلاً لقوى الظلام، بدءاً من وثوب البعث في شباط ١٩٦٣، مروراً بتعاقب الأنظمة المستبدة، وصولاً إلى الجهالة والتفسخ والفساد الراهن، ووراء تدمير وإقصاء عناصر الثقافة والمثقف من الحياة الاجتماعية والسياسية وتهميشهما، وخنق أي مسار أمامهما للتفتح من جديد..؟
وهل يمكن أن تكون سلطة فاسدة، مغرقة بالفساد والقيم المتخلفة، محمية بالتابوات الغيبية، كارهة ومعزولة عن الثقافة ومنارتها، على غير ما هي عليه اليوم، كما نتعايش معها، ويستكين لها البعض؟
إلى أي حين سنظل نهرش جلودنا، ونحك فروة رؤوسنا، بحثاً عن لحظة تحولٍ في الحياة الثقافية، وفي إرادة وموقف المثقف، للوثوب من سكونه او خدره الى الفعل الإبداعي الذاتي في قلب عملية التغيير والتحديث، يسهم من خلال ذلك في انتشالنا من أطلال الماضي الجميل، الى ضفاف استنهاضٍ ثقافي إبداعي، يعيد خلق وعي في المجتمع فينفض عنه قناعة الرضوخ، ويفتح عليه دروب التلاقي على مساحات مضيئة، تنعطف به وتزيل ما يعترضه، من أدران وفساد وحماقات أشباه الماضي وحوامل التخلف؟
متى سننفض عنا رجس انتظار الأمل من السلطة، خارج فعلنا الثقافي، ونتلوى على دروب الفقدان التي تقودنا إليها، بعض أسلاب إغراءاتها؟