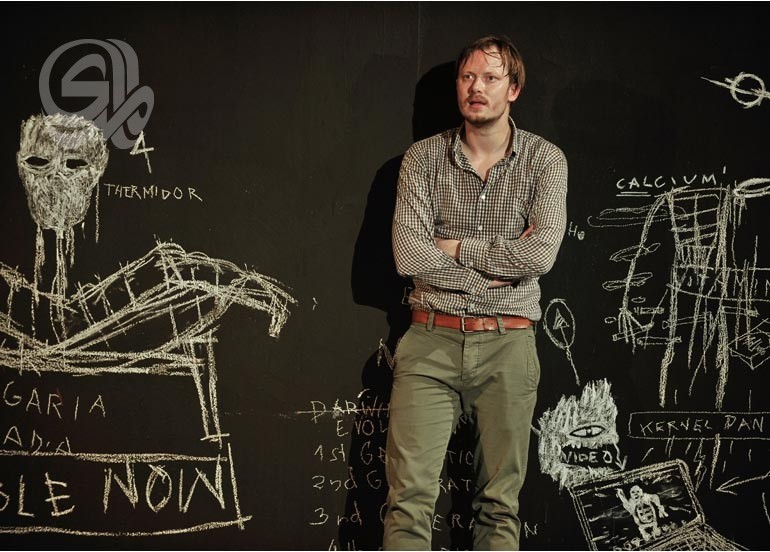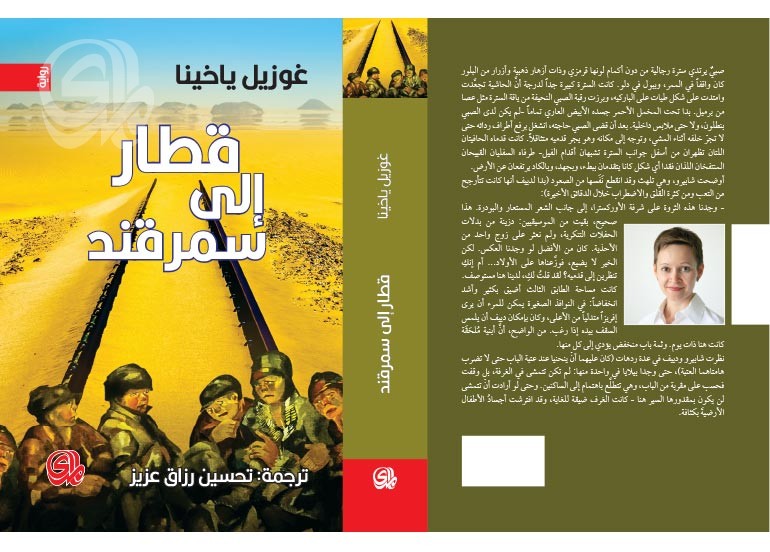طبيعي هو الاعتزاز بما تأكدت صلاحيته. ومعلوم ان هذه الصلاحية أكدتها التجربة والمدى التاريخي الذي تم فيه الانتفاع مما حصل الاعتزاز به. هذه الايجابية، هي التي وراء الاعتزاز. التقليد الاجتماعي والادبي- الفني، كما هي نفسها وراء الاعتزاز بالتقليدية الدينية
طبيعي هو الاعتزاز بما تأكدت صلاحيته. ومعلوم ان هذه الصلاحية أكدتها التجربة والمدى التاريخي الذي تم فيه الانتفاع مما حصل الاعتزاز به. هذه الايجابية، هي التي وراء الاعتزاز. التقليد الاجتماعي والادبي- الفني، كما هي نفسها وراء الاعتزاز بالتقليدية الدينية او المذهبية.
قد يرد سؤال يستفزنا: "ولكن كم يمكن ان يكون عمر هذا التقليد ليصبح قديماً، أي تنتهي فائدته او صلاحيته؟" جوابنا ، التقليد كان جديداً بدأ ظهوره، كان يترعرع واحتُفي به حين امتلك حضوراً أكبر، ووُقِفَ ضده!
هذا يعني انه يقع ضمن المسيرة التاريخية للأفكار والفنون والنظم وطبائع العيش والحراك الاجتماعي والتقليد، ايّ تقليد جديد في بدء ظهوره هو من خلق "الصفوة"، الصفوة في الأدب، في الفن، في الفكر والنظم. نحن إذن ضمن سلسلة متوالية من "التقليديات"، الواحدة ترث الاخرى او تزيحها. الافتراض بان هناك تقاليد traditions ثابتة وأزلية هو افتراض بإيقاف التطور البشري. كما ان الافتراض بان هناك تقاليد ادبية ثابتة هو إلغاء غير ذكي لتاريخ الادب وتطور الفنون.
كما ان ذلك الافتراض يظهر لنا كما لو ان هناك محطات ميتة، او متوقفة في التاريخ البشري. علينا ان نحسم المسألة بالقول: لا يوجد تقليد ازلي مصون ولا تقليدية دائمة. كل تقليد يتلقى دائماً مؤثرات تثلم مرتكزاته بدرجات مختلفة. وهو في جميع حالاته مشوب بما سيطوره او يغيره!
لهذا يكون القول الحماسي، الساذج ايضاً، بضرورة حماية تقاليدنا ومن بعد ديمومة التقليدية، قولاً مفيداً في ظاهره وضاراً ومؤذياً لحركة المجتمع في حقيقته. إدامة التقليد، أي تقليد، يقابله منع للتطور والتغيير. وإذا كان المقصود من ذلك القول هو الخوف من الثقافة الطارئة او المختلفة وما يصلنا من العالم، فهذا الخوف تصطنعه وتضخمه المؤسسات المنتفعة من ثبات التقليدية في الحكم والأنظمة والأفكار. هذه هي التي تجعل من الثقافة الحديثة القادمة رهاباً. هم يقفون بخساسة احياناً ليمنعوا انتفاعنا من مكاسب العالم الحضارية. هم يكرهون الأفكار والفنون الحديثة. يكرهون الجديد من الأزياء الى تسريحات الشعر الى الموسيقى الى الحريات الشخصية و حقوق الانسان. وهذا بالتأكيد اتجاه رجوعي على نقيض تام من الرغبة في التقدم والتجديد. أي نزوع تقدمي للتغيير والتجديد هو ضد التقليدية في جميع انواعها، ومنها التجارب الادبية والعرف والممارسات الاجتماعية (الدينية ضمنا) ..، صعب هو التحديد أيها "الوطني" منها وأيها "الأصيل" او أيها الأنفع للشعب. نحن نتحفظ من هذه الحجج التي تُمارس عادة في الجدل. الماضي المترسخ صنع أُلفةً وعلاقات مع المجتمع. والأُلفة والعلاقات انتجا اطمئناناً كما انتجا منافع. والناس دائماً حريصون على استمرار الاثنين. المرء لا يستطيع تغيير عمله او مخزنه او ورشته بسهوله او من دون تردد ما دامت ضامنة لعيشه، واستقراره. هو لن ينصاع للجديد إذا لم يحاربه. من يتبنى الجديد هنا هو المغامر. في لغتنا اليوم الطليعي.
المسألة المعوّقة ليست هي ضمن الانتفاع فحسب. معها، الاكثر خطورة ربما، هي إثارة الموالين للتقليدية الراسخة والدخول في مواجهة مع الضد. بعض هذه المواجهات كانت مسلحة وبين المثقفين وصلت احيانا الى درجة الابتذال. ولأن بين أفراد جبهة الضد، موالاة وتكافلاً اجتماعياً وفكرياً، فستكون جبهة المعادين كبيرة، وستكون النتيجة، آنياً، رفض المجتمع للطارئ الغريب ثم تتحول رفضاً قمعياً!
لا أحد يستطيع، ضمن ثقافة اليوم، تحديد ايها الأصيل وما هي المحّددات والصفات اللازمة؟ وهل هي الجدوى الاجتماعية العامة، ام جدوى النخب ام امتيازات الصفوة؟ أم، وهذا أمر آخر، هي نزعة المخالفة، وهنا يكون المخالف، اما ساخراً من حال قائم او متضرراً او داعية تغيير؟ طبعاً الظاهرة الفردية قد تجلب انصاراً ومماثلين. نحن طبعاً لا نستطيع تقويم (تقييم) الأمور على وفق احترامها للتاريخ، والتاريخ الاجتماعي تحديداً . لأن التحديد والقياس بمعيار النفع التاريخي، قياس باطل لقلقه وعدم ثبات مؤشره.
حركة التقدم الانساني ترفض ذلك. هي أساساً ضده لكي تتقدم. ونحن لا نستطيع، او لا نرتضي التضحية بالمستقبل من أجل ماضٍ ابتعد ومازلنا نستعين بإنتاجه. قد يدخل هنا، وكثيراً ما يحدث هذا، في حركة المفارقات، في الرياء الاجتماعي بادعاء مصلحة الناس وأمنهم مما يخرّب عالمهم المستقر. وهذا الكلام ذو حدّين، فهو يدعو للسلام الاجتماعي و"الاستقرار" ويمنع التغيير "القادم" والتجديد. وبما نمتلك اليوم من آلية اعلامية ضخمة، يتحول الموقف الرافض الى قوة قمعية واسعة، الى رهاب غوغائي ضخم. بهذا يصل عمل العقل "الفاضل" الحريص على "الاستقرار" الى حال يحاذي به الجريمة، جريمة مواجهة المستقبل. وبهذا نكون بين جبهتين، هي الرجعية، لا المحافظة، في جانب والمستقبلية في جانب آخر.
كما اتضح، ليست الرجعية بلا فلسفة هي تعتمد الراسخ المُطمَأَن له والضامن لاستمرار منافعها واستقرارها وتقف ضد ما يهدد تلك الثوابت من قادم "مغامر" مجهول او غير مضمون النتائج، أو غير مضمون المنافع! وهذه فلسفة، يمكننا احترامها، اعتماداً على عموم المضمون. لا مانع من احترامها عند هذا الحد. لكن الخطورة تحوّلها بحكم هذا التركيب الفكري الى مانع جبهوي واسع ضد التقدم ضد وصول المكاسب الحضارية والفكرية الجديدة.
وهنا نضطر لإسقاط الاحترام وكسر السد العازل. لا فكرا متنورا وانسانيا يقف ضد استمرارية التطور!
هذه الإشكالية تتفرع منها اشكاليات داخلية، لان النزوع البشري، على ما يبدو، هو الحفاظ على المتيسّر، على ما يُمتَلك: كهف، كوخ، بيت، مزرعة، ومنها التراث الثقافي. ولهذا نجد أن الطليعيين في مرحلة ما، الذين جاؤوا بثقافة جديدة، هم ايضاً عملوا على ترسيخ تلك الثقافة التي كانت جديدة وعملوا على الحفاظ عليها وصاروا من بعد يريدونها ان تبقى! فئة الجديد المسيطر، بهذا الاعتبار، ستصير لها تقاليد قد يقاتلون للحفاظ عليها وابقائها تحت اسماء مختلفة، قد تكون باسم "مكاسب الثورة" او بأي اسم منافق آخر.
الشيوعيون اللينينيون تمردوا، او تقدموا على "ماركسية" ماركس. وأولاء لم يرتاحوا لتنظيمات ورؤى ستالين، وان عموماً استجابوا لها. والماركسيون الجدد في العالم اليوم، الفرنسيون على وجه الخصوص، يلتقون مع اللبراليين في مزاعم اساسية من تفكيرهم. كما ان الديمقراطية اللبرالية للولايات المتحدة اليوم تريد ان تسود وتُعلن انها تريد ان "تترسخ". وعبارة "تقاليدنا" الديموقراطية، عبارة تتكرر في الكونغرس والمحافل الثقافية. ومثلما لهذه الدعوة إيجاب، لنشر الديمقراطية، فيها سلب كامن في عبارة "تترسّخ" التي تذكرنا بالنزوع المحافظ والرجوعي الذي اشرنا اليه.
نحن لا نستطيع في تنازع الأفكار ان نجد حكماً عدلاً ولاقضاءً محايداً. هي كلها أفكار انسانية وكلها تسعى لإقرار النفع الاجتماعي والسلم المجتمعي وضمان مستقبل الأجيال ولا نستطيع تكذيب أي منهم. الجميع يرتكزون على هذه الأهداف. المتخاصمون إذن يشتركون في الأهداف ويختلفون في الإجراءات. بالنسبة للفكر المحايد، بالنسبة لي، وربما بالنسبة للقارئ، الحياة المديدة هي من نحتكم اليه، مادمنا لا نمتلك قضاءً محايداً ولاسلطة فكرية حاسمة . الحياة يجب ان تواصل تقدمها! وضمان السلم الاجتماعي هدف اول في الزمن المعيشي، لكن السلم الاجتماعي الأشمل ومفردات الحياة جميعها، يجب ان تستمر في التقدم ولا يجوز، مطلقاً الوقوف دون تقدمها وتطورها وتغييرها.
ولكي نضمن سلامة المسيرة، لابد من ان نمتلك قوة رادعة ضد الممارسات العنيفة، او التطرف في الحفاظ على المكتسب. فقوة الحفاظ هذه، على الراسخ سوف تقع حتماً ضمن قوة الجبهة المضادة للتقدم او التجديد. فحماية المقدسات "الاجتماعية، وضمنها الفكرية، او التقاليد الثقافية القديمة الراسخة تعني الرضا بـ و الحاجة الى، ابقاء مصدات التغيير. وهذه تكبح القادم او تشرذمه او تعرقل مسيرته. واذا علمنا ان في الممارسة العملية يصعب التوازن ويضعف شأن الحياد الى درجة الخمول. بهذا نكون قد عدنا الى الساحة ورضينا بالحركة والحركة الضد وقنعنا بأمتار التقدم القليلة التي قد تتاح في فترات.
ولكن، هل نرضى بتواجد المتضادات في الساحة؟ قد نرضى. ولكن هذه المتضادات المتواجدة معاً هي ايضاً قد تربك السلم الاجتماعي وتؤدي في أحيان كثيرة الى قتلى وسفك دماء.
كما ان الأجيال لا تصبر طويلاً على حال، تريد ان تغير ما دامت غير مستفيدة، او ما دام هناك أفق لفائدة اكبر واعم او حين تكون متضررة وأمام كل هذه الفضائيات وسياساتها، يصبح مجمع المتضادات ساحة مجابهات مرجأة. نعم، اطلاق الصافرة وبدء الانفجار، عمل فيه تخريب ايضا وفيه مصادرات نفوس وأفكار ومواقع اجتماعية وثروات وطنية بحكم الشراكة الواسعة لغير الثوريين في الثورة او التمرد وضرب الثورة والوقوف ضد "الفوضى" من قبل الضد يصبح ضرورة. لكن الثورة أو التغيير من أجل حقوق الناس والمستقبل ضرورة أيضاً.
في كل حال، الثورة، التمرد، التغيير...الخ أساسيات حياة مطلوبة للتقدم والثمن ليس دائماً هيناً. فهل نحافظ على النظام والرسوخ ام نفتح الطريق للحياة لكي نتقدم؟
هنا أذكر فقرة من من ريجي دوبريه يخاطب الحاكم العسكري بعد سفك دم عمال المناجم: "انكم لا تمنعون هذه الأعمال. بل يبدو أنكم توافقون عليها كشرط ضروري تتجنبون به شراً اكبر. يلحق بـ"النظام" الدستوري. لكننا نحن ايضاً نتفادى به شراً اكبر يلحق بالشعب..."
فماذا نقول نحن في الثقافة؟ شخصياً أقول: ليس غير المصابين في عقولهم والفاشيست يحبون ان يروا البشر يصنعون التاريخ بقتل الآخرين. لكن كيف ننقذ البشرية والحياة؟ هل من طريق آخر؟ العقل البشري مُمتحَن. والحزن لا يفارق الأجوبة!