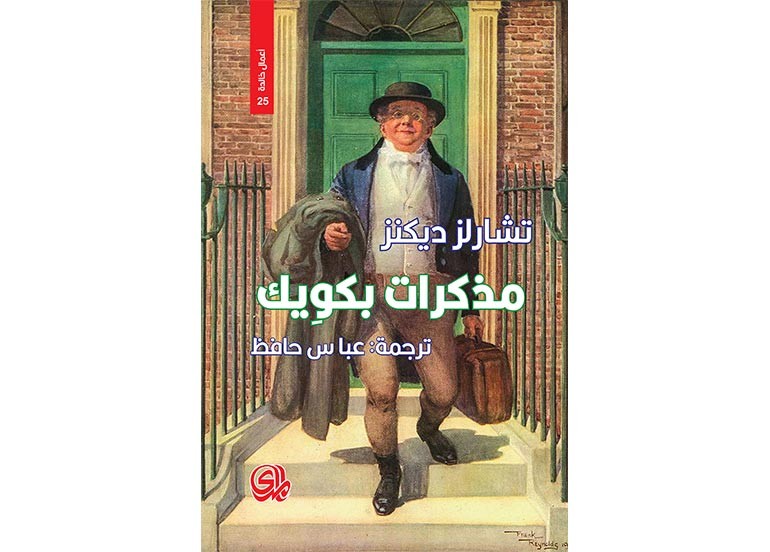رقد محمود... ورقدت من حوله كل الأشياء، فوضى شقته الصغيرة المعتمة، الكتب على الطاولة، القدح المكسو بغبار قديم، الأوراق البيض الفارغة والأوراق الصفر المكتوبة، رقدت حتى الكلمات، جميع الأشياء رقدت، لا شيء يوحي بالحركة... سوى خشخشة الصمت وعبق الوحشة العطن
رقد محمود... ورقدت من حوله كل الأشياء، فوضى شقته الصغيرة المعتمة، الكتب على الطاولة، القدح المكسو بغبار قديم، الأوراق البيض الفارغة والأوراق الصفر المكتوبة، رقدت حتى الكلمات، جميع الأشياء رقدت، لا شيء يوحي بالحركة... سوى خشخشة الصمت وعبق الوحشة العطن الذي يعطّ من كل الأرجاء، فضلاً عن رهبة الموت التي كان يفكر فيها كثيراً...
غير أنه في النهاية فعل ما تفعله الملائكة، اختفى بين الغيوم والضباب، دون أن يثير غباراً، أو يخلف ضجيجاً. ليس ثمّة ما يشدّه إلى الأرض، ويجعله ينظر إلى الخلف، أو إلى أسفل سوى الكلمات، كلمات لم تكن وفية له تماماً أو صادقة معه كما ينبغي. وكما يختفي أبطال الروايات الكاريبية في دوائر السحر الغامض ومتاهات الضباب أو في وهج الظهيرات الاستوائية، اختفى هكذا، وهو بأبذخ لا أباليته، وروحه المرحة وظرفه الحاضر... عاد ثانية صوتاً بلا جسد، كائناً حلميّاً أو كائناً نصف أرضي...عاد كرخّ أبيض كبير يرفرف بجناحيه في سماء مدينته التي يعرفها جيداً ولثغ في أزقتها أولى الكلمات... تهجّاها وكتبها كما كتبها أمهر الكتبة والوراقين، توقف عند العتبة، التفت إلى كل الجهات، وحين أدرك أن لا أحد سيكتشف هيئته الجديدة، هيئته التي كان ينظر لها بالكثير من الحرص والتوجس أو ربّما الاستهجان الخفيف، ابتسم ابتسامة ظافرة وألقى بجسده البرزخي على كرسي بنفسجي كان يعشقه جسده النحيل، وانتحب كثيراً في الأيام الأولى قبل غيابه، من ثم وبعد متوالية من التهويمات ونوبات النعاس غطّ الكائن الهابط من سماء غريبة في نوبة من الأسى الشفيف، كأنه فكر باستعادة مجده الأرضي، وقبل أن تكتمل الظهيرة وينكسر الظل، راح يشكو بكمد ظاهر درجات الحرارة أو كثافة الغبار وسخونته. وبصرف النظر عن الفصل، وتحولات الطقس، بقيت الشكوى هي ذاتها، إذ حين يتكثف الصمت في دورق الظهيرة، ويتحول الزمن إلى سائل دون لون وطعم، ينظر إلى ساعته القديمة بانتباه شديد، يقترح شيئاً لتبديد الصمت. يسحب قدحاً من درج المنضدة المفتوح، ويعمّر كأسه بعد أن يمسح الغبار الخفيف المتراكم عليه بمنديل ورقي ابيض، يخففه بقليل من الماء، يعبه دفعة واحدة، ويده المرتعشة تحاول تقطيع تفاحة بائتة بسكين عمياء، وبعد أن يضع قطعة صغيرة من التفاحة في فمه ليزيح طعم الخمر اللاذع، يمسح شفتيه المغضنتين بظاهر يده، ويحدق في الفراغ... الفراغ العميق، ليسبر غور وحدته، يفكر بإلباس سحلية الوحشة التي تأنسه بقسوة ثوباً فلسفياً. وبعد أن يمسح نظارته بهدوء شديد، يقول:"كم هو تافه وحقير هذا الذي يسمونه الموت". دفعتني كلماته دفعاً إلى الغرفة الخلفية للمكتب، وأنا أبحث عن عون لإزاحة هذا الصمت، وكنت في عتمة الغرفة الجانبية الرطبة، أقول لنفسي: إن الرجل هشمه الجزع وتلبّسه اليأس. ارتسمت أمامي علامات محمود الصلبة، التي كنت أرصدها دائماً بشيء من الاهتمام، وكانت لا تفارقه. خاطبته بعتب بارد: "يا صديقي لم تكن مهمتك رمي العالم خلفك.. لم تكن مهمتك تركنا هكذا دون أن نتهيأ لسورات غيابك، لم تكن على حق يا صاحبي على الرغم من أن قمرك اصطدم بنافذتك المكسورة، وفقدت أيامك الكثير من مائها، كنت تفعل الأشياء كما تفعلها في طفولتك، سخريتك الشهيرة، دهشتك التي لا تنحسر، إصرارك على إفراغ الصباح من بهجته، لتتفنن في سكبها بكأسك الأولى، ابتليت بالحب، وعشقت النور ولكنك وقعت في عتمة الشرفات، وظلام الزوايا، لو كنتَ أقل احساساً بطيش السماء لكنتَ الآن تروي أحلامنا، وتسقي حقولنا، وتبتدع لنا مواقيتَ للفرح والشغف.. هل كانت تلك المرأة العابرة حصان طروادة حياتك؟ تلك المقيمة فيك والتي تتقدم في قلبك وتهدر كماكنة القطار القديم الصاعد إلى بغداد دون مواعيد أو مواسم.. يا أنت المحفوف بالموت، غير المستكين تحت تراكم الخيبة، انهض كالجبل وانطلق كالمقذوف من فوهة العجز، قوياً.. حيوياً..متماسكاً، تفتح ذراعيك أقصى ما تستطيع، فتطير من تحت إبطك أسراب الطيور الملونة، وتغدو كائناً خفيفاً.. تفلت أيدينا التي كانت تتشبث بك، وبكل استقامة بهائك، توحي للنساء بأنك لا تزال معشوشباً كربيع ودافقاً كنبع، وقوياً كجواد، لا يخامرهن الشك في انك ستبقى ساطعاً كالشمس، لا يراودك الغروب أبداً،..تساءلت: هل أنت تتهيأ للحياة من جديد؟
في الطابق الخامس من مشفى المدينة، نافذتك المكسورة مفتوحة على الجنوب، ونهرك القديم يجري باتجاهين كروحك، مرة كطفل نزق يلهو بالحياة، وأخرى كشيخ يتهيأ للمغادرة، وعلى الرغم من رياح ديسمبر التي كانت تلسعنا بنسماتها الباردة جداً، كانت أحاديثك تتحول إلى مواقد جمر تشعرنا بدفء سرّي ينتشر كالشعاع في الغرفة الصغيرة، يحوم معبرك الشمس التي كانت تتسلل بحياء من تلك النافذة، وكانت إحدى هالاتها المتسللة تغمر وجه راوي المدينة، وجهه الذي يحمل كل بساطة العالم.. وطفولة الأشياء..الهادئ جداً والذي يحرّض دون كلفة أو تكلّف على الهدوء المشحون بالاسترخاء. راوي المدينة يجهد بمساعدتي لتغيير ثوب جديد لك، كانت رائحة النشأ تملأ أنوفنا كعطر اعتدناه بسبب تماهينا مع رائحة المشفى في الطابق الخامس. المكوث يطول ويمتد لأسابيع.. تعلقنا بك يأخذ منحى جديداً لم نشعر به طيلة أيامنا الماضية، الاحساس بمسؤوليتنا وقلقنا عليك يتصاعد مع كل يوم جديد.. وطيلة وجودنا الى جنبك، كنت أطعمك بعض ما تشتهي، وراوي المدينة يتفنّن في استدراجك بعيداً عن اليأس والألم، قريباً من الفرح والأمل مع صحبنا الآخرين الذين لا ينفكون يلقون على مسمعك الطرفة بعد الأخرى، وهو على الرغم من سيكولوجيته المعروفة بالتريّث الشديد الهدوء وعدم المجانية يخرج من طبيعته المعتادة ليمنحك ما تفتقده...أكثر من 40 يوماً كنا نهرع اليك في الصباح الباكر، لنطرد عنك الاحساس بالوحدة والألم والنسيان ونستبدل الشخصَ الذي رافقك ليلاً. رسخت بيننا علاقة غريبة تختلف كثيراً عن علاقة كل السنوات الماضية، ربما كنا نشعر بأننا نذود عنك، ونقف في صف واحد معك ضد الموت.. نحن والموت في الصف الآخر..هي علاقة جديدة بالتأكيد لكنها علاقة عميقة، عميقة جداً. اكتشفنا أن الموت يعزز الآصرة، أكثر من الحياة بكثير. سقطت بيننا الكثير من الشكليات والمظاهر، مثلاً لم نكن نفكر قبل هذا الموسم العائلي الحزين، أن نستبدل ملابسك الداخلية، ونرافقك لقضاء حاجاتك، ونتحدث معك دون كلفة من أيّ نوع، وعلى الرغم من آلامك ورعبك الشديد من الموت، لم تتخلَ عن سخريتك وظرفك، فحين أعطتك الممرضة قرصاً صغيراً وطلبت منك تناوله في أربعة أوقات، قلت لها إنك تحتاج لفأرة، اندهشت الممرضة وقالت لك وماذا تفعل بالفأرة؟ أجبتها بلطف وبساطة: لتقسّم لي القرص كما اقترحتِ أربعة وجبات.
ضحكت الممرضة بعد أن عرفت المغزى.. الصراع يشتد، لعبة جرّ الحبل بيننا وبين الموت في ذروتها، أظن أنها دخلت في جولات أكثر حماسة، ها أنت ذا تنحدر من السفح مثل حجر صغير تجتذبه الهاوية.
لستُ على قدر كافٍ من تجاهل الذكرى..أيها المُسجّى في انتظار مزامير الغياب، لم أكن قبل ثلاثين عاماً، يقودني تفكيري لأن أتخيل نفسي صديقاً لك، أن يكون صاحب هذا الجسد الهامد تقريبا، والذي تنبعث منه رائحة الموت.. صديقي! هذا الذي كان الوسيم الأنيق الذي أخذ قناعاً من الشهرة يعلو وجهه الناعم الحليق دائماً والمشرّب بالحمرة، مع شعر مرتّب كالحرير بلون الفضة، ابن العائلة الميسورة التي تنحدر ربما من شمال الشمال.. صديقي أنا ابن جنوب الجنوب وابن العائلة التي تحسب حساباً لوجبتها المقبلة، فضلاً عن فارق العمر الكبير، وما تقترحه الذكرى.. هذا الآيل للغروب والانطفاء، كان يقف على منصة المركز الثقافي للجامعة في ندوة للقصة القصيرة، شاباً أنيقاً ولامعاً ولبقاً ووسيماً ومثقفاً، استحوذ على تفكيري تماماً، هي الصورة البكر التي شكلت صورة المعرفة الأولى.. بعدها بثلاثة عقود صار محمود زادي اليومي، ينير مكتبي في الضحى، بإيقاعه الثقافي الفريد ونبله الإنساني المتدفق، وروحه العذبة الشفافة، وحسه الجمالي، وحرصه الشديد في التعامل مع النصوص والأشخاص بذات الروح.. لكن لعبة المصائر وقدرة الحياة على رسم الأقدار وتبديل الأدوار كانت تعمل كما تشاء.. فعلت فعلها كما تهوى. اقتربنا من بعض وتجاوزنا حدود صداقات المدينة السريعة العابرة، فكان يشاركني مكاني ولقمتي متفضلاً في أحيان كثيرة. في المرة الأخيرة همس لي أن نفسه هفَتْ إلى أكلة (الشبزي بالسمك). تناولها وهو يسرد ذكريات والدته، على عبق رائحة الشبزي التي أثارتها الأكلة، ولكن بعدها بيوم كان محمود في أسوأ حالة صحية، نقلناه إلى المستشفى، إلى الدور الخامس.. رقد محمود مستسلماً للأسوأ .بعد أن أنهكته آلام القولون والكبد وأطبقت عليه تماماً، كنا معه جنبه، ومن وحوله كعائلة.. حجزنا له غرفة خاصة، حيث يهرع لزيارته عدد من الأدباء، أصدقاؤنا، على مدار الساعة. كان محمود على يقين راسخ بأنها أيامه الأخيرة على الرغم من نفوره الشديد من كل ما يشير الى الموت والنهاية، وكان راوي المدينة صديقه ورفيق دربه يحيطه بحنو كبير، وأنا وكل محبيه لسنا بعيدين عن هذا الشعور. طالت أيام رقاده وعذابه، وراح مرضه يستفحل مع كل يوم، وكنا برفقته تماماً. نراقب كل شيء..نشعر بأوجاعه.. ونحاول تخفيفها عليه، نحكي ونتندر، ونتناقل أخبار الأدب والسياسة والمجتمع بعملية مقصودة لصرف صديقنا عمّا ألمّ به. في الأغلب يجلس أحدنا على حافة سريره، ويجلس الآخر على السرير الثاني المقابل، ويحيطه الآخرون على شكل دائرة، يتوسطنا هو، ثم نوغل في الأحاديث الحميمة، كأننا نمارس لعبة تجاهل الموت قصداً، وبين الفينة والأخرى يحكم راوي المدينة البطانية ذات اللون التركوازي على الجسد الذي راح يجف ويلمع كالصدف بمرور الأيام، ولا يتوانى عن رشِّ الكلونيا وشعل أعواد البخور في طقس أشبه بالطقس الديني، لمقاومة تلك الرائحة السرية التي ربما كانت تنبعث من أرواحنا، وليست من الأفرشة أو من زوايا الغرفة.. وها هي نسمات ديسمبر تشتد وتوغل في قسوتها، ونحن بعد أكثر من شهر من عملية جرِّ الحبل مع الموت، ترتخي قبضاتنا قليلاً بفعل سطوة المرض وشعورنا بشيء من اليأس، ومحمود يوغل في رسم نهايته المرعبة على الرغم من مقاومته الشديدة وذعره منها.، وفي أحد الصباحات تباطأ تنفسه، وراح يستجدي الشهيق بصعوبة، دفعناه بسرعة إلى العناية المركزة، وقد تحجّر وجهه الوسيم اليانع، وظهرت الشيخوخة على وجهه بقوة قاهرة لم نلحظها من قبل، خصوصاً أن النوبة لم تمهله ليلبس طقم أسنانه، ويطبق فمه الفاغر، ويضبط شهيقه المتسارع... كانت هذه علامات مخيفة ورسائل قادتنا للتفكير بالنهاية، لكن علينا أن لا نستسلم.. وقفنا نحدّق ببعضنا مرة، وببقايا محمود أخرى، نرقبها وهي تتضاءل رويداً رويداً وتختفي في بركة التركواز الصغيرة التي طغت عليها العتمة. كان في الليلة الفارقة بل وكل ليلة وقبل أن أودعه، يسألني بإلحاح شديد: أين الموبايل..أين الساعة...؟ وكانت هاتان الكلمتان أكثر الكلمات التي ردّدها محمود على عتبة نهايته.... قلت لنفسي، ليس بقليل من الفضول والخبث، ما السر في ذلك؟ وما العلاقة بين الشيئين؟ هل سيقوم صديقنا المشرف على النهاية من رماده ويتحول الى عاشق عند منتصف الليل، وأي عشق هذا الذي لم يتقهقر أو ينفد عبر كل هذه السنوات؟ ربما كان هذا جواباً على إحجام صديقنا عن الزواج، قلت لنفسي، وكأني صدقت كل ما أوحت به افكاري الغريبة.. ومن تلك المرأة التي لم نشاهدها طيلة فترة مرافقتنا له في المستشفى؟أو حتى قبله؟ هل هي حبيبة من الذاكرة؟ امرأة منفلتة من حلم.. أو من ثيمة سحرية بإحدى قصصه؟ أم هي حقيقة من لحم ودم؟ أو أن الرجل يمارس شغفه في التعلق بالحياة ومقارعة الموت، فيبتدع أجمل وأغرب الخيالات والحكايات، وهو الصانع الساحر والمتمكن من صنعته؟ وتسورتني نوبة أخرى من الأسئلة. ما العلاقة بين الساعة التي لم أزل احتفظ بها حتى الان وبين الموبايل؟ هل هو عشق بمواقيت دقيقة، كما عودنا في حالة الكتابة؟ هل هو عبث ما قبل النهاية؟ هل هي سخرية مُرّة من نفسه، ومحاولة لتقليد من يملكون عائلات وصلات حميمة؟ لم أجد جواباً، ولو كنت سألته فلربما صدمني بإحدى طرفه..كل هذا لم يغير من إيقاع ذلك الغروب الحزين..الغروب الذي نقلنا فيها جثة محمود إلى المغتسل في الجامع القريب.. ولأن الليل راح يحيطنا بضراوته لم يعد دفن محمود ممكناً في الليلة نفسها، وبات محمود ضيفاً على الملائكة في ليلته الأولى.. رقد محمود.. ورقدت من حوله كل الأشياء.. لننطلق به في الصباح الباكر الى مقبرة الحسن البصري.. وكان الاحساس بالفقد باهظاً.. كأننا سنواري المدينة كلَّها الثرى....