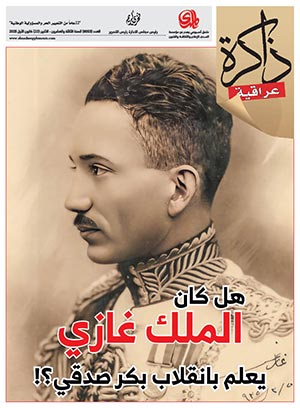فوزي كريم
في مطلع الشباب كنتُ كاتباً ستينياً. تعصف بي الكتب المترجمة، على قلتها، إلى أفق طليق. لأنها تتناغم بصورة مباشرة مع فورة الدم الشاب والعقل الشاب. لم أكن منقطعاً عن الكتاب القديم، ولا عن كتب الرواد: سلامة موسى، طه حسين، توفيق الحكيم، والذين ورثوهم: زكي نجيب محمود، فؤاد زكريا، زكريا ابراهيم، علي الوردي، نجيب محفوظ... ولكن هذا الإلتباس في اللغة، والغموض في المعنى، كانا جديدين تماماً، وبالتالي شديديْ الإغواء، مثيريْن للإفتتان. وما كنت حينها أفرق بين الالتباس والغموض، أو أُبالي إذا ما كان هذا الإلتباس والغموض وليديْ ضعف في الترجمة، أو علّةٍ في اللغة الأصل. وإن هذا الافتتان، الذي يرفعني شبرين عن أرض الواقع، هو وليد فقر دم في ثقافتي الشخصية، والثقافة العامة التي تُحيطني. وهو بالتالي ضرب من الهرب. كنت أقلّ قدرة على وعي ذلك.
الابتلاء لم يتوقف عند حدّ استلام المعرفة، بل يكتمل مع محاولة العطاء. كنت أُقبل على الكتابة بهمّة من يمسك بعصى الساحر. ها أنا ألتبس كما التبسوا، وأغمُض كما أغمضوا. وها هم القراء يحيرون معي كما حاروا معهم، وأحياناً يسخرون مني كما سخروا منهم. وأنا في الحالين خفيف الخطى، راض عن النفس كل الرضا.
أكتب الفكرة، وإذْ أجدها تستقيم استقامة الفكرة في لغة سلامة موسى أو طه حسين، أعدل عن هذه الاستقامة إلى تدبير ذكي يجعلها تعني، ولا تعني شيئاً في آنٍ واحد. أترك الجملة، ومن ثمَّ الفقرة، تسبح عائمة في فراغ معنى لا قدرة لي على الامساك به. أحسّ أن بي توقاً روحياً، أو عقلياً، إلى بلوغ عمق تعجز عنه خبرتي الثقافية، واللغوية. وما جراءتي في المحاولة إلا وليدة مكابرة لا تخلو من جهل. إلى جانب أنها مكابرة معززة بمحيط ثقافي هزيل، ومدى تربوي قاصر وخاطئ. ما كنت أعترف، أو أعرف، حينها بأن الجاهل أكثر جرأة من العالم.
كنا نحاكي الجملة المترجمة، والفكرة المترجمة، بوهم أننا أندادٌ، بفعل المعاصرة، لمفكري حضارة الغرب. كنا نهرب من فراغنا الثقافي، الذي نعرفه عن يقين، إلى المخيلة. كنا نراها الملاذ، مع يقيننا أنه ملاذ سهل المكسر. بالونة ترتفع بفعل الدخان. الدورة تكررت لدى الأجيال التالية، ولكن هربها لم يكن هذه المرة من الفقر الثقافي وحده، بل من ماكنة جمهورية الرعب المترصدة لما "يعني" الكاتب، ولما يقصد. فوجدت ضالتها في "اللامعنى". ووجدت الغرب يزودها، كما زودنا، ببالونة الوهم التي لا تكفّ عن التحليق. وحضارة الغرب لم تكن تخلو من كتاب لجأوا إلى هذا الوهم بتجاوز اللغة إلى ما ورائها. ولكن لجوءهم لم يكن هرباً، لا من الفقر الثقافي كهربنا، ولا من الذعر كهرب الأجيال التالية، بل كان ضرباً من اللعب العصابي، وليد الترف. ألم أقرأ ما يشبه ذلك عند "سارتر"، و"بارت" و"صمويل بيكيت"، وكثيرين غيرهم؟ ألم يتجاوز كاتب مثل مطاع صفدي مدىً أبعد من مداهم؟ ألم أقرأ لشاعر يقيم، لحظة الكتابة، على حافة الأبدية. وأعترف أني وجدتُ هذا الجلوس على حافة الأبدية، بالرغم من عدم فهمي له، فاتناً؟ ولذا تجرّأت عليه، وجاوزته. ولكني أعترف، إنصافاً للنفس، أني لم أبتعد، حدّ القطيعة، عن الكتاب القديم وكتابة الرواد. في حين كنت أرى معظم كتاب جيلي لا شأن لهم بالكتاب القديم، ولا بكتابة الرواد، إلا فيما ندر. ولعل العناية بهما كان مصدر سخرية مُعلنة.
حين أراجع كتاباتي الستينية، إذا ما وقعت عليها صدفة، أستطيع بيسر أن أضع طرف سبابتي على الجمل والفقرات التي تتماهى مع الفراغ واللامعني. حتى لأستعيد بيسر لحظات اللعب الشيطاني التي كانت ترفعني بنشوة شبرين عن الأرض، للتحليق في وهم المعاني التي تعجز اللغة كلغة على استيعابها، لا لغتي القاصرة طبعاً.
حضارة الغرب لا تزودنا بالوهم، بل نحن الذين نتزوّد به منها وهي غافلة، مستأنسين بافتراض المعاصرة والندية و"صراع الحضارات". في حين أن المعاصرة والمجايلة تفترض زمناً واحداً يجمع الطرفين في مسار حيوي واحد، لا زمنين متفاوتين تفاوتاً قاهراً، تعترف به البداهة، بداهتنا، كل حين.