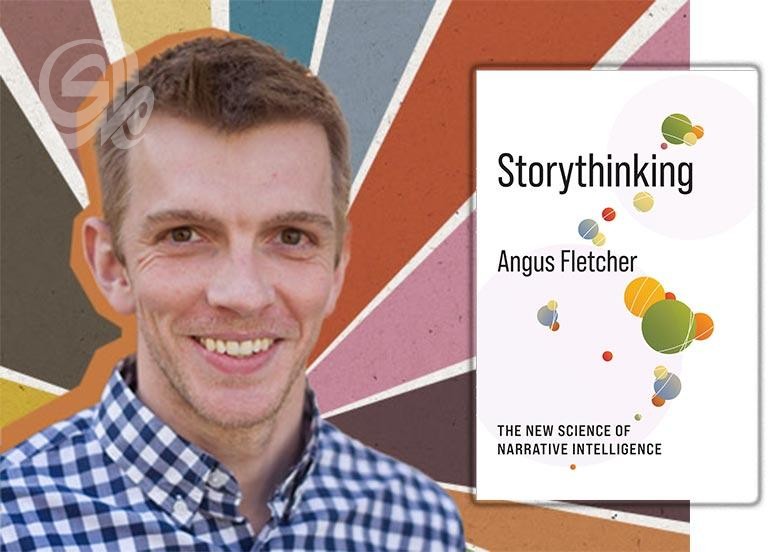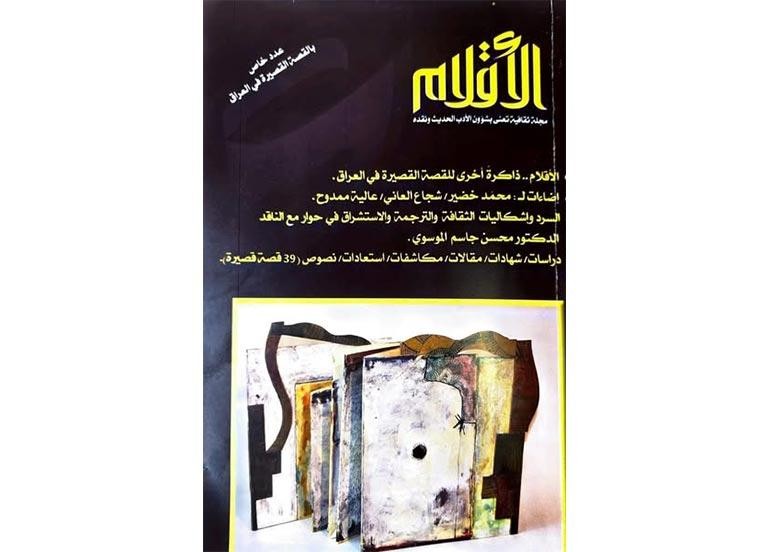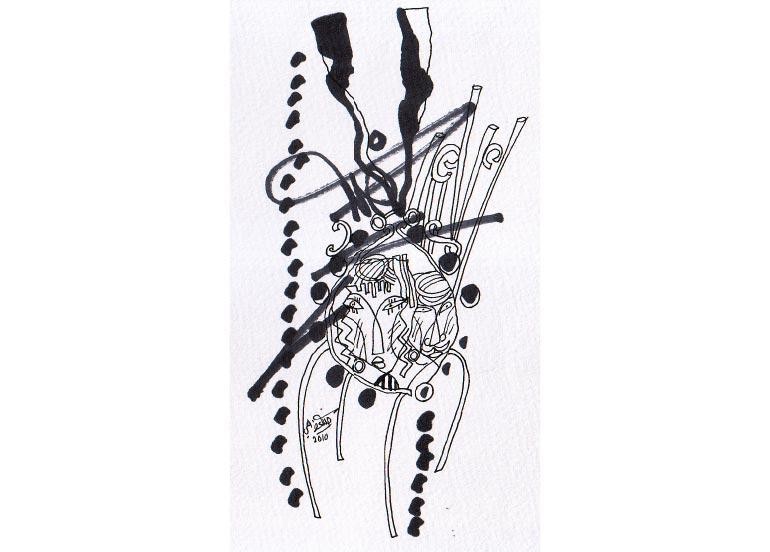د. نادية هناوي
ليس جديداً أن يشهد واقعنا الثقافي والأدبي الراهن ظواهر طارئة وممارسات، بعضها إيجابي إلى حد ما،وأكثرها سلبي للأسف.
ولندع هذا الكثير السلبي من الظواهر التي هي في طارئيتها لا تشكل خطراً ولا ضيراً، إذ كما تبزع بسرعة تنطفئ بسرعة كأن يتمظهر أمامنا فجأة كيان يوصف بأنه ثقافي ثم بعد حين يتضح ما وراء الأكمة. أو تشكيل يراد نفخ الروح فيه لكن بعد فوات الأوان أو النزعة المتناقدة التي لا يتبقى منها سوى جعجعات فارغة أو التمنصب على رأس مؤسسة او تشكيل مجيّراً ما تنصب عليه لمصالحه الذاتية حاسباً نفسه مالكاً إياه دنيا وآخرة، هاشاً على هذا وناشاً على ذاك، تطبيلاً ومحاباة بنفعية ووصولية لا يقتنع بها عقل ولا يقبل بها منطق..إلى غير ذلك من ظواهر سلبية كثيرة يعف عن ذكرها القلم فيرعف حبره قبل أن يسطر حروفه.
وسنترك الوقوف عند هذه الظواهر أو بالأحرى نرجئ الحديث فيها إلى وقت يناسبها. ولنبق في الممارسات التي نجدها تنهش جسد الثقافة خلسة، هذا الجسد الذي هو أصلا غير متعافٍ، وهنا مكمن الخطر لأن الممارسة السلبية ما أن تظهر حتى تغزوه، آكلة أخضره ويابسه، وهو ما يستدعي علاجاً ناجعاً وسريعاً وإلا استفحل الأمر، وعندها لن ينفع في تطهير واقعنا منها حتى الكي.
والممارسة التي نقصدها هنا التثاقف في مجال من المجالات الفكرية الذي به يسطو اللاحق على جهود السابق ويغير متعالما عليه خالطاً الأصيل الصحيح بالمزيف المزوق، محاولاً الاستحواذ على حق لسابقه ليسجله باسمه محققاً عبره مصالحه عدواناً وتجنياً.
وليس هذا بجديد فلقد عرف أدبنا العربي القديم مثل هذه الاغارات وتصدى لها النقاد تحت باب نقدي محدد هو السرقات الأدبية، فحددوا خصائص السارق وصنّفوا أنواع السرقة من السطو والإغارة الى الانتحال والغصب كما بينوا مخاطرها وطرق مواجهتها وكشفها.
بيد أن خطورة ظاهرة السرقة اليوم أشنع مآلاً من حالها قديماً، لا لأنها تتعدى على الملكيات الأدبية الى ما هو فكري وتستحوذ على ما ليس لها فيه حق حسب؛ وإنما هي أيضاً تنخر في أساسات القيم الثقافية والعلمية فاتحة الطريق لمزيد من التعدي والتجاوز غير الأخلاقي، لتكون السرقة الفكرية كمثيلتها الأدبية مشروعة ورائجة كفعل طبيعي يعلن على الملأ بلا وجل ولا حياء بل لا محاسبة قانونية عليه ولا مراقبة ذاتية يؤنب فيها الضمير صاحبه ويحمله على اللاتمادي وربما التراجع.
فهل يجوز لمن لا يحترم جهد الذي سبقه فيغتصب حقوقه أن نتركه بلا حساب ؟ وما الذي ينبغي فعله وبعض من الذين تغتصب افكارهم يتسامحون ولا يؤاخذون سارقي افكارهم من باب أن المؤاخذة والتقريع لن تجلب نفعاً بل تولد عداوة هم في غنى عنها ؟ لكن ما بالنا أن السارق سيتمادى في سرقاته فيسطو على ثان وثالث وهو يعرف ان هذا الثاني والثالث سيكون مثل الأول عاذراً ومسامحاً وربما أيضاً مباركاً إياه على سرقة جهده ليفلت بفعلته في الاستحواذ على جهد غيره لصالحه.
إن هذه الظاهرة التي صرنا نلمسها للأسف في مختلف مرافق حياتنا الثقافية والعلمية بل إن بعضها يمارس على مستوى مراكز ثقافية والسبب أن لا قانون للملكية معمول به في بلدنا ومن ثم ليس للسابق أن يحاسب اللاحق وهو يسطو على أفكاره ويسلبها بأشكال شتى من فذلكات السرقة التي تمارس بصلافة وفي وضح النهار ومن ثم لا يغدو غريباً أن نرى اللاحق يتبجح أمام السابق بفكرة ( لطشها) منه على حين غرة دونما تعب وعناء ولم يخض من أجلها مسالك ومتاهات ولا جرب الحيرة وهو يحاول إثبات أهميتها.
ومثل هذه الظاهرة تحتاج منا تصدياً كي لا يغتر السارق بسرقاته منتفعاً من خُلق الذي سرقه وكي لا يشيع الزيف والادعاء فيندر الأصيل والمعطاء.
وما كان للعرب قديماً بوعيهم النقدي أن يسمحوا للسرقة الشعرية مثلاً أن تمر في الواقع الأدبي إلا تصدوا لها مقرّعين وفاضحين، منتفضين لا تأخذهم في الحق لومة لائم، مستوعبين حقيقة أن الشعر ليس ملكاً لقائله الذي قد يموت وهو لا يعلم أن هناك من سرق شعره فأدعاه لنفسه في استعارة هنا أو كناية هناك.
وهنا يتجلى دور الناقد الذي من وظائفه تأكيد السبق وتحديد الرائد والقول الفصل في الجيد وتشخيص الأصيل بموضوعية. والمدهش أن استيعاب الناقد العربي القديم لوظائفه كان فاعلاً وصميمياً مع أن النقد آنذاك لم يكن محكوماً بنظريات محددة ولا تسيره مفاهيم ومصطلحات كالتي عندنا اليوم.
وشتان بين سرقة يغتصب فيها الحق بقصد الإغارة والسطو حرفياً وبين اقتباس أو تضمين أو تناص مع السابق بقصد البناء عليه وتطويره إبداعياً حافراً للتجديد بالمزاميل. لكن الفعل الأول ينطبق للأسف على ما هو رائج وآخذ في الانتشار في ساحتنا الثقافية للأسف. ومن أسباب رواجه البحث عن التميز من دون بذل جهد مساو لهذا التميز فضلاً عن أن غياب قانون للملكية الفكرية يجعل الأمر يسيراً في الإغارة وسهلاً في الغصب من دون أدنى رادع من حساب أو عقاب.
وليس أشنع من الاغارة فعلاً حين يكون المسروق فكرا وثقافة لا لأنه يدلل على انعدام الوازع الأخلاقي لدى السارق بل ان المتثاقف الذي يريد أن يتثقفن عن طريق السرقة سيوهم الاخرين بأنه مثقف أصيل.
وهو ما لمسناه ميدانيا مؤخرا بظهور أنفار لهم من الثقافة بضع مقالات ولهم من الأكاديمية بحث أو بحثان أو أكثر بقليل في أحسن الأحوال. ولا عيب في ذلك لان الله وزع أرزاقه بين عباده كيفما يشاء، لكن المعيب حقا أن مثل هؤلاء لا يرحمون أنفسهم فيعترفون بقدراتهم المتواضعة والله يرحم المرء الذي يعرف قدر نفسه، ولا هم يرحموننا فلا تأخذهم العزة بالإثم فيتصورون أنهم قادرون على التحليق صانعين لهم أجنحة من ريش وهمي. وغايتهم أن يجعلوا ما سرقوه من الأصيل السابق كأنه من عنديات علمهم وخاصة فهمهم، خبرةً وأصالةً، وقد بلغوه ـ كما يصورون لغيرهم ـ بجهدهم هم ونالوه بشق الانفس عن دراية ومعرفة.
وهنا نتساءل كيف يسمح بالإشهار والمباركة والإذعان لهذا النوع من التصيد المتثاقف في مجال البحث العلمي ناهيك عن مجال الابداع الادبي؟ وكيف يصح التغافل على التجني وعدم المحاسبة على انتهاك حق الملكية الفكرية سطوا عليها بلا وازع من خلق او ضمير وبصورة رخيصة بلا استحياء ؟ ثم كيف نسمح للطارئية في حقل من حقول المعرفة أن تصل إلى الأهداف والمبتغيات بالفذلكة والتدليس ؟
إن وقوف المؤسسات العلمية والأكاديمية والمنابر الثقافية الحقيقية ينبغي أن يكون حازما وصارما في وجه من يغتصب فكرة بحث من هذا أو عنوان موضوع من ذاك ويستولي على مشروع كان قد قدم له من سبقه لكن غياب الامكانيات حال دون تنفيذه له أو يسطو على كتاب او ترجمة بطريقة دراماتيكية ويدعيها لنفسه.
ومن دون ذلك الحزم وتلك الصرامة سيظل ميدان النهب والتزوير مشرع الأبواب لكل من يريد أن يكون له في الطيب نصيب وفي الحومة غنيمة، معتقدا بإمكانياته المتواضعة ولا علميته سهولة التمشرع في ميادين العلم والمعرفة، وربما تسول له نفسه الواهمة طائعية التمنطق بموضوعات الثقافة والتمنهج باستراتيجيات الفكر والفلسفة.
ولا شك أن الحزم يقتضي أيضا تطبيق قانون الملكية الفكرية تطبيقا جريئا وسريعا وببنود لا تغفل عن جميع طرق المراوغة والدجل التي بها يمكن للسارق أن يصادر المسروق.
ان ما نؤكده هنا ناجم عن خطورة الظاهرة، ومثلما لم يعذر النقاد العرب القدماء الشعراء الذين يسرقون المعاني غصبا وإغارة من شعراء اعلم منهم بالشعر وأشهر صيتا واشتهارا وأعلى شأنا ومكانة في عالم الإبداع الشعري كذلك لا ينبغي أن نعذر هؤلاء المنتحلين والسراق.
ومطلوب من وسطنا الثقافي ألا يبقى متفرجا وربما مباركا لهذه السرقات المفضوحة، بحجة أنها تريد بلوغ اهداف نسعى إليها او انها ممارسات طارئة لن تغني ولن تسمن من جوع، بل لأنها ستسمن وتكبر حتى تصبح مشاعة وكأنها مشروعة وعندذاك لن يكون بإمكاننا تغييرها ومن ثم يتمادى السارق فيسطو وهو منتش، ويغير الغائر وهو متبجح، ويغتصب الغاصب وهو ماكر، بينما نحن ننظر ولسان حالنا يقول العين بصيرة واليد قصيرة، باستثناء محاولتنا أن نغير ما بأنفسنا فعلا وصدقا.. وأنىّ للنفس أن تتغير ما لم تبذل الجهود الحقيقية المستفيضة والأصيلة وبإفادة صحيحة من تجارب السابقين الذين أضنى أصحابها أجسادهم واجهدوا عقولهم وأنفسهم من أجلها.