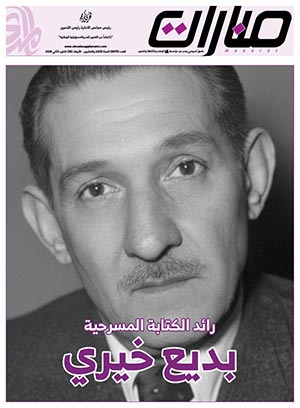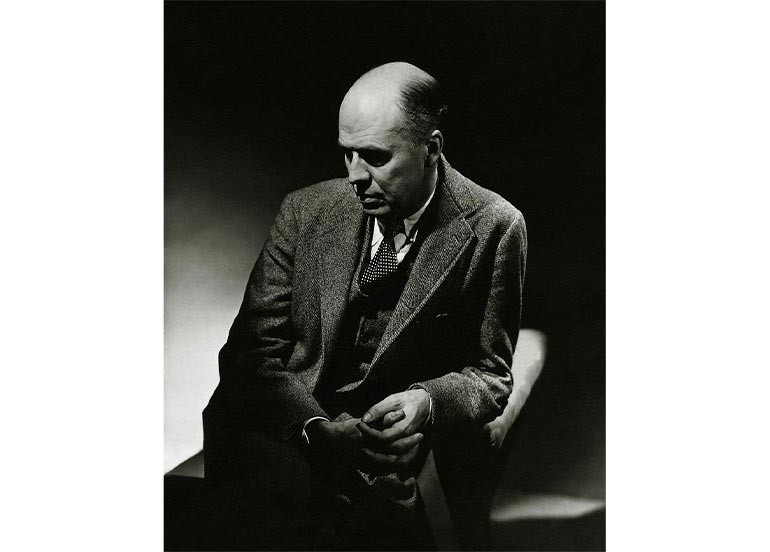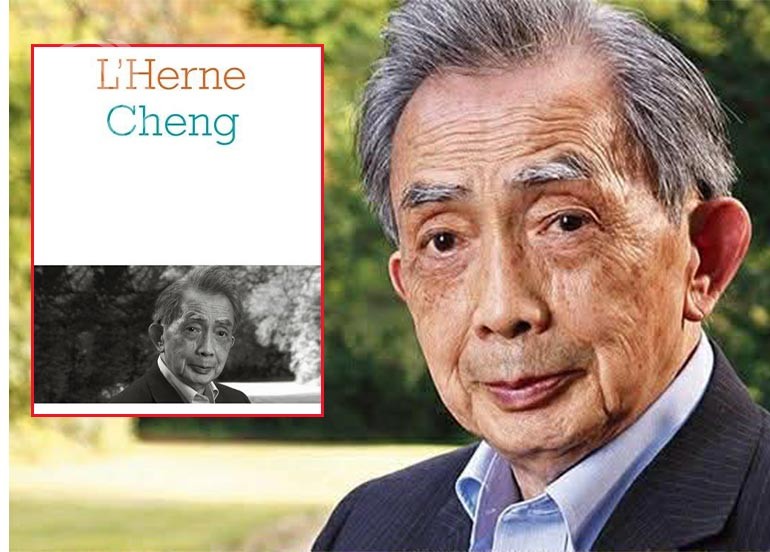يرى أن المثقف والحرية والوطن والإنسان هم الباقون، وما عدا ذلك فإلى زوال
حاوره: علاء المفرجي
ولد الشاعر الكوفي عدنان الصائغ الذي عام1955 في مدينة الكوفة. وحصل على الشهادة الإعدادية الزراعية. التحق بمدرسة أبن حيان الابتدائية. وقد عمل في عدة أعمال أثناء دراسته لمساعدة عائلته منها عامل مقهى، ندافاً, بائع سجائر، عامل بناء، عامل في المجاري، بائع مرطبات، بائع رقي، عامل في تصليح الراديوات. انتقل بعد الابتدائية إلى متوسطة أبن عقيل. توفي والده وهو طالب. حصل على الشهادة الإعدادية الزراعية. عمل في الصحف والمجلات العراقية والعربية. محررًا ومسؤولاً ثقافياً، ثم رئيس تحرير.
من مؤلفاته: انتظريني تحت نصب الحرية، أغنيات على جسر الكوفة، العصافير لا تحب الرصاص، سماء في خوذة، مرايا لشعرها الطويل، غيمة الصمغ، وغيرها.
القسم الثاني
المدى توقفت عندما اهم محطات ابداعه في هذا الحوار:
ما الذي تعنيه لك مسرحية (الذي ظلَّ في هذيانه يقظا).. وهي المسرحية التي أثارتْ جدلاً واسعاً في المشهد المسرحي والشعري في العراق وكانت معدة عن مجموعة من قصائدك، ما الذي تقوله عن هذه المسرحية؟
- «الذي ظلَّ في هذيانه يقضاً» كانتْ صرخة لافتة لمْ تتوقعها دائرة السينما والمسرح ولا الجمهور وقتها. أبدع فيها صديقي المخرج غانم حميد بعد أن كان صديقنا المرحوم احسان التلال قد أعدَّ له جزْأيها الأول «هذيان الذاكرة المرّ» على مسرح أكاديمية الفنون الجميلة عام 1989، والثاني (الذي ذكرته في سؤالك الكريم) على مسرح الرشيد عام 1993. فتحطمَّ جزءٌ من حاجز الخوف. وتحطمتْ إحدى الواجهات الزجاجية للسينما والمسرح نتيجة تدافع الجمهور وقتها. حدّ أن كتبت صحيفة المحرر وقتها (1993 باريس): «عندما أُسدل الستار على العرض الاول لمسرحية «الذي ظل في هذيانه يقظاً» دوّت عاصفة من التصفيق لم يشهدها تاريخ المسرح العراقي من قبل، وخرج ممثلو المسرحية يشقون طريقهم بين أمواج الجمهور المتلاطم على أبواب مسرح الرشيد في بغداد تاركين خلفهم علامات الدهشة والاعجاب، ولما نظّم التلفزيون العراقي استفتاءً مسرحياً كان لـ «هذيان» حصة الأسد فقد أجمع أغلب من شملهم الاستطلاع على انها الأفضل والأجرأ من بين ما قدم مؤخراً»
كما نالت المسرحية ردوداً كثيرة جداً وكُتب عنها مقالات عديدة ودراسات ثم فيما بعد أطاريح ورسائل أكاديمية كثيرة كما أخبرني الصديقان غانم واحسان.
وأشير هنا أن العملين: «هذيان الذاكرة المر» و «الذي «ظل في هذيانه يقظاً» مستمدان فكرةً ونصوصاً من قصيدتي الطويلة التي كانت وقتها مسودّة حملت عنوان «هذيانات داخل جمجمة زرقاء لا علاقة لعدنان الصائغ بها - أو نشيد أوروك « بالإضافة إلى مجاميعي الشعرية الأخرى. وقد ضم المعدّ إلى العمل الثاني نصوصاً للشعراء: أدونيس، مظفر النواب، يوسف الصائغ، عبود الجابري. كما صاحبَ العرض غناءٌ حي للمطربين: أنوار عبد الوهاب، وكريم منصور.
واستمرَّ الجدل طويلاً وكذلك المخاوف حتى بعد أن خرجتُ من العراق في السنة نفسها.
وقد تواشج في هذا العملِ النصُّ الشعري مع تجلّيات المخرج واندفاعه إلى أقصى ما يمكن تخيله، مع الالتقاطات الذكية للمعدّ وتفهمه للنص بعد جلسات طويلة معه، مع أداء مذهل للممثلين وخاصةً بطل العمل الفنان حكيم جاسم الذي كان يتلوّى على المسرح كصرخة مديدة لا تنتهي، تختصر كل الوجع العراقي والغد العراقي وحتى وهي ربما تتنبأ بما سيمرُّ.
ما حقيقة ما حصل عام 1997 عندما حصلتَ على جائزة الشعر العالمية في هولندا، وما الذي تخصني به بعد ما يقرب من ربع قرن على هذه الحادثة؟ وايضا عن الذي حصل عام 2006 في مهرجان المربد الشعري.. وما حقيقة التهديدات التي تعرضت لها؟
- أيضاً بعد ربع قرن على ما مرَّ، أجدني أسترجعُ تلكَ المكابداتِ والملاحقاتِ التي حصلتْ بعد حصولي على جائزة مهرجان الشِعر العالمي في روتردام – هولندا 1997، فقد وجهتُ رسالةً جريئةً إلى البروفسور فان دير ستاي رئيس منظمة الشعر العالمية وللمشاركين في المهرجان من دول العالم (تُرجمتْ الى عدة لغات) قلتُ فيها: «ونحن نحتفل الآن بالشِعر في هذا الكرنفال العالمي وأنتم تشرفونني والعراق بمنحي هذه الجائزة المهمة علينا أن نتوقفَ أمام قائمة طويلة من الشعراء والأدباء الذين غيّبهم النظام في مقابرهِ وسجونهِ وذكرتُ عدة أسماء منهم صديق الصبا والشعر والكوفة الشاعر علي الرماحي (غُيب عام 1979) والقاص حميد الزيدي، القاص حسن مطلك، والكاتب ضرغام هاشم، وقائمة الذبح والأنين تطول. بالإضافة إلى معاناة آلاف الأدباء والفنانين والمثقفين العراقيين الذين شُردوا خارج وطنهم. وقد جنّد النظام مرتزقته وقتها ولاحقوني لسنوات في أصقاع المنفى حتى سقوط النظام.
بعد سنوات من سقوط النظام، دُعيتُ للمشاركة في مهرجان المربد الشعري عام 2006 في البصرة، كان الوضع ملتبساً تماماً نتيجة سيطرة المليشيات المسلحة والعمائم الطائفية على الواقع العراقي الجديد. وبعد قراءتي لـ «نصوص مشاكسة قليلاً»، تقدمُ منّي أحد عناصر تلك المليشيات مزبداً مهدداً بقطع لساني لأنه رأى في قصيدتي تطاولاً على «الدين.
«لَمْ ترَ ربَّكَ/ إلّا بالنصلِ/ وبالدمْ
وقد أحاطني بعض أصدقائي من الأدباء من البصرة وخارجها الذين خَبروا تهديدات فرق الموت، وأوصلوني بمساعدة قائد عسكري شهم من الجيش عبر الصحراء إلى الكويت، لأعودَ إلى منفاي من جديد
إذن ما الذي تراه في من ورد اسمك في قائمة (المرتدين) في الداخل العراقي، والبيانات التي صدرت ضدك في المنفى، و(الحسد) الذي واجهته من بروزك المفاجئ في المشهد الشعري..؟
- الأمران على حدٍّ سواء وجهان لعملة واحدة، وهي العقلية الشمولية للسلطة، أيّاً كانتْ سياسيةً أو حزبيةً أو دينيةً أو ثقافيةً، مَنْ حكمتْ في الماضي ومَنْ أتى بعدها. دون أن يدركا أن المثقف والحرية والوطن والإنسان هم الباقون، وما عدا ذلك فإلى زوال. ودون أن يستوعبا دروس التاريخ أن الظلم لن يدوم، وأن مجد الإنسان هو الأبقى، وأن الكلمة الحرة لن يسكتها أو يخيفها وعدٌ أو وعيد. وهكذا ذهبتْ وستذهب مكائن إِعلامهم وثكناتهم العسكرية ومقصّات رقبائهم وقوائم تصفياتهم وغيرها.
إن بعض الأحزاب وبعض الأشخاص كانوا يملأون صفحات الجرائد والكتب والندوات بالحديث عن الحرية أو تجربتهم في التشرد والنفي من أجل وطنٍ بلا قمع وكتابات بلا رقابة، لكنك ما إن تصطدم معهم في أول حوار أو نقاش (وأنتما تعيشان في المنفى معاً، هاربين من القمع والتسلط والإلغاء) حتى تجد مخلفات شرطة وطنك كلها تبرز أمامك فجأة من بين ثيابهم العصرية المنتقاة بعناية شديدة… بل أنك ما أن تشير إلى رأيك المختلف أو المخالف لفقرة من فقرات كتبهم أو مناهجهم حتى يتحول هذا الحمل المقموع إلى أنياب لا تدري كيف أطبقت عليك بلمح البصر دون أن تتمكن من شرح وجهة نظرك أو تخليص نفسك والفرار بجلدك العاري…
نعم، تلك العقلية الشمولية هي التي أدخلتنا في حروب كارثية وبددت ثروات البلد وملأته مقابرَ جماعية ولافتاتٍ سوداً. ثم جاء من انتقدها وثار عليها. لكن سرعان ما حلَّ محلها بعد أن أبدل المسدسَ بالعمة، وأخذ منها مقولة مَن سبقه بحذافيرها: «كلُّ مَنْ ليس معنا فهو حتماً ضدنا»، سائراً على نهجها بالمصادرة والملاحقة والقمع والفساد والتشويه والتشريد وكواتم الصوت وإلى آخره. والدليل هو ما وصل إليه حالنا اليوم بعد حوالي 17 عاماً من سقوط الصنم وزوال حكم الطغيان. والدليل هو تواصل نزوح الكثير من المثقفين والمبدعين إلى المنافي.
أما عن الشق الثاني من سؤالك الكريم عن «البروز المفاجيء والحسد»، فأشير هنا إلى أنني تأخرت عن النشر لسنوات كثيرة حتى بالنسبة لأصغر أبناء جيلي الثمانيني سنَّاً لأسباب كثيرة ومريرة. فأول نصّ نُشر لي في الصفحة الثقافية في جريدة الجمهورية كان في 25 كانون الأول/ ديسمبر 1982 وكنتُ وقتها جندياً بائساً في تلك الحرب اللعينة، ولم أعرف بنشرها إلا بعد فترة وبعد أن انشغل الوسط بحكاية ما دار حولها بين الناقد يوسف نمر ذياب ورئيس تحرير الجريدة الشاعر سامي مهدي. وملخصها أن تلك القصيدة لفتت انتباه الناقد يوسف، فأرسل مقالة عنها إلى صحيفة «الجمهورية» التي كان يكتب فيها، تحت عنوان «صباح الخير أيها الشاعر» ويذكر اعجاب صديقه الكاتب مدني صالح فيها. إلا أن رئيس التحرير رفض نشر المقالة قائلاً إن كاتب القصيدة اسم غير معروف ينشر لأول مرة فكيف تكتب عن قصيدته الأولى مقالة كاملة من ناقد له اسمه. فيصرّ الناقد على نشرها، ويصرّ رئيس التحرير على رفضها. فيغادر الناقد يوسف موقعه في الجريدة ويدفعها إلى الصفحة الثقافة لجريدة الثورة فتنشر في شباط 1983. وهذه الحادثة أحدثت لغطاً وتفاعلاً في الوسط الثقافي. ثمَّ حمل غلاف ديواني الثاني كلمة للشاعر الكبير عبد الوهاب البياتي وأنا لم أتخط الثلاثين وديوانين. ثم تلتها اشادات نقّاد وأسماء مهمة مثل حسب الشيخ جعفر، رشدي العامل، حاتم الصكر، فاضل ثامر، ياسين النصير، د. عبد العزيز المقالح، د. خليل الشيخ، طراد الكبيسي، محمد الجزائري، حافظ محفوظ، عبد الجبار داوود البصري، عبد الجبار عباس، محمد مبارك، ماجد السامرائي، وغيرهم الكثير. أقولُ كل ذلك سلط الضوء بقوة على تجربتي مما أثار حفيظة بعض مجايلي في الوطن وغيرتهم..
والأمر نفسه عندما خرجت من الوطن عام 1993، فكان أول ديوان يصدر لي في المنفى عام 1994 يحمل كلمة الشاعر سعدي يوسف وثم أعيد طبعه فيما بعد وحمل إضافة إلى سعدي كلمة جبرا إبراهيم جبرا، وشيركو بيكه س. ثم صدر لي «نشيد أوروك» وقوبل بحفاوة بالغة، وهذا مما أثار حفيظة بعض مجايلي في المنفى أيضاً..
رغم احساسي الحقيقي بأنني لم أقلْ بعدُ ما أريدُ قوله. وربما أدعي أن عملي الجديد «نرد النصّ» يمكن أن يحمل الكثير ما لديَّ. وهنا لا بدَّ لي أن أتوقع وأنتظر زوبعة أخرى قادمة.
لي سؤال أخير قد لا يكون في السياق لكنه يلح علي من زمن طويل.. مجموعتك (سماء في خوذة - 1988) بعدها جاءت مجموعة الصديق الشاعر وسام هاشم (سهول في قفص - 1993).. وهنا نتذكر قصيدة مايكوفسكي (غيمة في بنطلون).. ما رأيك ما الذي يجمعهما؟
- أسّرتني قصيدة «غيمة في بنطلون» للشاعر المنتحر مايكوفسكي، بالإضافة الى قصائد كثيرة له فهو يحمل في داخله هذا التمرد الضروري لكل شاعر. أما المفارقة في العنوان وثنائية النقيضين. أي تداخل الواسع في الضيق وبالعكس، فقد سبقته ولحقته عناوين كثيرة أكثر من أن تُعدّ من الشاعر الفرنسي رامبو في قصيدته «فصل في الجحيم» عام 1873، وما فيها من تداخل الحواس أيضاً، حتى ديوان صديقنا الشاعر السوري عبد القادر الحصني «ينام في الأيقونة» عام 1994.
لقد كتب الناقد د. حاتم الصكر عن ديواني ذاك في دراسته المعنونة «الداخل الضيّق.. والخارج المتّسع عام 1988 سنة صدور ديواني. ومما يقول فيه: «.. وقصائد الصائغ لا تهادن موضوعها. إنها تجيء به إلى طقوسها ونظامها ولا تذهب إلى عناوينه أو كلياته. بمعنى أن الوحدة الصغرى (الذات) هي التي تجلب: بالشعر، الوحدة الكبرى (الموضوع) على عكس ما يفعله شعراء كثيرون يبدأون بالموضوع وبهذا نستطيع تفسير العنوان المحيّر: «سماء في خوذة». إنها علاقة الخارج بالداخل والواسع بالضيق والموضوع بالذات. فالسماء (أو الأفق المفتوح) هي التي حلّت في الأصغر (الخوذة أو الثقب). ومن هذه الخوذة أو الثقب في الجمجمة أو النافذة في غرفة أو الفتحة في موضع.. منها يتصل الشاعر بموضوعه: بالواسع الممتد خارج نفسه.. فيراه وهو في هيئة ضيّقة ولا يغريه اتساعه ليتيه أو يحلق. وليس هذا اقتراحاً لإقامة ثنائية مفترضة. فالخارج والداخل المرمّزان بالسماء والخوذة (والأفق والثقب أحياناً) يحتلّان الجزء الأكبر من آليات قصائد الصائغ»... والخ