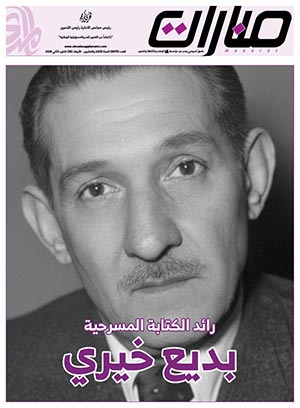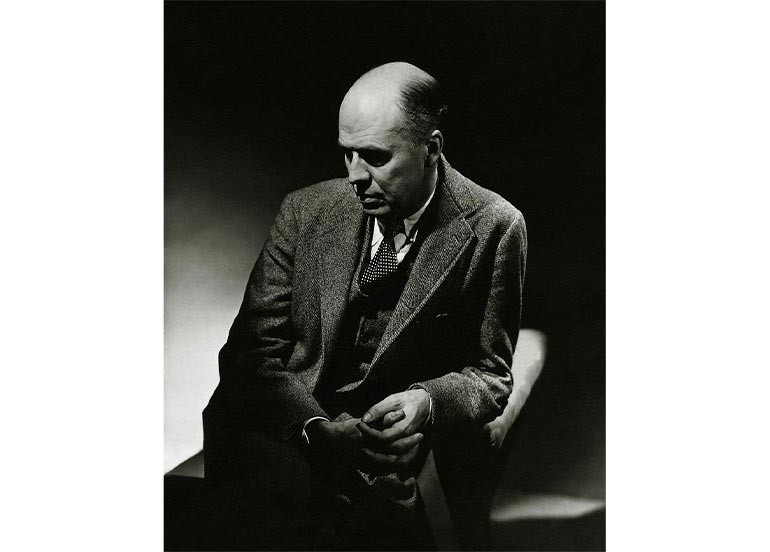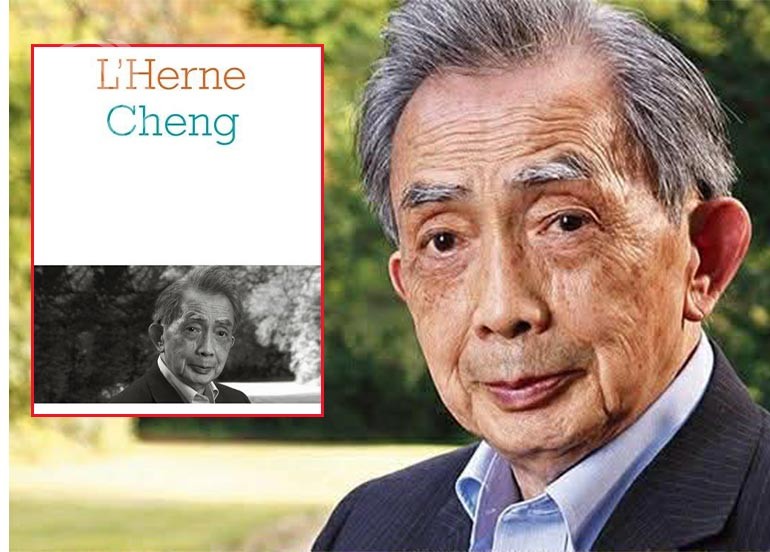ترجمة : عدوية الهلالي
عن دار روبرت لافونت للنشر، صدر مؤخرا كتاب (حرب الأفكار) للكاتبة والصحفية الفرنسية أوجيني باستيه في 312 صفحة،
والذي توثق فيه الكاتبة حرب الأفكار القاسية التي تتغير بمرور الوقت محاولة مساعدة القارئ على فهم أفضل للوضع الحالي في فرنسا ..
ويقوم الكتاب على استعراض رجعي للمواجهات الفكرية العظيمة الماضية راسما بانوراما حالية تعتمد بشكل خاص على العديد من اللقاءات والمقابلات التي كان من الممكن أن تجريها المؤلفة لمدة ثلاث سنوات مع المفكرين من جميع المشارب.
وحتى لو كانت المناقشات الفكرية في فرنسا ترجع إلى زمن بعيد ، فإن مصطلح “المثقف” نفسه ، كما تخبرنا الكاتبة، وُلد خلال قضية دريفوس. وكان مصطلحا ازدرائيا في البداية ، بل كان يمثل إهانة ، اذ يمكن تعريف المثقف منذ ذلك الحين على أنه الأكاديمي أو الكاتب أو الفيلسوف أو العالم الذي يترك تخصصه للخوض في شؤون المدينة مثل فولتير ، زولا ، جيد ، سارتر ، آرون ، الذين يشكلون بعض الأمثلة. لكن طبيعة النقاش تغيرت بشكل كبير على مر العقود. واليوم يصعب التمييز بين المثقف والخبير أو الصحفي الموجود على التلفزيون أو في وسائل التواصل الاجتماعي. فالعلاقات تغيرت أيضًا.
وما تُظهره لنا أوجيني باستيه بتذكيرنا بتاريخ النقاشات الفكرية التي تحولت أكثر نحو الصراع بعد تلك الفترة القصيرة جدا في تاريخ البشرية ، التي تقع مابين ظهور حبوب منع الحمل وظهور فيروس الإيدز ، وهي الفترة التي تميزت بالثورة الجنسية ..كما عرجت المؤلفة على فترة الثمانينيات والتسعينيات عندما أفسحت حرية معينة في التعبير المجال تدريجياً للمعارضة الطائفية ، وحتى القتال العدائي والتخصص المفرط الذي ابتعد عن الآراء العامة التي كان من الممكن أن تكون لدى مثقفي الماضي.
وعلى الرغم من كل شيء ، فقد تغير المشهد الفكري الفرنسي في السنوات الأخيرة.. وقد رأينا بالفعل نهاية هيمنة اليسار في عالم الأفكار. وهذا ما تظهره لنا أوجيني باستيه من خلال فصل عن النهضة المحافظة ، ولكن أيضًا في صعود اليمين الراديكالي ، الذي تبنى بدوره أفكار جرامشي. ومع ذلك ، لا يمكننا أن نقول - بعيدًا عن ذلك - أن اليسار سيهزم.
وفي ظل ظهور ساحة يقاتل فيها المحافظون والتقدميون على قدم المساواة ، فهي لا تزال (اليسار) في الواقع ، من خلال التأثير الذي تحتفظ به في التعليم والجامعة ورجال الدين والاعلام ، والذي يحدد قواعد اللعبة ، هم اللاعبون. والأفكار التي لهم الحق في مناقشتها.
ليس من السهل ، مع ذلك ، ان يعبر المرء عن نفسه بحرية في مواجهة صعود اليسار الراديكالي ، الذي تخللته دعوات للعنف والتمرد ، مقترنة في بعض الحالات بالحنين إلى الإرهاب ، والتطرف المفترض لفريديريك لوردون ، أو حتى الشعبوية اليسارية المستوحاة من شانتال موف وإرنستو لادو ، وهؤلاء الذين ينوون تفكيك اليمين.
وإذا انحسر عنه الرأي العام ، وإذا صدمه مثقفو اليمين في وسائل الإعلام ، فإن اليسار الثقافي لا يزال في المنزل وفي الجامعة ، إن لم يكن متطرفًا. ففي جامعة السوربون ، حقق الماجستير في دراسات النوع نجاحًا كبيرًا ، وتشق دراسات ما بعد الاستعمار طريقها في الجنس والعرق ، مع هواجس مستوردة من الجامعات الأمريكية ، حيث يتخصص المرء أكثر فأكثر وفقًا لموضوع الدراسة بدلاً من التخصص ، وتترسخ أكثر فأكثر “ديكتاتورية الهويات” في قلب الجامعات الفرنسية. وغالبًا ماحل عهد الصورة واللقطات والعاطفة محل النقاش ثم حل إلغاء الثقافة بسبب الانجراف الذي نعرفه الى اليوم الولايات المتحدة ،والذي انتهى به الأمر إلى قتل كل النقاش بطريقة مقلقة للغاية.
ووفقًا لمسح شمل 1500 طالب في عدة جامعات أمريكية ، يعتقد 51٪ منهم أنه من المقبول ايقاف متحدث لا نتفق معه بالصراخ في مؤتمر ما، ويعتقد 20٪ أنه من المشروع استخدام العنف ..كما لم نعد نتردد في جر المثقفين الى المحاكم مثل بروكنر ، أو بن سوسان ، أو هوليبيك الذين نبحث عن كل كلمة لهم لنجد شيئًا لإدانتهم ، وإسكاتهم بشكل مثالي.اذن ، يبقى اليسار الراديكالي في الصدارة.و ينتهي الصراع الإعلامي بقتل الجدل والنقاش ..
وهنالك فصل في الكتاب مخصص للمصطلح النيوليبرالي الرائج أيضًا ، كما أنه يحدد بوضوح المؤلفين التاريخيين العظماء للتقليد الليبرالي الفرنسي. ويبدو ان الهزيمة الفكرية لليبرالية واضحة للعيان اذ تتجول كتب الشعبويين والمحافظين واليسار الراديكالي على رفوف المكتبات. ففي الولايات المتحدة ، لم يكن الاقتصاديون الفرنسيون الذين انتصروا ليبراليين بل اشتراكيين. لكن المؤلفة تدرك ان الدفاع عن الخصوصية ضد رأسمالية المراقبة ، وحماية حرية التعبير في عصر الرقابة الجديدة يمنح الليبرالية دورا لتلعبه في التحديات الجديدة للقرن الحادي والعشرين. ففي مواجهة الديكتاتورية التكنولوجية وصراع الشبكات الاجتماعية ، أصبحت مسألة حرية الفرد وقدرته على مقاومة الضغط الاجتماعي وثقافة النقاش ضرورية مرة أخرى. وتعتمد إمكانية الحياة الفكرية على ذلك.
ويبدو ان اليسار ، من جانبه ، قد تغير كثيرًا كما يبدو أنه في حالة فوضى. فلم يعد العديد من المثقفين يجدون أنفسهم في المنعطفات التي اتخذوها في السنوات الأخيرة.فهل ان اليسار هو الذي خسر معركة الأفكار أم اليمين هو الذي انتصر فيها؟ هناك إجابة ثالثة: لا.
أدت الانقسامات الأيديولوجية الجديدة إلى محو هذه الحدود الفكرية التي تعود إلى الثورة الفرنسية ، ولم تعد العديد من الشخصيات البارزة في مجال الفكر يتعرفون على أنفسهم في هذا الانقسام الحزبي ، فعندما وُصف بعض المفكرين المشهورين بأنهم رجعيون جدد في أعقاب الهجوم الرسمي على دانيال ليندربيرغ في عام 2002 ، أليس الواقع هو الذي تغير؟ تسأل أوجيني باستيه. بينما يواصل مثقفون مثل ، آلان فينكيلكراوت ، وباسكال بروكنر ، ولوك فيري ، وبيير نورا ، ومارسيل غوشيت ، من بين آخرين ، تعريف أنفسهم بأنهم من اليسار.لكنهم لا يعترفون بأنفسهم في إنكار الواقع ، ولا في التعددية الثقافية أو معاداة الرأسمالية التي تهيمن على اليسار اليوم. وبالتالي ، تصبح هذه الحقوق غير قابلة للتوفيق بينها..
وفي الفصل الثالث والأخير من الكتاب ، تدرس أوجيني باستيه الصراع الفكري الحقيقي الذي يسود التاريخ ،.وينتهي العمل بفصول مكرسة تباعاً للراديكالية النسوية (وتناقضاتها) ، مرة أخرى دون تفكير بسيط أو اعتدال ، بسبب دخول العرق في الجامعة وبشكل أكثر عمومًا في المجتمع مع كل الآثار الضارة التي نعرفها كثيرًا الآن.فعلى جدران جامعة السوربون ، لم يعد المرء يقرأ شعارات تدعو إلى الثورة والحرية بل الى العنصرية وكل عناصر التعصب الذي أصبح مقلقًا والذي يصيب مجتمعنا بشكل متزايد، ما يدعو إلى التشكيك في مفاهيم مثل العالمية أو حتى التنوع. وبالتالي يسمح لنا بقياس إلى أي مدى نجد أنفسنا منغمسين في انحدار فكري لا يُصدق ومقلق أكثر.
ومن خلال”حرب الأفكار” قد نسأل أنفسنا ، هل سننتقل إلى الحرب (الأهلية) ؟ تشير الأخبار المبالغ بها واستحالة النقاش أحيانًا إلى أننا لسنا بعيدين جدًا عن ذلك ...لكن أوجيني باستيه يريد أن يكون أكثر تفاؤلاً وباعثا للأمل من خلال كتابه مشيرا الى ان بمقدورنا أن نعتقد أن الأفكار هي التي توجه العالم ، وبهذا المعنى يجب ألا نستسلم أبدًا ، بل على العكس ، نحشد أنفسنا باستمرار لمحاولة تطوير المعرفة.، ذلك ان مصير البشرية يعتمد على الأفكار.
وهكذا ، فإن النقاش الفكري المعاصر مبني على مبدأين متعارضين: النسبية وعدم التسامح مع آراء الآخرين. فقد تم تعقيد إمكانية الوصول إلى الحقيقة بدقة ، وفي نفس الوقت ، يعتقد كل شخص أنه صاحب “افكاره” التي يؤكدها بطريقة دوغماتية في النقاش العام ، من دون إعطاء أية قيمة لأحكام الآخرين. وهذا هو جوهر المسألة. فليس من ينتصر هو الأقوى ، بل الأضعف والأكثر مهارة. كما ان من ينتصر في المعركة الأيديولوجية هو من يصرخ بأعلى صوت. فلم يعد هناك آراء ، هناك مشاعر فقط ، ولم يعد هنالك واقع بل تفسيرات ...
في هذه الفوضى الكبيرة من الذاتية ، ما الذي لا يزال بإمكان المثقفين فعله؟ فعندما ُيحسب الجنس أو لون البشرة أكثر من محتوى العمل أو الخطاب ، يبدو العقل عاجزًا عن توجيه التاريخ. ولكن على الرغم من هذا العجز ، أعتقد أن المثقفين لا غنى عنهم أكثر من أي وقت مضى. ليس لتشكيل الطليعة التي تمهد طريق التاريخ ،والشعلة التي تنيرالدرب للجماهير في الثورة ، ولكن لمحاولة متواضعة لإحداث فارق بسيط حيث تسود المانوية ، والشك مكان العقل ..