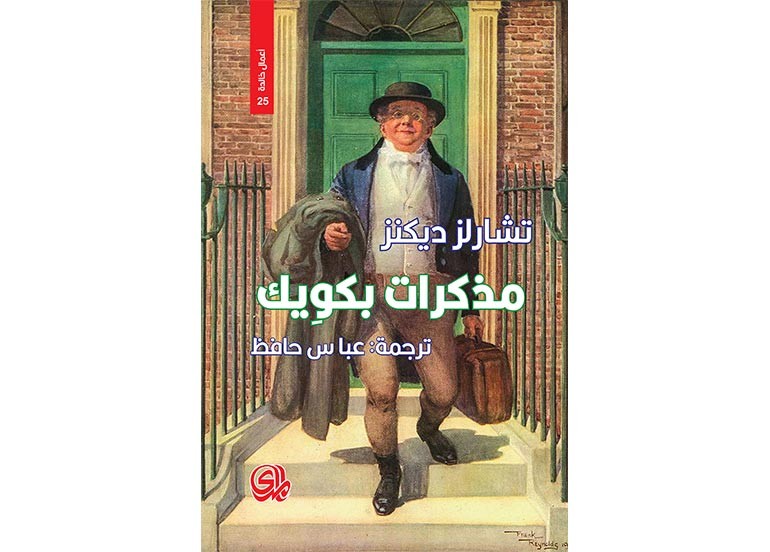انتبهت الى قول ميخائيل باختين، وهو يتحدث عن "التعدد الصوتي في الخطاب الروائي /ترجمة الاستاذ محمد برادة/يقول: النقد الدلالي للرمز الشعري يفترض وحدة ومطابقة الصوت لنفسه وتوحّده الكامل داخل كلامه. ولمجرد ما يرتاد لعبة الرمز هذه صوتٌ اجنبي أو نظرةٌ اجنبي
انتبهت الى قول ميخائيل باختين، وهو يتحدث عن "التعدد الصوتي في الخطاب الروائي /ترجمة الاستاذ محمد برادة/
يقول:
النقد الدلالي للرمز الشعري يفترض وحدة ومطابقة الصوت لنفسه وتوحّده الكامل داخل كلامه. ولمجرد ما يرتاد لعبة الرمز هذه صوتٌ اجنبي أو نظرةٌ اجنبية،
أو وجهةُ نظرٍ محتملة مخالفة ،
فإن المستوى الشعري يتحطّم والرمز يُنْقَل الى مستوى النثر.."
وطبعاً المقصود هنا بالأجنبي و المخالف، هو أيّ طارئ على نحو الرمز ومدى عمله. يقتحم القصيدة ما يضطرها على افتقاد صفائها الشعري وامتيازها الخاص الى النثر. ليس في الانتقال الى النثر انتقاص إلا بمعنى خسارة التكوين الشعري وتحوّل البنية الشعرية الى ما يسبب ضياع خيط الاضاءة السري فيها. والا فلكل الاجناس الأدبية فضائلها. المقصود إذن هو قسر النص الشعري على تغيير طبيعته وفعله..
وطبعاً لهذا القول الذي قال به باختين، جذر إغريقي، فحواه، كما اورده بوضوح هوراس في فن الشعر، أن كثرة الشعر في الخطابة يضر بخطابيتها، أي فنها الخطابي. كما أن كثرة النثر تُفسد شعرية القصيدة، أي فنها الشعري. وهذا هو ما كان يؤكد عليه نقّاد الشعر ودارسوه بضرورة أن تمتلك القصيدة موضوعها وجوّهاً وامتيازها في وحدة الموضوع، لكي لا تسيح فلا بُعدَ لها.
لكن الواقع الجديد وحركة العصر وتنوع مفرداته، اعادت فتح الآفاق الملحمية لحركة النص. امتلكت القصائد التي تجاوزت الغنائية شراهتها في استيعاب التنوع الهائل والمتجدد لمفردات العصر في العيش والعمل والفكر وحيوية اللغة واستيلاداتها مما تحتاجه الكتابة من اشارات. هذه الموضوعات والمشاهد والأحداث وتنوّعات الحرج الانساني في العيش والمواجهات، فرضت على القصيدة توسّعاً في العواطف وتنوّعات في الانتقالات. فبالنسبة لشعر اليوم، ما عاد ممكناً ابتعاده عن مؤثرات السرد ومناطق حركته أو نفوذه، حتى صارت السردية في الشعر موضوعاً للدرس ومادة للاطاريح.
السؤال الآن: إذا كان السرد وارداً في الكتابة الشعرية وقديم هو في شعر الملاحم مروراً بالبالاد والتروبا دور وكل الحكايا الشعرية، فما الذي يخيفنا اليوم منه؟
القصيدة الحديثة، مثلما افتقدت نقاءها الشعري، فجرَها البكر، وذلك الصفاء الذي كان موضع الثناء، افادت من انسجام أو هرمونية الاصوات التي أشار لها باختين. لكن لا ننس أن باختين، بأستاذيته، اشترط الانسجام. ومن غير هذا التناسق والهرمونية المفترضة في عموم تفاصيل القصيدة ومشاهدها، تنفرط وتتحول نثراً. وحين اقول تتحول نثراً، اعني هنا تتحول سرداً وليس شعراً سردياً. وهذا الانسجام من ناحية أخرى، أو هذه الهرمونية، قد تجعل من المقطع الروائي حاملاً لصفة الشعر أو تُقرّبهُ للقصيدة. وكَم نحس بشعرية في الرواية احياناً، في بعض من مقاطعها أو في العمل مكتملاً ..
لكن احتضان أو لملمة القصيدة لشتات من مفردات الحياة والأفكار وكثرة الانتقالات، من غير أن يحكمها شكل شعري، يجعلنا بعيدين عن مواصفات القصيدة، بعيدين عن الشعر، تظل عندئذ كلاماً وأن امتلك ذكاءً. القصيدة غير الكلام ذي الومضات. ذلك كلام ذكي أو حيّ والقصيدة به تصبح احياناً بخطابها اليومي من عموم الكلام والتعليقات. الاختراقات، بغفلة من الفن تصيب القصيدة بالهُجْنة الشعرية، كما الاختراقات بغفلة عن سلامة الخطاب الروائي، لا تُبقيه فناً سليماً وتصبح غرابته غير مقبولة ضمن التقليد فهو لا يمتلك، بسبب ركاكة تماسكه، فضيلة التجديد. وعي الفن اساس ابتداعه. ووعي الحرية اساس الإفادة منها. والخلط دائماً مدمر للفنون وإن بعد حين ...
ثمّة ملاحظة، نحاول قدر الامكان، الا تؤخرنا عن أكمال رأينا. تلك هي أن باختين يشير الى ما يسوّغ "الطارئ" أحياناً. يقول: الاجناس الشعرية المنظومة (الغنائية مثلاً)، المُدْرَجة في رواية، يمكن أن تكون قصدية شعرياً وبكيفية مباشرة، من دون سوء نيّة. هذا ما ينطبق، مثلاً، على الاشعار التي ادخلها جوتيه الى روايته "ويليم ميستر" . وكان الرومانسيون يدرجون أبياتاً شعرية في الرواية باعتبارها تعبيرات عن نوايا الكاتب) بمثابة مكوِّنه للجنس الروائي. وفي حالات أخرى، تقوم القصائد المُدْمجة بتفسير نوايا الكاتب، مثلاً، قصيدة لينسكي في رواية اوجين أو نجين لبوشكين "الى اين حلقتم..".
هذه ، كما ترون وكما يذكر باختين، قد تكون نوعاً من الاسلبة الباروكية ... الإشارة ضرورية للتمييز بين أن ينحو السرد الى الشعر، نتيجة عدم صفاء الفن وأن يريك السرد البنية العامة للنص الشعري. هنا النص الشعري، مكتمل، حَطّ في موضع آخر وظل شعراً محتفظاً بمزاياه. التوظيف هو الذي اختلف.
في موضوعنا قد يتمكن "فن الكتابه الادبي" من أن يغدق المزيد من الشعر على السرد، أو حتى على الكلام. لكنَّ أيّاً من هذه "التجديدات" أو التوظيفات، ان كانت مقصودة ، واي نوع من التطوير للعمل الفني...، لن يجديا العمل إذا لم يستندا الى تصور مسبق انضجته الثقافة والخبرة ، فهو الآن في التطبيق. معنى كلامنا: اوجبه كلا الفن والضرورة.
بقيت لنا ملاحظة، هي أن الرغبة بتجديد الفن عن طريق احداث تغييرات، بطواريْ على انسجام، أو على هرمونية حالة التآلف بين عناصره وشروطه لن يتم بنجاح، بمعزل عن طبيعة البناء اللغوي واستجابته السليمة، لهذا التحول. فمثلما قد يفيد الانزياح في عبارة، تراه مربكاً وسبب اسقاط في عبارة أخرى. الجهد في رسم الجملة هو اساساً لتوسيع مقدرتها على التعبير. بمعنى آخر وكما يريد باختين: لتوسيع قدرتها على الاستيعاب وقدرتها على تبني الرمز. تجميع "الأشياء" وضخّها على الورق، يبقيها أشياء وورقاً. المنظور الادبي وحضور الفن هما اللذان يجعلان من الكتابة عملاً فنياً وبمعنى آخر. بنية جمالية صالحة لحيوية الرموز.
إن احداً لا يستطيع نكران حقيقة أن الرواية، منذ نشأتها وحتى اليوم، تشارك الملحمة في الكثير من مضامينها وصياغات لغتها. أي انها تشارك في المدى الشعري الكبير. وقد اعتمدت الاعمال الشعرية في مروياتها والمشاهد على سرد لا يقلل من شأنه قربه الفني من السرد الروائي. مع ذلك لا أحد يشكك باستقلالية الفن الروائي ولا استقلالية الملحمة او القصيدة. ما يبقى الامور في صوابها هو عدم تجاوز - الثقافة الشعرية.
والشاعر لا يمكن – مهما تمرّدَ، الا أن يحتكم في مجمل عمله الى ثقافة ناقد الشعر، بمعنى لا الى الاخلاقية النقدية، ولكن الى مركزية الوعي المتخصص. كما هو غير صحيح تجاوز الثقافة الروائية واحترام المجمل النقدي. ثقافة الناقد الروائي مدى مهم من ثقافة متخصصة. وإلا، فعلى أي الأسس تقوم الحضارة إذا ألغينا أهمية التخصص والغينا انظمة العمل التي انضجتها التجارب؟ المغامرات ناضجةً تقيد الفنون بجرأتها. لكن عبثيتها الجاهلة تفقد أي عمل خصائص أو شروط ديمومته ... كلا المبدع والناقد في حال اكتمال الجد، يحرصان على عمل مهم مشترك. ذلكم هو عدم انفراط القلادة الذهبية، خشية على ما يحفظ ذخيرة العالم الروحية وخلاصة مسيرته....