لطفية الدليمي
وأنا أكتبُ هذه المقالة صباح يوم 4 شباط يكون كتابُ مذكّرات (بل غيتس) عن طفولته قد نُشِر في كلّ العالم. لا عجب أنْ يخصّ غيتس طفولته بكتاب كامل في مذكّراته التي ستتلوها كتبٌ لاحقة تختصُّ بمفاصل أخرى في حياته: تأسيسه لشركة مايكروسوفت، ثمّ انشغاله بالأعمال الخيرية. كلٌّ من هذين المفصلين سيكون له كتابٌ كاملٌ في مذكّرات غيتس اللاحقة.
جرت العادة في الامثال أن يقال (الطفل هو الرجل). ربما الأصحّ هو القول: الطفل هو الإنسان رجلاً كان أم إمرأة. إسقاطاتُ الطفولة شبيهة بالإعدادات المصنعية الأولى للأجهزة الألكترونية. لن نستطيع إلغاء هذه الإعدادات مهما حاولنا؛ بل ربّما العكس هو ما يحصل غالباً. عندما تعترضنا عقبةٌ هائلةٌ فنحنُ في العادة نلتمسُ نوعاً من الخلاص أو السكينة أو العلاج المفترض في إعدادات الطفولة الأولى حتى لو جاء الأمرُ من باب التوق النوستالجي إلى أيّام مضت وانقضت. يحصلُ هذا الأمر عندما تكون ذكريات الطفولة طيّبة أو غير مشوبة في الأقلّ بما يُمرِضُ القلب والروح؛ لكن لن يكون الأمر هكذا عندما تكون الذكريات قاسية أو ظالمة بكيفية غير مسوّغة، وسيتفاقمُ الحال بالتأكيد لو حصل هذا الظلم مع طفلٍ يعرفُ في دواخله أنّه يحوز نباهة وشغفاً ورغبة في التعلّم والإرتقاء خارج السياقات الكابحة والمحدّدة التي يُرادُ له العملُ في نطاقها. يتّخذُ الشكل الشائع لكبح تطلّعات الطفولة وطموحاتها المتفجّرة نمطاً مؤسسياً يتمظهر في ثلاث مؤسسات: العائلة، المدرسة، الحكومة. المؤسّسة هنا هي إشارة إلى النمط الهرمي التراتبي في ممارسة السلطة الفعلية أو الرمزية.
ربّما يمثلُ فؤاد عجمي (1945-2014) مثالاً لما ذكرتُ أعلاه، وأعترفُ بوضوح أنني أمقتُ فكر عجمي ومقارباته الإستشراقية المستحدثة، وتكرّس مقتي له بعدما ظهر في صورة شائعة له وهو يتوسّطُ بوش الإبن وزوجته في البيت الأبيض عقب غزو العراق. لم نعرف عن عجمي الكثير قبل غزو العراق 2003، ثمّ بعدما حصل الغزو شاع إسمُه وصار قرينة شرطية مع برنارد لويس باعتبارهما إثنيْن من صانعي الإستشراق الجديد والعقول المفكّرة الداعمة لمدرسة المحافظين الجدد. ثمّة الكثيرُ ممّا كُتب ويُكتبُ عن عجمي، والخصيصة السائدة عنه أنّه كارهٌ للعرب، ويتقاطعُ مع مدرسة الإستشراق المعرفي ذات الأصول البحثية الراسخة والرصينة. صار الإستشراق الجديد صناعة سريعة التحضير كما الأكلات الجاهزة، ولم تعد الجامعات العريقة ميدانه بل تكفّلت به مراكز البحوث ذات التوجّهات الآيديولوجية المشخّصة. الغريب وغير المفهوم في مسيرة عجمي العلمية أنّ بداياته تختلف إختلافاً نوعياً عمّا انتهى إليه، وربما تكون المناظرة المشحونة ثم القطيعة بينه وإدوارد سعيد علامة على تحوّل جوهري في فكره. لسنا هنا قارئين ما هو مختزنٌ في الصدور والقلوب، وليس القفز السريع إلى التسويغات الجاهزة في ملامة الآخرين وإلقاء عبء تخلفنا عليهم مقاربة مفيدة. أظنُّ أنّ معضلة عجمي تكمنُ في تضاعيف طفولته المعقّدة والتي لم تخلُ من بؤس ومشقات في بعض مقاطعها الزمنية. أؤكّدُ ثانية: أجدني أختزنُ نفوراً عارماً من عجمي وأطروحاته؛ لكنّ هذا النفور لا يصحُّ أن يصدّنا عن قراءة الرجل وأفكاره.
نشرت زوجة عجمي عام 2022 بعضاً من مذكّرات زوجها المبعثرة في قصاصات ورقية، واختارت لها (وربما زوجها هو من اختار العنوان قبل رحيله) عنواناً مثيراً: عندما فشل السحر When Magic Failed، مع عنوان ثانوي أكثر إثارة: مذكراتُ طفولة لبنانية عالقة بين الشرق والغرب. السحر في العنوان الرئيسي يرتبط جوهرياً بولادة عجمي الذي ربّما أرادته والدته وسيلة لكبح زوجها عن مغامراته النسائية الكثيرة؛ لكنّها فشلت وكان الطلاق نهاية علاقتها مع زوجها. عاش عجمي مع والدته المطلّقة حياة قاسية أقرب إلى عيش المهجّرين أو اللاجئين، وما كان في خلده أنّه سيكون شخصاً ناجحاً أو متفوّقاً؛ لكنّ شيئاً من حظ طيّب جعل أباه يتحصّلُ على مال أتاح له تسجيل إبنه في مدرسة أمريكية في لبنان. في تلك المدرسة كانت إنطلاقة عجمي الحقيقية. يؤكّدُ عجمي في مذكرات طفولته أنّ تلك المدرسة الأمريكية هي التي جعلته يفهم معنى التفكير النقدي والمساءلة المعرفية الفردية والمخلصة في مفارقة هائلة بينها وما كان سائداً في المدارس الحكومية التي شجّعت الطلاب على الحفظ والتلقين، وقمعت كلّ أشكال التفكير الحرّ لديهم. واصل عجمي دراساته الجامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت، ثمّ لاحقاً في جامعات أمريكية عدّة منها برنستون و جونز هوبكنز التي حلّ فيها محلّ الراحل الدكتور (مجيد خدّوري) في رئاسة مركز دراسات الشرق الأوسط. لم يُبدِ خدوري رغبة في أن يكون عجمي خليفته؛ لكنْ ما كلّ ما يريده المرء يحصل كما يشتهي. عوامل كثيرة تلعب أدواراً خفية أو صريحة حتى في الميدان الأكاديمي الذي يُفترضُ فيه القدْرُ الأعلى من النزاهة.
تتأسّسُ أطروحة عجمي (التي يراها كثيرٌ من المفكّرين الغربيين قبل العرب متعسّفة وفوقية وتفتقد المصداقية العملية) على أنّ تغيير المجتمعات المتخلّفة لا بدّ أن يقترن بالقوّة الضاربة. إنّه التمثّلُ الصريح للمثل الصيني الذي يفيدُ بإمكانية أن تتحدّث بهدوء مع الآخرين؛ لكن لا تنس أن تريهم العصا الغليظة التي تحملها . واضحٌ أنّه يخاطبُ الإدارة الأمريكية بهذه المثال. العنوان العام والشامل في ذاته قد تكون له مصداقية كبيرة لو إقترن بالنيّات الحسنة؛ لكن هل توجد نيّات حسنة في ممارسة السياسة العالمية من جانب قوّة أخطبوطية متعدّدة الأذرع مثل الولايات المتّحدة؟ ربما لو كانت حكومةٌ هي التي تقود مسيرة التغيير عبر ممارسة نوعٍ محدّد من القوّة المسندة بسطوة القانون لكنّا سنتفهّمُ الوضع كما حصل مثلاً في تجربة (محمّد علي) في مصر؛ لكن أن يحصل التغيير على يد قوّة أجنبية (كما حصل في غزو العراق عام 2003) فهذا ما سيرمينا في أتون الظنون بأنّ العناوين البرّاقة للتغيير وكبح سطوة التخلّف ليست سوى أخدوعة مهلهلة. تسويغُ عجمي لإستخدام القوّة يستوجبُ التفكّر طويلاً وبهدوء ومن غير انفعالات متسرّعة. أظنُّ أنّ أطروحة عجمي تأسّست على خبرات طفولته، وهو ما يتوجّبُ علينا أن ننتبه إليه كثيراً.
يذكّرني عجمي بشخصية أخرى عانت شعوراً مزمناً بمرارة قاسية تجاه بلدها (مصر). أقصد (إيهاب حسن) أحد صانعي ما بعد الحداثة الأدبية. يقول في مذكّراته (الخروج من مصر): «عندما غادرتُ ميناء الإسكندرية عام 1946 عرفتُ أنني لن أعود لمصر ثانية طالما بقيتُ حيّاً». ظلّ الرجل وفياً لما إعتزمه ولم يزر مصر حتى وفاته. لماذا فعل ذلك؟ السرّ يكمنُ في الطفولة. قد يكون مشهداً قصيراً ربما لم يتعدّ الدقيقة ولكنّه تكفّل بإحداث جرحٍ غائر في النفس والروح وتبدّى في شكل كراهية معلنة. أعتقدُ بقوّة أنّ مثل هؤلاء لا يكرهون بلدانهم بقدر ما يكرهون مؤسّسات شاخصة فيها أظنّها واحدة من ثلاث هي التي ذكرتها سابقاً: العائلة، المدرسة، الحكومة. الفارق الأوضح بين تجربة عجمي وحسن هو أنّ الثاني ذهب لأمريكا طلباً لإكمال الدكتوراه في الهندسة الكهربائية، ثمّ إنعطف هناك نحو الأدب والدراسات الثقافية. المشتغلون في العلم والهندسة غالباً ما تكون مفاعيل الذاكرة أقلّ تأثيراً في توجهاتهم اللاحقة بعكس ما يحصلُ مع المشتغلين في الحقول الإنسانية، وحتى في الحقول الإنسانية تتفاوت مفاعيل الذاكرة الطفولية تبعاً لمطواعية الحقل البحثي على خدمة التوجّه الآيديولوجي. الإستشراق بالتأكيد حاملٌ أكثر استجابة من الأدب لجروح الذاكرة وأعطابها الغائرة.
لستُ هنا في معرض تسويغ أيّ توجّه فكري لا يحملُ ودّاً أو تصالحاً أو في الأقلّ حسّاً بارداً وحيادياً مع الأوطان الأولى وأهلها؛ غير أنّنا يجب أن نفهم الأسباب التي تجعل كائناً ما يختزنُ نفوراً مرّاً من بلده وأهل بلده. الأهمّ من هذا - وهو ما يصيبني برعب ممضّ عندما أفكّرُ في مضاعفاته غير المنظورة- هو كيف سيكون سلوك نظراء فؤاد عجمي من عراقيين معاصرين أذكياء وألمعيين سحقتهم عجلة الغباء الحكومي والمدرسي والعائلي ثمّ أتيحت لهم ظروف الخلاص بفعل جهدهم الذاتي أو بحظّ طيب؟ ماذا سيفعلون عندما يكتشفون حقائق الحياة البائسة التي أرادها لهم العابثون المتخلّفون والماكثون في مستوطنات الجهل والخرافة؟
منابع الكراهية غالباً ما تختفي هناك في تضاريس الطفولة التي تبقى أسراراً لا يُحكى عنها. بعضُ فضائل عجمي وحسن أنهما آثرا الحديث والكشف بدلاً من أخذ تلك الأسرار معهما إلى النسيان.
قناديل: كراهيةٌ تستوطنُ ذاكرة الطفولة
نشر في: 9 فبراير, 2025: 12:04 ص


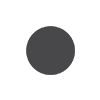








جميع التعليقات 1
دكتور سمير ليلو
منذ 1 سنة
احسنتي ياست لطفية على هذا البحث المهم جدا هذه الايام وخاصة للعراق حيث اصبحت مغادرة الوطن والعيش في الدول المتقدمة مودة لدى الجميع مع الاسف وهذه الضاهرة تحتاج للمزيد من البحث للوصول الى المعالجة لهذا الجيل الجديد وبالنسبة لما جاء في مقالكم اود ان اشير الى