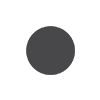لطفية الدليمي
لِما يزيدُ عن الخمس عشرة سنة وأنا مواظبةٌ على كتابة مقالة أسبوعية في (المدى). اليوم سأروي بعضاً من مسرّات وشجون كتابة المقالة.
حتى عام 2009 كنتُ أكتبُ مقالاتٍ متفرّقة في موضوعات شتّى في صحف عراقية وعربية. لم تكن المقالة الأسبوعية نشاطاً ثابتاً مستمرا ليتحول الى تقليد يعرفه القراء. كانت الكتابة موسميّة وغالباً ما تكون تحت عنوان كبير ضمن محور ثقافي. لم تكن المقالة حينذاك إعلاناً مكتفياً بذاته يتناول موضوعة محدّدة، فضلاً عن أنّ معظم مقالاتي تميزت بخصيصة أدبية واضحة.
مع مقدم عام 2009 إختلف الأمر وشهد إنعطافة مهمة في حياتي. صارت كتابة المقالة الأسبوعية نشاطاً متّسماً بالإستمرارية والثبات وسِعَة طيف الموضوعات المتناولة. لو أردتُ توصيف هذا الجهد (المقالي) فسأقول باختصار مكثّف أنّ كتابة المقالة جهدٌ متطلّبٌ قد تثقلُ موازينُ مشقّاته لو وُضِعَتْ في موضع المقارنة مع فعاليات ثقافية أخرى. أظنّ هذه المشقّة هي التي تجعلُ كبار الكتّاب العالميين يعزفون عن كتابة مقالة منتظمة حتى لو كانت في كبريات الصحافة العالمية.
، وبعد هذا هم لا يشاؤون بعثرة أفكارهم وتشتيتها في مسارات متشعّبة. قد يكتفون بين حين وآخر بمقالة عن موضوعة محدّدة؛ لكنّ الإرتباط الثابت لا يطيقونه أبداً وبخاصة أنّهم إعتادوا حفلات الإشادة والإطناب في مديح أعمالهم المنشورة وماعادوا يتحمّلون غير هذا النمط من الإشهارات الإحتفائية لما يكتبون حتى لو كان مقالة من ثلاثمائة كلمة في صحيفة (الغارديان) مثلما فعلت الروائية الإيطالية (إيلينا فيرانتي) لسنة واحدة ثمّ أوقفت الكتابة تحت مسوّغات كتبت عنها في مقالتها الأخيرة في الصحيفة، وما كانت تلك المسوّغات مقنعة أبداً.
أبدأ أولاً بنوع المقالة التي أحبّ من حيث تواترها الزمني: يومية أم أسبوعية أم شهرية. أعترفُ أنّ المقالة اليومية لا تستهويني أبداً. هذا النمط له (أسطواته) الذين يعرفهم القارئ العراقي و العربي. لا أظنّ أنّ أربعاً وعشرين ساعة تكفيني لتقليب أوجه التفكير في موضوعة لأكتبها في حيّز لا يتجاوز المائتين وخمسين او ثلاثمائة كلمة في أبعد تقدير. ثمّ أنّ إطلالتك اليومية على قارئيك تتطلّبُ منك إضافة نوع من (التوابل) و(القفشات) التي يجيدها بعض الكتاب، أو أن تقتصر على متابعة الشأن السياسي الطارئ والراهن بطريقة مباشرة لا تستدعي التعليل والتسبيب والتفكر الهادئ. أما المقالة الشهرية فقد جرّبتُها من قبلُ؛ لكنّ كتابة مقالة يتيمة كلّ شهر ليست بالفعالية التي تحفّزُ الإنضباط والنظام والمطاولة وخلق تقاليد عمل تتسمُ بالفعالية والقدرة على الإنجاز. المقالة الأسبوعية تبدو الخيار الأفضل بالنسبة لي بين المقالتين اليومية والشهرية.
الأمر الثاني هو طبيعة المادة المكتوبة: عمّ يكتب الكاتب؟ ربّما يظنّ كثيرون منّا أنّ المقالة فنّ مُيسّرٌ لأنّ للكاتب الحريةَ المطلقةَ في أن يكتب عمّا يشاء. هذه نظرة غير خبيرة ومن خارج مشغل الكاتب. العكس هو الصحيح. كثرة الخيارات قد تسبب تشويشا لأفكار الكاتب. كثرة الخيارات بقدر ما هي قرينة الحرية الممتعة لكنّها في الوقت ذاته تحدث قدرا من التشويش الذي لابد من كبحه وتقييده. قد يجلس الكاتب ساعات طوالاً وهو يتفكّرُ في كثرة من الموضوعات؛ وهو يريد موضوعا مقنعا له أولا قبل ان يكون لقارئه.
بعد معضلة كثرة الخيارات تواجهك حيرة في أيّ شأن تكتب: سياسة أم إقتصاد ام ثقافة أم فلسفة،،،،؟ المقالة الثقافية هي أشبه بالمظلّة التي تغطي كلّ الفعاليات الفكرية البشرية لاتقتصر على الادب وحده. كلّ مايفعله البشر هو فعالية مدفوعة بمحفّز ثقافي، وستكون له بالضرورة مفاعيل ثقافية متنوعة. شخصيا أعشق الكتابة عن التخليقات الثقافية المركّبة حتى لو كانت نقطة الشروع في الكتابة موضوعة سياسية محدّدة أو مفهوماً ثقافياً ينطوي على مقاربات إشكالية. واذكر على سبيل المثال أنّني كتبتُ غير مرّة عن الحرب الروسية – الأوكرانية أو إنتخابات الرئاسة الأمريكية أو أخلاقيات اليسار أو النيوليبرالية أو شتى المعضلات الوجودية... ، لم تكن كتابتي في كلّ هذه العناوين المتنوّعة تتسم بالتموضع الثقافي أو التخندق في العنوان ذاته . كنتُ أسعى دوماً لتخليق مناطق مشتبكة بينها عملاً بفكرة أنّ الوجود البشري بكلّ تشكّلاته هو أقربُ إلى سلسلة نظم دينامية متعشّقة عضوياً مع بعضها، وهذه بالضبط هي رؤية مبحث النظم الدينامية المعقّدة التي صارت عنوانا واسعا في العلم المعاصر والتقنيات الثورية المنبثقة عنه.
الجانب الآخر من كتابة المقالة الأسبوعية يختصُّ بالقارئ. أيّ القرّاء تخاطبهم المقالة؟ ثمّة قناعة عامّة شائعة أنّ المقالة ذات الثراء الثقافي لابد أن تكون أعلى من منشور فيسبوكي وأقلّ من أطروحة أكاديمية، بمعنى أن تترفع عن مواضع (الخفّة) في مواقع التواصل الإجتماعي في الوقت ذاته الذي تتخفف فيه عن مراتب (الصرامة) الأكاديمية. أظنّ هذه الرؤية فيها جوانب من صحّة وخطأ. تنطلق هذه الرؤية من بديهة مؤكّدة: أنّ الكاتب إنّما يكتبُ لكي يصل ما يكتبه لأوسع فئة من القرّاء، والحجّة المقدّمة دوماً هي: ما فائدة أن تكتب لقرّاء معدودين؟ الأمر أقرب إلى نظرة مخرجات (الجهد/المنفعة). أظنّ أنّ الأمر ليس كذلك فيما يخصّني. ليس كلّ القرّاء يسعون وراء الخفّة والطرافة التي تسفح الزمن وتغيّبُ الجهد العقلي. هذه أخدوعة كبرى، ثمّ ليست كلّ كتابات مواقع التواصل الإجتماعي متسّمة بالخفة؛ فبعضها كتابات متميزة رصينة في وزنها الثقافي حتى لو خالطتها خفّة مقصودة، الأمر ببساطة أن تكتب ما تراه خليقاً بقارئ يحترم وقته وجهده المبذول في القراءة، وأن يشعر أنّ قراءته أضافت له شيئاً يتحسّسُ تأثيره في عقله وروحه، ولايهم حينها عدد القراء ،كتبتُ مرّة أنّ قارئاً واحداً رصيناً يكفيني لو شعر تماماً بما أشعر به وأنا أكتب، ولو جالت بعقله الأفكار التي تناوشت عقلي وقلّبَتْهُ يميناً ويسارا وهو يفكر في المآلات والنواتج الجانبية أو تلك المعروفة في المشهد الثقافي المرئي.
أما عن تقنيةكتابة المقالة الأسبوعية فيمكنني القول أنّ كلّ مقالة تتطلبُ سيناريوخاصا بها : تُفكّرُ في التمهيد أولا، وفي الغالب يكون مشهداً أو فعالية مررتَ بها أو قراءة في كتاب ما،،، ثمّ بعدها يأتي التطوير المفاهيمي: تحويل ذلك المشهد أو تلك الفعالية أو فكرة الكتاب إلى قراءة ثقافية من جوانب متعددة. لرَصْدُ الإشتباك الحاصل بين المؤثرات الثقافية والمشهد المرئي العام حتى في أدقّ الفعاليات البشرية وفي أي إطار تتخذه (سياسة، إقتصاد، علوم وتقنيات...).
تعلّمتُ الكثير من كتابة المقالة الأسبوعية في (المدى) وخدمتني خدمة عظيمة في تعلّم فنون الإنضباط والقراءة وتطوير مهارة تحويل الكثير ممّا تقرأ وتشهد إلى مادة عامّة مفيدة وفيها بعض العناصر الثقافية المغذّية التي يتقبلها القراء.
بعد هذا كلُّ ما أسعى إليه من مقالتي الأسبوعية أن تساهم ولو بقدر ضئيل في إشاعة الجمال والحب والخير في عالمنا وتقليل مناسيب القباحة فيه، وإثارة مكامن الشغف والمعرفة والتفكّر .أظنّ أنّ هذه الأهداف النبيلة هي التي تذلّلُ المشقة وتدفعني لمواصلة هذا الجهد الذي ينأى عنه معظم كُتّاب العالم ممن استطابوا نشر كتاب كل بضع سنوات واكتفوا بهذا.