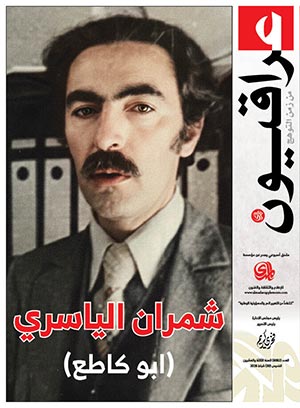علاء المفرجي
لم أكن قد تجاوزت العاشرة من عمري، وكانت عائلتي قد خرجت تواً من مشكلة كبيرة مع الحكومة، هي مشكلة بمعناها المجازي. في مثل هذا الجو دخلت أول مرة الى صالة العرض في بغداد بداية السبعينيات صحبة أخي الكبير، وكان الفيلم الذي يعرض (ساكو وفانزيتي)، وهو فيلم أنتج عام 1971 كتبه وأخرجه المخرج الإيطالي "جوليانو مونتالدو"، بناءً على أحداث محاكمة وإعدام نيكولا ساكو وبارتولوميو فانزيتي.
ولكن يبدو أن الفيلم لم يكن (عاديا) فقد كانت صيحات الجمهور داخل الصالة تصرخ غاضبة بشعارات يسارية، وأنا مندهش مما يحصل، حتى وجدتني اتلاطم في نهاية الفيلم مع جمهور الفيلم في الشارع الذي تقع فيه السينما، مرددين نفس الشعارات، وكنت بين خائف وسعيد لأني ببساطة في مظاهرة.
عرف فيما بعد أن نضج وعيي، أن هذا الفيلم قد جرّ مظاهرات غاضبة أشعلت مدنا مثل روما وبوينس آيرس وباريس ولشبونة. وغيرها؛ اذن لم تكن هذه المظاهرة الصغيرة التي خرجت في بغداد من صالة سينما سمير أميس، إلا جزءا من مظاهرات عمت الكثير من العواصم، قضية ساكو وفانزيتي أثارت العالم في عشرينيات القرن الماضي، وخلدتها السينما في السبعينيات. السبعينات العقد الذي شهد مداً يساريا طامحا إلى تسجيل حضوره.
نعشق الحكايا والقصص من أفواه جداتنا، ومن فن الرواية، ولكن، ما أمر هذا القص، هل هو لتسليتنا، أم تراه تأثيرا وعبرة لنا.
السينما هذا الإختراع السحري هو الذي جعلنا نحب الحكايا، وسرد الاحداث التي تمر بنا، ولكننا أيضا نحبها لأنها توفر علينا عناء الخلق والتخيل. فنحن نخوض - كما هم أبطال الفيلم - في أحداث تُصنع بمهارة تطابق الى حد كبير حياتنا.. فنروح معهم في متعة سرد الاحداث، بل والتأثير بها.. نغضب، ونحزن، ونفرح، وأحيانا ننتقم.. والجميل في السينما أنك تتعاطى معها بـ (ديمقراطية)، فأنت من تختار الفيلم الذي يتماهى وطبيعتك، لا أحد يفرض عليك ما تختار ما.
السينما كلمة تنفتح على عوالم البهجة والحزن، الفوضى والانسجام الحب واللاحب، تماماً مثل كالفينو في إحساسه ان ما يشاهده على الشاشة فقط هو الذي يمتلك المميزات المطلوبة من العالم: الامتلاء، الضرورة، الانسجام، و احلام اليقظة... ببساطة ملاذ مصطنع تشاغلنا به الحياة.. السينما تجعلنا اكثر وعياً في رؤية وجودنا اليومي و في تكوين شخصيتنا، ولا بأس ان نتماهى مع الخرافة، شرط ان نتقمص الشخصية التي نحب على طريقة (إيرما لادوس).
مثل كالفينو، كان للحرب حضورها.. عند كالفينو اضطهاده المرير من انقطاع الرؤية بسبب قرار الفاشية بحضر الافلام الامريكية اثناء الحرب، اما عندي حين حجبت عني الحرب نفسها ولوج عالم أحب، لكن كان ذلك لم يمنعي يوماً من الهروب من إحدى جبهاتها مباشرة، باتجاه بوابة ساحة الاحتفالات المكتظة او المزينة بخوذ قتلى الحرب الى سينما المنصور حيث عرض (باريس والاخرون) قصيدة كلود ليلوش البصرية، وعلى إيقاع موريس بيجار أستعيد مأساة الحرب واهوالها في عتمة القاعة.. قاعةالاحلام (هكذا وببساطة وجدها رولان بارت).. عالم ساحر يومض منبثقاً من عتمتها الحالكة، التي هي عند بورخيس رمادية تشبه عالم الشاشة الفضية.
هذا العشق للسينما جعلني أرغب بشدة أن أكون في دوامتها، فاخترت الكتابة عنها، وقبل ذلك حاولت ان أدرسها بشكل علمي، لكن للأسف لم تسنح لي الفرصة في الدراسة النظرية، والسبب طبيعة فهم المؤسسة الحاكمة فترة السبعينيات في العراق لموضوع التعليم حيث لم يُسمح لغير (المتحزبين) دراسة بعض الفروع الانسانية مثل الرياضة والفن والتدريس، باعتبار ان المتخرجين سيلقون في سلك تعليم الأجيال.. وهو الامر الذي زادني اصرارا في اكتساب المعرفة السينمائية من غير مصادرها الاكاديمية الصرفة، واعتماد القراءة المتخصصة والمشاهدة المستمرة للأفلام فضلا عن ملاحقة أبرز انجازات هذا الفن وتياراته، ولا يلازمني شعور ان الدراسة الاكاديمية كانت ستضيف لي ما هو أكثر، خاصة وان المؤسسات الاكاديمية السينمائية لدينا تعاني قصورا واضحا في ادائها التعليمي وأغلب خريجيها تستوعبهم الوظائف الإدارية.